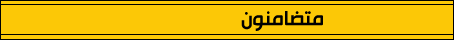المناهج النقدية
اختلاف المناهج النقدية وتعددها:
لقد اختلفت مناهج النقد، وتنوعت طرقه؛ وذلك باختلاف النقاد، واختلاف العلوم التي أفادوا منها في دراستهم للأدب، وتعرضهم لنقده، وقد تعددت هذه العلوم، وتنوعت ما بين علوم اللغة، والتاريخ، والفلسفة، وعلم النفس، والاجتماع... إلخ.
كما تدخلت الظروف السياسية أو الدينية في فرض بعض تلك المناهج النقدية، وذلك كما في النقد المذهبي، فقد كان تأثير الدين والسلطة الإسلامية واضحًا في ظهور ذلك النوع من النقد في عصر صدر الإسلام، كما كان للظروف السياسية في روسيا أثرها في فرض منهج النقد المذهبي الذي يقيد الأديب بضرورة خدمة المجتمع، والدفاع عن المبادئ الاشتراكية الروسية.
ويمكن أن نذكر هنا أهم تلك المناهج النقدية، وهي:
1-المنهج الكلاسيكي الاتباعي:
وهو ذلك المنهج الذي يقوم على الالتزام بالأصول والتقاليد الفنية الموروثة، ويرى ضرورة اتباعها، وعدم الخروج عليها.
وخير ما يمثل ذلك المنهج هو النقد العربي في فترة طويلة من تاريخه، فقد زاول النقد العربي –لفترات طويلة- هذا الأسلوب في النقد، وبخاصة حين استقر ما عُرف بعمود الشعر([1])، أو مجموعة الأسس الفنية التي يجب على الشاعر أن يحققها في مجالي المعنى واللفظ، لكي يسير على تقاليد القدماء أصحاب الأصالة والسبق، وبذلك يصل إلى المرتبة العالية التي بلغوها.
وخير من حاول تحديد مفهوم عمود الشعر هو المرزوقي (ت 421هـ) في مقدمته لشرح ديوان الحماسة، إذ يقول عن القدماء الذين أرسوا الخصائص المميزة للصنعة الفنية: "إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف –ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات- والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم، والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا تحدث منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر. ولكل باب منها معيار"([2]). وقد مضى المرزوقي شارحًا ومحللاً هذه الأصول الفنية، ثم انتهى إلى إعلان الرأي العام العربي الذواقة للشعر، "فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها، فهو عندهم المفلق المعظم، والمحسن المقدم، ومن لم يجمعها كلها، فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والإحسان، وهذا إجماع مأخوذ به ومنهج متبع حتى الآن"([3]).
2-المنهج الرومانسي التأثري:
وهو ذلك المنهج الذي يقوم على التحرر من الأصول الموروثة، وتعظيم الذوق الفردي بناء على أن الإنسان مقيد بشخصيته، وأنه ليست هناك مقاييس يستطيع أن يزن بها أفكاره، أو أفكار غيره، فالشخصيات تختلف؛ ولذا ينبغي أنه يفهم كل قارئ العمل الفني حسب طبيعته، أي: ميوله النفسية واستعداده الكافي.
ويمكن أن يعقد الشبه هنا بين هذا المنهج وبين اتجاه التجديد الذي شاع في العصر العباسي وتزعمه أبو نواس، وبشار، ومسلم بن الوليد، وأضرابهم ممن نحو نحو التجديد والخروج على عمود الشعر القديم.
وسوف نعرض لذلك تفصيلاً في الفصل الخاص بالخصومة بين القدماء والمحدثين.
3-المنهج المذهبي:
وهو ذلك النوع من النقد الذي يقوم فيه الناقد المنتمي إلى مذهب معين –مع تنوع معارفه وأدواته الفنية- بقبول أو رفض النص الأدبي على أساس من عقيدته الخاصة كالمذهب الديني، أو المذهبي الخلقي، أو السياسي.
وهذا الاتجاه النقدي لم يعدم أنصارًا له في مختلف العصور، وسوف نشير إلى أمثلة له في عصر صدر الإسلام في توجيهات النبي r، والخلفاء من بعده للشعراء، وقد تبادل الشعراء والأدباء من الشيعة، والخوارج، والمعتزلة وجوه النقد التي ترجع إلى تلك الأصول المذهبية التي يلتزم بها كل فريق من تلك الفرق.
وفي العصر الحديث جددت الواقعية الاشتراكية الدعوة إلى ذلك النوع من النقد، حتى صار ذلك الاتجاه النقدي المذهبي لا يكاد يعرف في غير الاتجاه الواقعي الاشتراكي أو الماركسي في الأدب والنقد.
وإذا كان النقد في الاتجاه الجمالي الشكلي يركز على المتعة الجمالية الخالصة، فإن هذا النقد المذهبي يدعو إلى ضرورة المشاركة الاجتماعية، وخدمة قضايا المجتمع والارتقاء به. ولم يعدم هذا الاتجاه من يدافع عنه من النقاد المعاصرين، فالناقد الكبير الأستاذ الدكتور محمد مندور يدافع عن هذا النقد المذهبي، الذي يستند إلى إدراك جديد لوظيفة الأدب والفن بصفة عامة، فلم يعد الأدب –عند دعاته- نشاطًا جماليًا خالصًا هدفه الإمتاع، وإنما هو مشاركة اجتماعية ضرورية. ومن هذا المنطق فإن الناقد المذهبي يفضل التجربة الحية المعيشة على التجربة التاريخية البالية، وبخاصة إذا لم تصلح وعاء لمشكلة معاصرة تشغل الأديب أو تشغل مجتمعه وإنسانيته الراهنة، والناقد المذهبي لا يكتفي بالموضوع العام للعمل الفني، بل يهتم بالمضمون، أي بما يفرغه الأديب من أفكار، وأحاسيس، ووجهة نظر خاصة، وهذه الأفكار –من موقف النقد المذهبي- يجب أن تكون في خدمة الحياة وتطويرها نحو ما هو أجمل، وأفضل، وأكثر إسعادًا للبشر، وأن الأديب يجب أن يزاول هذا الدور المنوط به، لا من موقف المعبر عن واقع مباشر -أي أن يكون فنه صدى للحياة- بل يجب أن يكون مبشرًا بالمستقبل، قائدًا لصنع الغد الأكثر تقدمًا وجمالاً([4]).
من هذه المنطلقات الأساسية يناصر الناقد المذهبي القضايا الأدبية والمواقف الفنية التي تساير فلسفته، مثل قضية الفن للحياة، وقضية الالتزام في الأدب والفن، وقضية الواقعية في الأدب والفن، وتفضيل الأدب القائد على الأدب والفن الصدى، ويرفض ما يخالف ذلك، كما يرفض النظرة المتشائمة إلى الإنسان، وإلى الحياة، ويدعو إلى التفاؤل، وهذا الموقف المتفائل –عند المذهبيين- لا يقوم على إنكار وجود الشر في الحياة، ولكن على الإيمان بأن الشر ليس أصيلاً في الطبع الإنساني، وإنما هو عَرَض تولده عند الأفراد ظروف المجتمع الفاسدة، وقشرة يكمن تحتها خير راسخ. ومن ثم لا محل للتشاؤم؛ لأن أسباب الشر من الممكن إزالتها، بل يرون أنها يومًا ستزول، ويعود الإنسان خيِّرًا حين يلتقي مع فطرته الأصلية، وهذا مصدر تفاؤلهم.
وهذه القضايا جميعًا تستحق المناقشة، وقد أثارت نقاشًا حادًا في العالم العربي في الخمسينيات من القرن الماضي بخاصة.
ومن الممكن أن يقال عن الاتجاه المذهبي (أو الأيديولوجي) في النقد: إنه منهج لا يريد أن يسلب الأديب أو الفنان حريته، وأنه يرجو أن يستجيب الأدب وكاتبه لحاجات عصره وقيم مجتمعه بطريقة تلقائية، ويرى أنه لابد سيستجيب لذلك إذا فهم وضعه الحقيقي في المجتمع، وأدرك مسئوليته الكاملة ونهض بالدور القيادي الحر الذي يعزز مكانته، ويرتفع بها إلى مستوى الإيجابية الفعالة، التي يُعتبر الاحتفاظ بالقيم الفنية الجمالية أهم وسيلة لتحقيقها؛ لأن الأدب والفن بغير القيم الجمالية والفنية لا يفقد طابعه المميز فحسب، بل يفقد أيضًا فاعليته، ترتيبًا على أن تلك القيم الجمالية والفنية هي التي تمنحه القدرة على التأثير، وتفتح أمامه العقول والقلوب.
من الممكن أن يقال هذا كله من المعتنقين للنقد المذهبي ودعاة المذهبية في الأدب والفن، ولكن النظرية أو الدعوة لابد أن تحمل بعض حقائقها من التطبيق، وأن يدخل في مفهومها ما انتهت إليه من نتائج([5]).