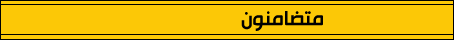هويدا رأفت الجندى
مراقب عام



عدد الرسائل : 4821

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 10155
ترشيحات : 11
الأوســــــــــمة : 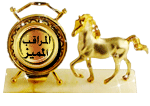
 |  موضوع: الهجاء بين المظاهر السلبية والإيجابية موضوع: الهجاء بين المظاهر السلبية والإيجابية  13/9/2009, 20:48 13/9/2009, 20:48 | |
| الهجاء بين المظاهر السلبية والإيجابية
لقد عبر الإنسان منذ طفولته الأولى بوساطة الشعر عن وجدانه وعمَّا يختلج في نفسه من ألم وغبطة ومن فرح وترح، ومن إحساس بالسعادة وشعور باليأس والإحباط، فكان الشعر- إذن في حياة الإنسان- تعبيراً عن تنازع البقاء، وعن صيرورة هذا الإنسان في الوجود. وإذا كانت أحواله تختلف من حيث الغبطة والرضا والتفاؤل والتشاؤم-مثلاً- فإن هذا الشعر بدوره يعاني من الوحشة والانقباض فهو تارة يحب ويلين، وأخرى ينقم ويحقد ويقسو على تصرفات الناس من حوله.
وقد تتحول تلك النقمة والوحشة أو الحقد والعداوة من مجرد إحساسات وجدانية داخلية تتفاعل في نفس الشاعر وتتعقد لتضاعف وتتطور ثم تنصهر في أعمال الوجدان الفردي، ثم يخرجها الشاعر إلى العالم الخارجي، بهجاء مشفوع بكثير من الملامح المشوّهة التي هي في الواقع ((تعبير مادي محسوس عن تلك الظلال الشعرية الموحشة الغائرة في أبعاد النفس))
فالهجاء بناء على هذا المنظور غرض شعري أصيل واكب الإنسان منذ الوهلة الأولى التي نطق فيها شعرا، أو هو –على الأقل- من أقدم الأغراض الشعرية في الجاهلية "ومما يدل على أن الهجاء كان أصلاً من أصول الشعر، وغاية منشودة يتطلبها البناء الاجتماعي التهديد بالهجاء ووصف الشعر بالصلابة وأدوات الحرب والنزال ونعت قصائد الهجاء بالأوابد".
وهكذا، فحين نتفهرس بعض الكتب النقدية القديمة نجدها في تقسيمها لأغراض الشعر العربي القديم لا تهمل غرض الهجاء، كأن يقسم بعضها تلك الأغراض إلى خمسة أقسام مدح فهجاء فغزل فوصف فرثاء، وقد قال أبو هلال العسكري في هذا الشأن: "وإنما كانت أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح والهجاء والوصف والتشبيب والمراثى حتى زاد النابغة فيها قسماً سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه".
وعلى الرغم من إيماننا بأن الهجاء يمثل غرضاً أصيلاً في الشعر الجاهلي بعامة، إلا أن هذا الغرض لم يكن غرضاً يمتاز بغزارة المادة الشعرية كما هو الأمر بالقياس إلى الفخر والتشبيب-مثلاً- فالشاعر الجاهلي لم ينصرف-فيما يبدو- انصرافاً ظاهراً إلى فن الهجاء، وإنما كان هناك نوع من التهاجن الذي كان يعقب الأيام الجاهلية، يحفل بصور مما تشهدها في شعر الفخر، حيث تتحول إلى النقيض من الرذائل والمنكرات.
ولعل نظرة عجلى إلى المعلقات، وهي أصفى وأقدم ما وصلنا من الشعر الجاهلي تجعلنا نقف على أغراض الفخر والغزل والخمرة والوصف في حين يندر التعرض لغرض الهجاء.
ولعل حاجة الجاهلي إلى الفخر بالذات الفردية والجماعية كانت أمسّ من الحاجة إلى الهجاء، لذا فقد غلب غرض الفخر وطغى في البيئات البدائية على الهجاء. "فالبدائي يكاد لا يغشى إلاّ سطح الأشياء، ويقتصر غالباً، على الهموم المادية، لذا نراه يسرف بالتفاخر لأنه في زهوه واطلاعه الجديد على الوجود، يؤخذ بالدهشة والاستغراب ويترنّح بالانتصارات الصاخبة الشديدة الانفعال متجاوزاً عن التحديق بهاوية الفراغ والعتمة والوحشة التي تدلهم في نفس الحضري الذي لم يعد يرضى من الحياة بأن يحيا، بل يريد أن يفض لغز نفسه ولغز الوجود".
ويحاول أحد الدارسين أن يقيم وزناً بين نوعية الهجاء في البيئات البدائية وبين هذا الهجاء في البيئات الحضرية فيلاحظ أنّ الهجاء في البيئات البدائية غالباً ما يكون مرتبطاً بالفخر بحيث يكون امتداداً له، في حين يختلف الأمر في البيئات الحضرية بحيث يمثل الهجاء غايات أخرى، كأن يقول: ولا تحسبن أن الهجاء يقوم في البيئات الجاهلية البدائية، بل على العكس فإنه قد يظهر في أحيان كثيرة إلى جانب الفخر، لأنه امتداد له ومبالغة فيه، لكن هذا النوع من الهجاء هو هجاء سلبي، لا يظهر فيه رأس الإنسان، ولا سويداؤه المتجهمة، ولا أحداقه الفارغة المظلمة في جمجمة الوجود، لهذا فإننا نقبل على الهجاء الجاهلي ونكاد لا نشهد فيه إلا صورة من حياة الإنسان في سبيل اكتشاف الغاية الكبرى التي تجعله يشعر أن لحياته معنى، وتحرره من الشعور بالتفاهة والعقم واللاجدوى".
ومما تجدر ملاحظته، ونحن بصدد مناقشة مناحي الهجاء في الشعر الجاهلي أنَّ هناك علاقة جدلية بين المدح والهجاء تمثل-في الواقع- تصارع القيم الإنسانية في عمق الكائن الإنساني، فحين يتسم المدح بكونه بحثاً عن المثل الإنسانية السامية، ومطمح الشاعر لأن يضفي على الممدوح- وربما يعني نفسه- أنبل الصفات وأسماها، فإن الهجاء يتكئ على المدح في جل صوره لأنّه يمثّل الضد لتلك الصور والصفات، فالشاعر الهجّاء ينقض تماماً ما يصوره في المدح.
وقد قلنا-فيما سبق- إن الشاعر حين يفتخر بنفسه أو بقومه، فهو يصور تطلعه إلى أرقى ما هنالك من قيم إنسانية محبذة، فهو ينشد مُثلاً عليا تجسّدها تلك القيم الحميدة، وحتى إن قلّت نظائر تلك القيم في الواقع الذي يحياه منشدها فإنها تظل غاية إنسانية سامية يتشبّث الإنسان بكل الوسائل المؤدية إلى بلوغها.
وكذلك الأمر في مجال المدح، إذ هو من الأغراض الشعرية التي عرف بها الشعر القديم أكثر من غيره في شعر الأمم الأخرى، وحين نتأمل هذه الظاهرة الشعرية، قد لا نجدها مقتصرة على مجرد إبداء المهارة الفنية في خلق الاستعارات والتشبيهات وإضفاء الصفات المثالية على الممدوح بل نجدها أعمق من ذلك بكثير.
فالمدح قد يبدو مجرّد وسيلة للتكسب ونيل الحظوة لدى الملوك والأمراء الممدوحين، ولكنه ليس دائماً كذلك، فصفات الممدوح هي رغبة وجودية تعيش في لا شعور الإنسان (الشاعر) ويوطن النفس على بلوغها لنفسه، وما دامت السبل والوسائل غير مهيّأة لتمكينه من ذلك فإنه يكتفي-على الأقل- بتصويرها مقترنة بغيره، أما إذا كان هذا الشاعر فارساً، أو من ذوي النفوس المتطلعة إلى المعالي، فإنَّ الممدوح-حينئذ- يتحول إلى المادح نفسه أي أن الشاعر يمدح غيره تصريحاً، ويقصد نفسه تلميحاً، فشاعر مثل المتنبي لا نخاله حين يمدح سيف الدولة-مثلاً- إلاّ قاصداً نفسه لأنه يرى في شخصية ذلك الأمير صورة عن شخصه من جهة، ولأن نفس الشاعر جُبلت على حب المعالي وركبت المخاطر والأهوال قصد بلوغ غايات سامية ومراتب عُليا من جهة أخرى، وإذا لم يكن ذلك ليتحقّق على أرض الواقع، فإن تلك القيم التي عبر عنها الشاعر من خلال غرض المدح هي –على الأقل- قاسم مشترك بين المادح والممدوح.
لكن الهجاء يحمل من الصفات الإنسانية ما يمثل النقيض تماماً، فالقيم المحبّذة تقابلها قيم ذميمة، والخصال الكريمة تقابلها صفات قبيحة، فما السرّ في كون هذا الإنسان يميل إلى ما هو أقبح وأرذل؟
لعل النفس الإنسانية في حالة صفائها وهدوئها وسعادتها ونشوتها ترى الوجود جميلاً فتصوره في ضوء ذلك الإحساس، ولكنها حين يعتكر صفوها وتضطرب أحاسيسها فإنها تصور انفعالها معبّرة عن نقيض تلك الانفعالات الحسية، فتبدي ما هو قبيح وذميم، والإنسان هو دوماً مصدر هذا الإحساس بمعناه السلبي والإيجابي معاً.
ويبدو أن نشأة الهجاء متأتية من ارتباطه بالعصبيات القبلية وما تثيره تلك العصبيات من حروب، وما تخلفه من أحقاد، فالشاعر لسان حال قبيلته، فهو الذي يذود عن حياضها بلسانه ويهجو خصومها حين تقتضي الضرورة ذلك، ومن ثمة ارتبط الهجاء بالفخر ارتباطاً وثيقاً، فحين يكون الهجاء، قبلياً فإن الحروب والرغبة في الانتقام هي التي تحركه، ثم إنه يكون مرتبطاً بالمدح -في الوقت نفسه- حين يتوجه الشاعر إلى مدح شخص فيعرّض بخصم ممدوحه ليقيم من وراء ذلك هجاء على عنصر المفاضلة.
ومثل تلك العصبية العمياء للقبيلة، والانقياد لأهوائها ونزواتها يعبر عنها الشاعر الجاهلي أصدق تعبير من خلال البيت التالي:
وما أنا إلا من (غزية) إن غوت
غويتُ وإنْ ترشدْ (غزيةُ) أرشدِ
وإذا كان الهجاء قد ارتبط بكثرة الحروب، فهو بذلك ليس بعيداً في معانيه عن شعر الحماسة، وقد تمتزج في قصائد الهجاء معاني الفخر والفروسية معاً، لأن الشاعر الذي يهجو قبيلة أو فرداً يبحث –في الواقع- عن الصفات الذميمة من جبن وبخل وخوف، وتلك الصفات وغيرها هي نقيض للصفات الأخرى الإيجابية، وكأن الشاعر سواء أكان ممثلاً لقبيلته أو لذاته الفردية ينسب الصفات الذميمة إلى غيره ليتبوّأ هو مكان الصدارة في تطبيق الصفات المناقضة لسابقتها، فحين يتهم غيره بالجبن فهو-ضمنياً- شهم وشجاع، وحين يصف غيره بالبخل فهو الكريم والسخي والمعطاء وهكذا…
وليس ذلك فحسب، بل هناك بعض الدارسين ممن يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقول: "فلم يبق من أغراض الشعر غير غرضين… الفخر، والهجاء وعلى هذين المحورين قام أساس الشعر الجاهلي، وارتبط به، وبين هذين الغرضين من الوشائح ما يؤكد ترابطهما وفيهما من الاتساع والعمق ما يؤدّي إلى رحابة الشعر وسماحة أغراضه".
وقد يقول قائل: ما دام غرض الفخر يمثل حماسة الجاهلي التي تجعله ينشد القوة ولذة الظفر بالنصر، مما يدخل معاني الغبطة والنشوة إلى نفسه، فكيف يمكن النظر إلى غرض الهجاء بالمقابل على أنه يمثل المثل الأعلى للشاعر؟
إن الأديب يصور في الهجاء مثله الأعلى حقاً "لأن شيئاً قد عارض هذا المثل، وهذا الشيء قد يكون شخصاً من الأشخاص أو نظاماً من النظم أو فكرة من الأفكار، فإذا صور الشاعر عاطفته فقد يصورها منصبة على هذا الشخص أو هذا النظام".
أمّا حين نحاول الوقوف عند مصطلح الهجاء من الناحية اللغوية، فإن هذا الغرض الشعري يكاد لا يخرج عن معنى الشتم بالشعر.
أما على المستوى النقدي فإن ابن رشيق القيرواني يعرّفه قائلاً: "الهجاء هو الشتم بالشعر، وهو خلاف المدح.. والهجاء ظاهرة السخط والسخرية… يتخذ معانيه من سوءات المهجو أو مثالب قومه، فالمفتخر يلتفت إلى نفسه ليشتق منها مادته والهاجي ينظر إلى خصمه لينشر مساوئه مقرراً أو ساخراً، ويفضل النقاد السابقون ما كان من الهجاء عفاً خالياً من الفحش بحيث تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح بمثلها".
فالمتأمِّل في القول السابق يخلص إلى أن ابن رشيق ينطلق من المعنى اللغوي، ولكنه سرعان ما يضفي معاني جديدة تجعل هذا الهجاء غير الشتم المتعارف عليه لدى السوقة أو الدهماء، بحيث أنه لا يخلو من معاني السخط والسخرية، ولكنه ليس ذلك الكلام البذيء الفاحش الذي تخجل العذراء من ترديده ، ونفهم من ذلك أن الهجاء مستوىً فنيّ أعلى من الشتم، بل هو غير الشتم، فالشتم قد يمس الأعراض والأنساب والأشخاص أثناء حالة من الغضب والانفعال اللذين يخرجان الإنسان من حالته الطبيعية فيطلق الكلام دون وعي، لكن الهجاء هو فنٌّ قولي يبرز عورات الناس، ويحط من قيمة الفرد أو القبيلة بما يلصقه من مثالب وصفات ذميمة، ولكنه يتم بدرجة أعمق بحيث تؤثر في الفرد أو الجماعة تأثيراً عميقاً بصرف النظر عن كون تلك الصفات حقيقية أو أن الشاعر قد أضفى عليها شيئاً من عنده.
وليس غريباً أن نجد تفريقاً بين الشتم والهجاء في الشعر القديم نفسه، كأن يقول حسّان بن ثابت مثلاً:
لنَا في كلٍّ يوم من معدِ
قتالٌ، أو سباب، أو هجاء
فنحكم بالقوافي من هَجَانا
ونضرِبُ حين تختلطُ الدماء
فالهجاء فنٌّ شعري ذائع الانتشار في الشعر الجاهلي، وهو خلاف المدح إذ يمثل النقيض، فإذا كان المدح هو إبراز القيم الإنسانية المثاليّة التي ترفع من مكانة الفرد أو القبيلة فإن الهجاء هو تصوير تلك القيم في معانيها المناقضة لها قصد الحط من المهجو اجتماعياً وإنسانياً، فالمفتخر يلتفت إلى نفسه ليشتق منها مادته في حين يلتفت الهاجي إلى خصمه ليصور نقائصه في قوالب ساخرة مؤثرة تنفذ إلى مخاطبة المهجو من خلال نقاط ضعفه سواء أكان ذلك متعلقاً بالفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذاهب إذ لا تقتصر عاطفة الغضب تلك على الناس في حد ذواتهم بل تتجاوزهم إلى الأخلاق والمذاهب حين لا تلقى استحساناً وتفهماً لدى الهاجي.
وفضلاً عن أن الهجاء هو تعبير عن عاطفة السخط والغضب، كما أسلفنا فإنه يعد سلاحاً من أسلحة القتال، إذ يعمل الشاعر أثناء هجائه للقبيلة المعادية على أن يثبط العزائم، ويضعف الهمم لتنهار معنويات الأعداء، مع التركيز على التهديد والوعيد والانتقاص من قدرهم، ومن هذا المنطلق كان ارتباط الهجاء الوثيق بأيام الحرب.
والهجّاء من هذا المنظور، ناقد بطبعه يوطّن النفس على إظهار حماقات الناس أو أخطائهم أكثر مما تسترعيه أفضالهم، "فكأنه لا يهتدي لنفسه إلا بالقدر الذي يدفعه إلى حقده وغضبه، فهو لا يكتشف ذوقه، ومواهبه إلا عن طريق السخط، فإذا مات في نفسه السخط وسكت عنه الغضب فقد معهما كل ظل من ملكاته".
ويستطيع الهجاء أن يبلغ مبلغه في هذا الفن، فإنه يحتاج إلى ثقافة اجتماعية عميقة ومصادر تمكنه من معرفة خلفيات الناس وعوراتهم وميولاتهم النفسية، ويحبذ النقاد أن يكون عنصر الصدق في الهجاء متوفراً ليبتعد بذلك عن أن يتحول إلى سب وقذف، وعن كلام العامة الذي هو إلى السب أقرب منه إلى الهجاء كما أشرنا من قبل.
((فالهجاء على هذا شعر يقترب من الواقع، ويرتبط بالمجتمع وهو الشعر الذي يؤرخ التطور الاجتماعي وتؤخذ منه صورة الحياة ومثالب السادة)).
وإذا كان الهجاء لا يخلو من كشف للمساوئ والعورات ولا يتورع من السخرية وإبداء السخط والغضب، فما مدى علاقته بقول الله جلت قدرته في سورة الحجرات: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون" صدق الله العظيم.
وبطبيعة الحال فإن هذه الآية الكريمة تحث على مكارم الأخلاق ورعاية الآداب، وقد يقول قائل ما علاقة هذه الآية وموضوع الهجاء في الشعر؟
والحقيقة أنّ ما نريد الوصول إليه لا يتعلق بأسباب نزول الآية المذكورة، ولا فيمن نزلت بالتحديد، ولكنه يتعلق بظاهرة اجتماعية متفشية في المجتمع الجاهلي وقد أقرها القرآن الكريم، وهي ظاهرة السخرية والتنابز بالألقاب، واللّمز الذي هو العيب وقد يكون باليد والعين واللسان والإشارة، ومن ثم فإن هذه الظواهر الاجتماعية المادية منها والمعنوية نهى عنها الله، وحث المسلمين على تجنبها.
فهل نفهم من ذلك أن الهجاء الذي لم يخل في بعض جوانبه من إبراز العورات مثل "التنابز بالألقاب" و"اللمز" و"السخرية" و"هتك الأعراض" والتشهير بالأفراد والجماعات في مناسبات مختلفة، ولأسباب متعددة منظور إليه بنفس النظرة التي أشار إليها الله في معاني الآية السابقة؟
هنا يجب أن نقول دون تردد أو وجل، إن المجتمع الجاهلي كبقية المجتمعات البدائية يتسم بسلبيات كما يتسم بإيجابيات، ومن ثمة ليس عيباً أو مثلبة حين نقف عند بعض هذه السلبيات من خلال النص الشعري الجاهلي نفسه، لاسيما أن هذا النص الذي عني بإفشاء بعض العيوب الاجتماعية أو الخلقية ليس دائماً يفشى مثل تلك العيوب لمجرد السخرية أو النيل من الخصم سواء أكان فرداً أم جماعة، بل غالباً ما يكون بغرض التوجيه حيث أن العرب قبل الإسلام لم تكن تحكمهم قيم أو تعاليم مستمدة من السماء، فلا نعتقد-مثلاً- أن الجاهلي كانت، تروعه الخشية من القانون الإلهي (الشريعة السماوية)، ولا تحكمه سلطة من الأرض (الدولة)، لذا فإن الهجاء غالباً ما كان يكبح جماحه ويلزمه باحترام قيم معينة، وحتى إن كنَّا لا نتفق بشكل مطلق مع الرأي التالي إذ يبدو فيه شيء من التصميم والمبالغة إلا أنه لا يخلو من جانب هام من الحقيقة، وذهب هذا الدارس إلى حد القول إن: ((العرب لم يكن يحكم حركتهم شيء من ذلك، فلم يبق غير الهجاء ذلك الفن الذي يكشف عن العورات، ويهتك ما خفي من سوءات الأشراف)).
ومهما يكن الأمر فإن للهجاء دوراً لا ينكر في المحافظة على القيم الإنسانية والاجتماعية، وفي توجيه الحياة العربية، لا سيما قبل ظهور الإسلام حين لم يكن للعرب الجاهليين وازع ديني ينظم حياتهم، أو نظام سياسي يملي عليهم التقيد بأحكام معينة.
ويبدو أن العربي كان شديد الحرص على أن يبدي لغيره أحسن ما لديه من مواقف ليظفر بالثناء وينال الحظوة لدى هذا الغير، بغض النظر عما يبدو منه أحياناً من إساءة وبطش بغيره أو نكال ((فكل إنسان يتدثر بما يروقه من أخلاق، ويلبس أمام الناس أحسن الشيم، وربما راجت هذه الأفاعيل، ولم يتبين الناس وجه الحق حتى يقول الهجاء كلمته، ففيها يظهر الرشد من الغي. والشاعر الهاجي بذلك يؤدي دوراً هاماً في توجيه الحياة)).
ولعله من باب الإنصاف ألاّ نقلل من شأن الهجاء في توجيه بعض مناحي الحياة العامة في العصر الجاهلي حين يأخذ هذا الهجاء دور التوجيه والتقويم، لكننا- في الوقت نفسه- قد نظلم هذا الجاهلي حين ننظر إليه على أنه لم يكن يخشى عقاباً سوى عقاب الهجاء، وكأنه بذلك لا تحكمه قيم ومعايير إنسانية غير هذا الهجاء، وكأننا بذلك نجرده من أي وازع أخلاقي أو رادع إنساني أو أية قيمة إنسانية تتحكم فيه، وتوجهه في مختلف مناحي حياته، كما يذهب إلى ذلك أحد الدارسين حيث يرى أن ((العرب لم يكن يحكم حركتهم شيء من ذلك، فلم يبق غير الهجاء ذلك الفن الذي يكشف عن العورات، ويهتك ما خفي من سوءات الأشراف)).
فأن يسهم هذا الهجاء في توجيه وتهذيب سلوكات المجتمع، فأمر قد لا يختلف فيه اثنان، أما أن يكون بمنزلة الناموس الذي يتحكم في حركة هذا المجتمع فأمر فيه شيء من المبالغة والغلو.
((فالهجاء هو الفن الذي يقود حركة المجتمع العربي في الجاهلية، وهو الذي يكشف زيف الناس ويقوّم الانحراف ويتتبع الفساد أنى كان.
وقد عرف العرب هذا الدور للهجاء فتحاشوا –ما أمكن- المثول أمام شاعر الهجاء، وأخفوا عوراتهم عن أنفسهم، ولم يجرؤ أحد أن يجاهر بما يعاب عندهم)).
والحقيقة أن مثل هذا الرأي يجعلنا نتساءل عما يصوره-أصلاً- الهجاء، فحتى إن سلمنا-جدلاً- أن الشاعر الهجّاء يعبّر من خلال هجائه عن مثاله الأعلى خلال غضبه وسخطه أو اشمئزازه واحتقاره، بحيث يصور ما يختمر في ذهن المادح أو شاعر الحماسة مثلاً باعتبار أن المدح هو حماسة الواقع، إلا أن الهجاء ليس دوْماً كذلك، فأحياناً يصدر عن ظروف نفسية خاصة، وقد لا يختص دائماً بالتوجيه والتقويم، فقد يصدر نتيجة لظروف ومؤثّرات تؤثر في تكوين الشاعر من الوجهة النفسية والاجتماعية، مما يجعله لا يرى الحياة إلا من منظور سوداوي قبيح، ومن ثمة يكتسب الاستعداد لتصيد عيوب النَّاس وكشف عوراتهم، أو يأتي نتيجة لمركب نقص سواء أكان فسيولوجياً أو نفسياً، ومثلنا في ذلك الشاعر الحُطيئة الذي كان ذميم الخلقة مغمور النسب، وجرير الذي كان متواضع النشأة والنسب فضلاً عن بشار بن برد الذي عرف بتشوه الخلق وبأن أباه كان مولى مهيناً، ثم إن الجاحظ كان قصيراً ذميماً وكان هؤلاء هجائين.
وبطبيعة الحال ليس في ذلك حطٌّ من قيمة الشعراء الهجَّائين أو تقليل من دور الهجاء في البناء الاجتماعي، ولكن الهجاء يمثّل سلاحاً ذا حدين فقد يكون هدفه التقويم والتهذيب والتحذير والوعيد تحاشياً للخروج عن المألوف وقد يتأثر لمجرّد التجريح والسخرية أو التفكه، كما هو الأمر في الهجاء الذي يوجه من فرد لآخر، فيحاول أن يلصق بالمهجو صفات قد تكون مفتعلة إما لإضحاك الناس أو لإبراز قدرة الشاعر الفنية والخيالية، أمّا أكثر أنواع الهجاء "تعقيداً وأعمقها تجربة إنسانية، فهو ذلك الهجاء الذي يعلن نقمة الفرد على المجموع، وثورته على ما يشهد فيه من اختلال في المقاييس والقيم".
وقد قُسِّم الهجاء حسب النقد العربي القديم إلى عدة أقسام منها: الهجاء الشخصي وهو ما يعتمد على هجو الأفراد ويعدّ هذا النوع من أقدم أنواع الشعر الهجائي، وقد يتأثر هذا النوع-في الغالب الأعم- بالأجواء الشخصية، ويبتعد عن العدل والإنصاف وهو أقرب إلى الشتم وأدنى إلى أن يتورط في الفحش
ثم الهجاء الأخلاقي وهو ما يدور حول التعبير عن الجرائم الأخلاقية أو الدينية والمفاسد الاجتماعية والعادات السيئة، وقد لا يقتصر على إنسان بعينه، بل يتحدث بأسلوب تعميمي قصد الابتعاد عن تلك السلوكات أو تصوير الاشمئزاز منها، ثم يأتي نوع ثالث وهو ما يعرف بالهجاء السياسي الذي يتميز عن سابقيه بكونه "يرى مثله الأعلى في حزب أو طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب، فهو يهاجم كلّ ما يتعارض مع هذا المثل من نقائص ومعايب تتمثل في انتصار حزب على آخر"([28]).
وبالنظر إلى أن بحثنا هذا قد اقتصر على العصر الجاهلي دون غيره من العصور التالية الأخرى التي أخذ فيها هذا الغرض الشعري دلالات أخرى، ومفاهيم جديدة وفقاً لتطور العصر وتغير العقليات، لا سيما بعد ظهور الإسلام وما أحدثه من قيم ومفاهيم جديدة، فإن معالجتنا ستنحصر في النماذج الشعرية الجاهلية.
وأياً كان الأمر فإن للهجاء آثاراً فاعلة ومؤثرة في نفس المهجو وقد لا تمحى تلك الآثار على مر الأجيال والحقب سواء أكان المهجو فرداً أم جماعة. فكم من قبيلة أطاح بشموخها واعتدادها بيتٌ من الشعر، وكم من فرد طأطأ الرأس وأضحى ذليلاً مهيناً من جراء بضعة أبيات كشفت عن عوراته وفضحت مساوئه.
وبالنظر إلى ما تتميز به الكلمة من قوة وتأثير عميقين، فقد نبَّه الشعراء الهجاؤون منهم بخاصة على هذا الجانب، وحذروا من صدى تأثيرها في النفس، حيث أن حدّة اللسان حين ينطلق من صمته لا تقل خطورة عن حد السيف البتار، وفي هذا المعنى يقول عبد القيس بن خفاف:
وأصبحت أعددت للنائبات
عرضاً بريئا، وعضبا صقيلا
ووقع لسان كحدّ السّنان
ورمحا طويل القناة عسولا
ثم إن شاعراً آخر هو سويد بن أبي كاهل يسم اللسان بالسيف، والذي هو في حقيقة الأمر لما يمتاز به من هجاء لاذع قد يتجاوز حد السيف نفسه مضاء وقطعا:
ولسانا صيرفيا صارما
كحسام السيف ما مسَّ قطع
فللقول الشعر أثره الفاعل سواء أكان بيتاً أو قطعة أو قصيدة، إذ أن هذا القول قد يغير أشياء جوهرية في حياة الأفراد والجماعات ممّن يكونون هدفاً لهجاء شاعر ما، لا سيما إذا كان هذا الشاعر ممن يحسب لقولهم حسابه في كشف النقائص وتضخيمها، ما ظهر منها وما بطن.
ومن هنا فلا غرابة أن يجتهد الناس في إخفاء عيوبهم وسقطاتهم عن الناس خشية بلوغها إلى مسامع الشعراء الذين يمثلون خصوماً، وبالمقابل فإن من الشعراء من يهدد وينذر غيره بأنه سيناله بهجائه ما لم يبتعد عن سبيله لأي سبب من الأسباب، فهذا النابغة الذبياني يحذر يزيد بن الصعق الكلابي قائلاً:
فحسبك أن تُهاضَ بمحكماتٍ
يمرُّ بها الرؤّي على لساني
فكأن الشاعر هنا لم يقل شيئاً يذكر بعد، ولكننا حين نتأمل بيته يتجلى لنا أن الفعل (تهاض) قد شكله الشاعر تشكيلاً شعرياً بحيث أحدث فزعاً ورعباً في نفس المهجو، لأن هذا الفعل يدل لغوياً على الكسر بعد الجبر، ومن ثمة يتجلى مفعول البيت وقيمته الكلامية وما يمكن أن يتركه من أثر، وقد لا نجانب جادة الصواب حين نذهب إليه أن الأثر الذي يحدثه مثل هذا التحذير أو الوعيد في نفس المهجو أكثر من الهجاء نفسه، ولذلك غالباً ما نجد الشعراء يركّزون على أسلوب التهديد، وتخويف الخصم بأنهم سيسلطون عليه أقبح الأوصاف، فيكون ذلك أثره أكثر مما يبينون عن تلك الأوصاف.
وقد سبق أن أشرنا من قبل إلى أن الهجاء يكون شخصياً بحيث يهجو شاعر شاعراً آخر، فيرد عليه هذا الأخير هاجياً إياه بدوره مما يترتب عليه شيء من المبارزة الكلامية لإظهار القدرة في كشف العيوب، ويحاول كل طرف أن يتفوق على الطرف الآخر من خلال ما يحدثه هجاؤه من ضربات موجعة، كما هو الأمر بين أمية بن خلف الخزاعي وحسَّان بن ثابت.
فقد تعرض أمية لهجاء حسان بن ثابت، وحاول أن يصيبه في الصميم لا سيما أنه أبرز عوراته، ويشكك في نسبه أمام الناس الذين يجتمعون في سوق عكاظ لسماع ذلك النوع من الكلام الموزون المقفى شكلاً ومضموناً، وفي ذلك ما يجلب العار والفضيحة للمهجو، ولنا أن نتخيل كيف ينتشر الخبر بين الناس في مثل تلك الأسواق الأدبية، وما يحدثه التشهير بمثالب الإنسان، ناهيك عن صدوره في سوق مثل سوق عكاظ.
ألا من مبلغ حسان عنّي
مغلغلة تدبّ إلى عكاظ
أليس أبوك فينا كان قينا
لدى القينات فسلافي الحفاظ
يمانيا، يظل يشدّ كيرا
وينفخ دائبا لهب الشواظ
وأمام هذا الهجاء اللاذع الذي لا يكثر أثره في نفس حسان لا سيما أنه مسه في نسبة العائلي وشهّر بأبيه الذي كان مجرد قين بين القينات بين أهل الشاعر الهاجي، حاول حسان أن يرد، ولكن رده اقتصر على التهديد والوعيد، ومحاولة تكذيب ما روّجه الشاعر الخصم إذ لم نعثر على أوصاف أو نقائص تحط من قدر أمية هذا، ولكننا نجد أبياتاً تحاول أن تخفف من أثر ما نُسب إلى حسان، من كذب وتلفيق لا يمتان إلى الحقيقة بصلة، في حين يهدد الشاعر بأنه سينشر كلاماً في مختلف المجامع من عكاظ، وسينال به من الشاعر وقومه بأبيات صلاب غلاظ وهكذا يبدو لنا حسان مدافعاً عن نفسه، ومخففاً عما أصابه من خصمه، على الرغم مما في قوله من تهديد ووعيد، وتراكيب شعرية تنبئ عن شيء من الغلظة والقوة:
أتاني عن أمية زورُ قولٍ
وما هو بالمغيب بذي حفاظ
سأنشر إنْ بقيتُ لكم كلاماً
ينشر في المجامع من عكاظ
قوافي كالسّلام إذا استمرت
من الصّم المعجرفة الغلاظ
تزوركَ إذ شتوت بكل أرض
وترضح في محلك بالمقاظ
بنيت عليك أبياتاً صلابا
كأمر الوسق قعص بالشظاظ
ويستوقفنا امرؤ القيس منذراً متوعداً زاعماً أن دم أبيه لن يذهب هدْرا، وأنه سيقتل من أعدائه ما يشفي غليله ثأراً وانتقاماً، ويطلعنا على الكيفية التي أعدّ بها العدّة لهذه المهمة الكبرى، حيث جمع عدداً هائلاً من النياق والرماح ليفتك بخصومه، وكل ذلك من خلال صورة كلية تجتمع فيها الصور الجزئية الفرعية مؤلفة صورة عامة عمادها إعداد العدة للبطش بالأعداء والنيل منهم انتقاماً لدم الملك المقتول.:
والله لا يذهب شيخي باطلا
حتى أَبْتُر مالكا وكاهلا
يالهف هند اذ خطئن كاهلا
نحن جلبنا القرح القوافلا
يحملننا والأسل النواهلا
مستنفرات بالحصى جوافلا
يستنفر الأواخر الأوائلا
فصرت فيهم غانما وقاتلا
تلك-إذن- الصورة الأولى التي يمتزج فيها الترهيب والوعيد بالفخر المتأتى من نشوة الظفر بالثأر والنيل من الأعداء، بيد أن هذه الصورة سرعان ما تفقد مصداقيتها، ومن مدى حيويّتها وحماستها لدى القارئ حين يفاجأ برد الشاعر عبيد بن الأبرص الذي يفند تلك المزاعم، ويطلعنا على أن امرأ القيس قد جانبه الصوابُ فيما ذهب إليه، إذ أنه لم يفعل شيئاً ممّا قاله وإنما ذلك مجرد توهم، وإن قومه من بنى أسد قد انتصروا على والد امرئ القيس وأردوه قتيلاً، فما كان من امرئ القيس إلا أن يستنصر قيصر الروم على الأسديين، ولكنه لم يظفر ببغيته منه، وهذا ما يؤكده عبيد حين يدعو عليه بالهلاك، وهو لا يزال في الشام قبل أن يدرك القيصر، وكل ذلك من خلال أسلوب فيه شيء من التهكم والسخرية الجارحين:
يا ذا المخوفنا بمقتل شيخه
حجر تمنى صاحب الأحلام
لا تبكينا سفها ولا ساداتنا
واجعل بكاءك لابن أم قطام
حجر غداة تعاورته رماحنا
بالقاع بين صفاصيف وأحكام
أزعمت أنك سوف تأتى قيصرا؟
فلتهلكني إذاً وأنت شامى
وفي رواية أخرى يخاطب عبيد بن الأبرص امرأ القيس ساخراً مفندا مزاعمه ومبطلاً تهديده بالانتقام لأبيه حين يقول:
يا ذا المخوفنا بتقا
ل أبيه إذ لا لا وحينا
أزعمت أنك قد قتلـ
ت سراتنا كذبا وحينا
هلا على حجر بن أمـ
م قطام تبكي لا علينا
ولا شك أن تلك المحاورات الشعرية – إن صح أن نسميها كذلك- تضعنا أمام مجموعة من الحقائق التاريخية، من أبرزها أن الشعر قد سجل كثيراً من الأحداث التاريخية التي لها علاقة بجوانب مختلفة من الحياة العربية الجاهلية، ولعل أيام العرب خير دليل على ذلك، ثم أن هناك تواصلاً بين الشعراء، حيث إن الشعر سرعان ما تتلقفه الأسماع وإذا كان هذا الشعر نابعاً من حقائق مشبوهة أو مشكوك فيها، فإن الرد يأتي سريعاً ليدحض ما هو زائف، وتبقى الحقيقة هي السائدة، كما هو الشأن في قول امرئ القيس حيث تطلعنا الأخبار التاريخية أنه مات في طريقه إلى القيصر، ولم يستطع الثأر لأبيه خلاف ما أطلعنا عليه شعره، وليس هذا فحسب، بل قد نذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أن مثل تلك المحاورات الشعرية تدل على أن هناك تواصلا ثقافيا بين الشعراء مما يجعلنا نتوقع حركة شعرية نشطة في ذلك العصر الذي يتخيله الكثير عصرا متحجرا يطغى عليه الجهل والرتابة.
وما دام الهجاء قد ارتبط – في الغالب- بالفخر، وأن الشاعر الهجاء يعمل قريحته لإصابة المهجو في موطن ضعفه فإن للمهجو حق الرد، وقد يكون رده أقوى بحيث يعيد اعتباره واعتبار قومه متى امتلك الحجج الدامغة، بل إنه قد يجعل من النقيصة موقفا إيجابياً، ومن العيب مزية، فهذا عنترة- الذي عير بسواد لونه وبأمه الأمة الحبشية- على الرغم مما يعتمل في نفسه من أسى وألم بسبب منبته الهجين، فإن فروسيته ونفسه الأبية تأبيان عليه الرضوخ لشماتة الحاسدين وسخرية المتطاولين، ويرد على من يعيره مقرا بما نسب إليه من هجائه في النسب بيد أنه يرد موقف الضعف قوة حين يقول:
فان تكن أمّي غرابيةً
من أبناء حام بها عبتني
فإنّي لطيفٌ ببيض الضبي
وسمر العوالي إذا جئتني
ولولا فرارك يوم الوغى
لقدتك في الحرب أو قدتَني
في حين يخاطب الشماخ بن ضرار الربيع وقومه مهدداً إياه تارة، وساخراً متهكما تارة أخرى، ثم يحذره من مغبة إثارة سخطه ناصحا إياه بضرورة تجنب هجائه وإلاّ أمطره بصواعق من نفثات لسانه تلصق به العار والمذلة، حاثاً إياه على ضرورة الاستقامة من غفلته وحمقه إذ أن مهاجاته أيامُ لن تمر بسلام كما يتوهم، ولن تكون هينة مستساغة مثل اللبن الذي يشربه من نياقه البدينة التي يرعاها:
فان كرهتَ هجائي فاجتنب سخطي
لا يدركنك تقريعي وتصعيدي
وإن أبيتَ فإنّي واضع قدمي
على مراغم لفاخ اللغاديد
لا تحسبن يا ابن علباء مقارعتى
برد الصريح من الكوم المقاجيد
وقد يتلوّن التشكيل الشعري بتلون نوعية الهجاء ونوعية المهجو فأحياناً يعتمد الشاعر على الأسلوب الرصين والألفاظ الغليظة التي تحدث فزعاً ورهبة في نفس المهجو لا سيما إذا كان هذا الهجاء مرتبطاً بالفخر أو له علاقة بالحرب، كما لاحظنا في بعض النماذج الشعرية السابقة، وقد يبتعد فيه الشاعر عن الجدية المفرطة لا سيما حين يعمد إلى إظهار العيوب الخلقية، فيميل إلى إضفاء عنصر الإضحاك والسخرية أو التفكه، كأن يضفي مفارقات غريبه، أو يرسم لشخصية المهجو صوراً "كاركاتورية" وليس هذا فحسب، بل أن الشاعر يعتمد أحياناً تكثيف الصورة بحيث يصور في البيت الواحد أكثر من مظهر أو أكثر من عيب خلقي أو اجتماعي، فهذا خداش يهجو عبد الله بن جدعان، فيصور عيوبه الخلقية المتمثلة في قصر قامته وبدانة جسمه ودقة إليته حتى يبدو كأن لا عجز له، وقد أصيب بفتق في أحدى خصيتيه فأضحى على قصره كثير الشحم ما بين الرجلين، وإلى جانب هذا المظهر المضحك الذي يبدو عليه هذا الرجل، فإنه تاجر بطيء الحركة يعتمد أداء اليمين في كل بيعة يبيعها، حيث يقضي يومه مستلقياً لا يطيق الحركة:
أريْصعُ حلافٌ على كل بيعةٍ
وآدرِ مستلقٍ بمكة أعفل
ويقول خداش أيضاً في موضع آخر هاجياً رباح بن ربيعة العقيلي، مبرزاً عيوبه الجسدية، ومقللاً من قيمة نسبه، مكثفاً صورة الهجاء في بيت واحد ولكنه يحمل من المعاني ما يجعل المهجو يحتل أسفل المراتب الاجتماعية إذ يكفيه مذلة ومهانة أن قوم الشاعر سبَوا أمه وهي حامل به، فباعوها في سوق النخاسة:
بعناك في بطن مخضرٍّ عوارضها
ترى من اللؤم في عرنيها خنسا
ويفعل الحادرة قريباً من ذلك حين يهجو زبان بن سيار واصفاً أياه بالخنعة والغدر والفجور، وبأن به ميوعة واهتزازاً في شخصيته بحيث لا يثبت على حال:
لحا الله زبان من شاعر
أخي خنعة غادر فاجر
كأنك فُقَّاحَة نَوَّرت
مع الصبح في طرف الحائر
أما الأعشى فإنه يهجو عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان حين جمع بينه وبين جهنام ليهاجيه قائلاً: أيا عمير متى تشرق بما أذعت من قول كما تشرق مقدم الريح بالدم. فلا أنت من أهل قريب أهل الحجون والصفا وزمزم، فيأتي شيء تحاول جاهدا النيل مني، وما أنت ممن جعل الله بيوتهم في العلى بأجياد غربي الصفا والعرمرم، وما دام الأمر كذلك فالأجدر بك أن تلزم الصمت لأنك لم تبلغ بعد الدرجة التي تؤهلك لأن تهدد أمثالك ممن يفوقونك مجدا وشرفاً ونسبا.
وتشرق بالقول الذي قد أذعته
كما شرقت صدر القناة من الدم
فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا
ولا لك حق الشرب من ماء زمزم
وما جعل الرحمن بيتك في العلى
بأجياد غربي الصفا والمحرم
فلا توعدني بالفخار فانني
بنى الله بيتي في الدخيس العرمرم
وتعد تلك النماذج من أهم المسارات التي سار في ضوئها الهجاء الشخصي، وقد تأرجحت صوره بين المكاشفات الشخصية بين شاعر وآخر أحياناً وبين شاعر وفرد لا علاقة له بالشعر أحياناً أخرى، وتعددت وخزاته ليشمل كلا من التجريح في الأنساب حتى يقترب من الشتم في كثير من الأحيان والحط من قيمة الأفراد والجماعات وذلك حين يكشف عن المراتب الاجتماعية الدنيا للأفراد، كما أنه لم يهمل التعرض بالتهكم والسخرية للعيوب الخلقية ولنا أن نتعرف إلى أهم العيوب التي صورها الهجاء الموجه إلى القبائل والبطون.
لقد لاحظنا كيف تنوعت أساليب الهجاء الشخصي، وكيف كان الشعراء يتنافسون في كشف العورات الشخصية والعيوب الخلقية، ولنقف الآن عند الهجاء القبلي وهو الهجاء الذي يتجاوز الهجاء الفردي ليشمل القبيلة بكاملها، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ما توصف به القبيلة ليس دائماً يمثل الحقيقة، ولعل هذا يقودنا إلى القول بأن عنصر الصدق في غرض الهجاء يبدو ضعيفاً في جل هذا النوع من الشعر لأنه تحكمه المبالغات والتطرف، ويحكمه أيضاً البحث عن الصاق الصفات القبيحة تحت طائلة الانتقام أحياناً، ورد الفعل أحياناً أخرى، فعلى الرغم من أن شعر الهجاء قد يقول شيئاً من الحقيقة التاريخية أو الاجتماعية إلا أن هذه الحقيقة ممزوجة بكثير من المغالطات والمهاترات، فقد ينطلق الشاعر –مثلاً- مما هو مظهر إيجابي ليعكس حقائقه ويجعله مظهراً سلبياً، فالشاعر هنا يتحين الفرصة للانقضاض على فريسته ويختلق الحجج الواهية للحط من خصومه، ليحول المكرمة إلى مثلبة، والمزية إلى نقيصة، وكل ذلك في ظل ما يمثله هذا الشاعر أو ذاك من قدرة على تلوين الأمور بتلويناته الخاصة.
فالصيد -مثلاً – عادة مألوفة ارتبطت بحياة الجاهليين، وليس فيها ما يعيب أو يشين، ولا نجانب الحقيقة إذا عددناها من خصائص الفرسان وسادة القوم، لكن الشاعر يجهد النفس ليحول الصيد إلى سبب من الأسباب الجوهرية التي تقعد صاحبها عن بلوغ المجد وركوب المعالي، كأن يزعم أن خصومه ما تأخروا عن نيل المكرمات إذ تأخروا وما قصروا عن بلوغ شرف الفوز في ساحات الوغى إذ قصروا الا ابتغاء الصيد ومطاردة الوعول بالكلاب في حين لو أظهروا قوتهم في مقارعة الأعداء لكان الأمر مختلفاً، وبالطبع فإن الشاعر في مثل هذه المواقف يكيف الأمر حسب ما يريد الوصول إليه بعد أن يسجل الموقف النقيض ليجعل قبيلته تتيه فخراً وتختال عجبا وخيلاء على حساب القبيلة المهجوة التي لا تطاولها حسبا ومجدا:
أبنى زياد أنتم في قومكم
ذنب، ونحن فروع أصل طيب
نصل الخميس إلى الخميس وأنتم
بالقمر بين مربق ومكلب
لا تحسبن بنو طليعة حربنا
سوق الحمير بحانة مالكوكب
حيد عن المعروف سعي أبيهم
طلب الوعول برفضة وبأكلب
فالمتأمل في الأبيات السابقة تتجلى له تلك المبالغات التي يصورها الشاعر الذي يتطاول بلسانه على القبيلة الخصم ويجردها من جل صفات البطولة والمجد لتتبوأ قبيلته تلك المنزلة العليا، وحتى إن صور مثل هذا الشاعر وغيره بعض الحقائق فليست الحقائق كلها، وقد أكثر الشعراء –والفرسان منهم بخاصة- من شعر الهجاء الذي يمتزج بالفخر كما هو الشأن عند عنترة بن شداد الذي يقف مزهوا بتفوقه على بني ضبة وتميم في إحدى إغاراته، مشيراً إلى فرار الأعداء الذين فرطوا في نسائهم من أجل النجاة بجلدتهم، فقد أعطانا هذا الشاعر صورة عن بقايا معركة أبرز من خلالها صورة الجنود المهزومين الذين تفرقوا وتلاشى جمعهم لتقع عيوننا بعد ذلك على عدد من النساء منهن الحوامل ومنهن المرضعات من حديثات الولادة وفي ذلك ما ينم على وصمة العار وشر الفضيحة التي وقع فيها هؤلاء الأعداء، وفي هذا يقول :
فخلوا لنا عوز النساء وجببوا
عبابيد منهم مستقيم وجامح
وكل كعاب خدلة الساب فخمة
لها منصب في آل ضبة طامح
تركنا ضرارا بين عان مكبل
وبين قتيل غاب عنه النوائح
وعمرا وحيانا تركنا بقفرة
تعود هما فيها الضباع الكوالح
ويأبى الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي إلا أن ينزل بالهجاء اللاذع على قبائل الرباب ونمير، وبني كلاب، وسليم، واشجع، وذبان محاولاً بذلك أن يسند لكل قبيلة من تلك القبائل ما يناسبها من العيوب والنقائض، زاعماً من وراء ذلك بأن قبيلته هي صاحبة القوة والعزة والمنعة، وفي ضوء ذلك ليس بمستغرب أن تحتل قبيلة بني أسد مركز الصدارة والسيادة، فبنوا نمير فضلوا الفرار على المواجهة وأخلوا سبيلهم، في حين فر بنو كلاب قبل المعركة، على أن ذلك الفرار لم يكن لينجيهم من العذاب الذي سيصيبهم.
وليس الأمر كذلك لدى قبيلة سليم، فإنها لم تهرب، ولكنها جفلت وانهارت، وقد استطاع الشاعر هنا أن يستعمل صورة شعرية ذات دلالة إيحائية قوية، بما دلت عليه من شلل أصاب هؤلاء القوم الذين شلت حركتهم، وتتجلى تلك القدرة الفنية في الفعل (ضمز) الذي توسل به الشاعر لخلق تلك الصورة، حيث أن الضموز أن تمسك الدابة أو نحوها طعاماً في فمها فلا تجتره، فتموت الحركة عندها ليبين من خلال ذلك أن خصومه جمدوا عن الحركة من جراء مباغتتهم لهم وتلك حال الخائف الذي يدهمه داهم.
أما قبيلة "أشجع" فقد وسمها بالخنثى، وهي ذلك الشذوذ الذي لا يحمل معنى الذكورة ولا الأنوثة وإنما هو بين بين، وفي ذلك معاني التحقير والإذلال ما لا يطاق، ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين صور القوم وهم مثل التيوس في تفرقها وفرارها:
وبدلت الأباطح من (نمير)
سنابك يستثار بها الغبار
وليس الحي حي بني (كلاب)
بمنجيهم –وإن هربوا- الفرار
وقد ضمزت بحيرتها (سليم)
فخافتنا كما ضمز الحمار
وآمّا (أشجع) خنثى فولت
تيوسا بالشظي لهم تعار
وينزل الأعشى الأكبر باللائمة والهجاء اللاذع على علقمة بن علاشة وقومه قائلاً: وما ذنبي يا علقمة ما دمت حكمتني فوجدتني عالماً بما ظهر من مثالبكم وما بطن، فقد كان أبوكم وأبوهم شريفين ماجدين، وقد وطنا النفس من أجل بناء مجد مؤثل غير أنكم هدمتم ما ورثتم من مجد لم تكونوا أهلا له، فهم الاشراف القاهرون لعدوهم، وأنتم آخر الثلاثة من بيوت قومكم تأكلون الميتة من الحيوان، وتبيتون في ليالي الشتاء خوالي البال بعد أن تملؤوا بطونكم، في حين لا تبالون ولا تسألون عن جاراتكم من حولكم جوعى خاويات البطون، وما زلن كذلك يتضورن جوعاً يترقبن غفلة أهل الحي في الهزيع الأخير من الليل وطلوع النجوم ليخرجن بحثاً عما يقوتهن:
أعلقم وقد حكمتني فوجدتني
بكم عالما على الحكومة غائصا
كلا أبويكم كان فرعا دعامة
ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا
تبيتون في المشتى ملاءً بطونكم
وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا
يراقبن من جوع خلال مخافة
نجوم السماء الطالعات الشواخصا
وليس هذا فحسب بل إنه يصعّد من درجة تعنيفه وهجائه لعلقمة وقومه، متسائلاً تساؤلا إنكاريا ليؤكد حقيقة مرة تنزل كالصاعقة على المهجو حين يقول فهل كنتم إلاّ عبيدا تعدون من سفلة القوم ودهمائهم، وهل أنتم سوى مخادعين كذابين يتجلى الحقد في عيونكم الخوص الغائرة للعيان ولن يشفع لكم نكوصكم عن حقكم، ولن يغنيكم ذلك نفعاً يوم لا يحسن للكريم الأصيل أن ينكص على عقبيه. وإن صادف وأن التقى قومي وقومك فترقب قتالاً شديداً تتكسر فيه الرماح ويكثر فيه الطعان، وينتصر الشاعر لقومه في نهاية المطاف بطبيعة الحال:
فهل كنتم إلاّ عبيدا وإنما
تعدّون خوصا في الصديق لوامصا
تخامصكم عن حقكم غير طائل
على ساعة ما خلت فيها تخامصا
فان يلقَ قومي قومه ترَ بينهم
قتالا وإكسار القنا وتداعصا
ألم تر أن العرض أصبح بطنها
نخيلا وزرعا ثابتا وفصافصا
وقد سبق أن ذكرنا كيف أن عرب الجاهلية جعلوا من أيامهم سجلا حافلا لأمجادهم ومفاخرهم، ومن ثمة فان انتصار قوم يعني بالضرورة هزيمة قوم آخرين، وبذلك يمتزج فخر المنتصرين بجهاد المنهزمين، وكم تكون وطأة الهزيمة أشد على نفس صاحبها عندما يضطر قوم للفرار – أو الخروج من المعركة- مستسلمين تاركين في أعقابهم أعز ما يمثل شرفهم وعزتهم وإباءهم وهو نساؤهم لقمة سائغة للغانمين.
ففي يوم (النسار) –مثلاً- هزمت قبيلة عامر من لدن بني أسد، فوقف بشر بن أبي خازم الأسدي هاجيا العامريين، معيرا إياهم بتركهم لنسائهم من المرضعات سبيا لدى بني أسد، وقد كانت فرائص تلك النسوة ترتعد من شدة ما أصابهن من هلع وفزع، ومن المصير المجهول الذي سيؤلن إليه:
بنى عامر إنا تركنا نساءكم
من الشل والإرجاف تدمى عجوبها
عضاربطنا مستوطنو البيض كالدمى
مضرجة بالزعفران جيوبها
تبيت النساء المرضعات برهوة
تفزع من خوف الجنان قلوبها
ومن المفارقات التي سجلها الشعر الجاهلي في مجال الهجاء الذي يرتبط بتصوير النساء اللاتي يقعن سبايا، ما يروى من أن بني عامر تمكنوا من أخذ امرأة من عبس من بني سكين فسبوها، وظلت عندهم يوما أو بعض يوم ثم تمكن قومها من أن يستنقذوها، فبلغ عروة أن ابن الطفيل قد فخر بذلك، فانشد عروة معيرا إياهم بأخذ ليلى بنت شعواء الهلالية قائلاً:
إن تأخذوا أسماء موقف ليلة
فمأخذ ليلى وهى عذراء أعجب
لبسنا زماناً حسنها وشبابها
وردت إلى شعواء والرأس أشيب
كمأخذنا حسناء كرها ودمعها
غداة اللوى مغصوبة، يتصبب
ومما تجدر ملاحظته أن الشاعر بصفته يعد لسان حال قومه، والمدافع عن حياضهم، ونصرتهم في السراء والضراء، إلا أنه قد ينقلب عليهم ويهجوهم، لا كرها وتشفيا أو انتقاما، ولكن قد يكون إصلاح ذات البين لا سيما إذا بدا له ما يسيء أو يشين، فهذا الشاعر مالك بن نويرة يعز عليه أن يرى فريقا من أبناء قبيلته يفرون من ساحة الوغى ويتركون أصحابهم تحت رحمة أعدائهم، إذ حدث في يوم (نعف قشاوة) بين بكر وتميم أن فر بنو سليط بن يربوع من ساحة القتال تاركين أصحابهم فهجاهم شاعر نتيجة فعلتهم تلك داعيا عليهم بشر الوبال بعد أن سلموا ورجعوا القهقرى ولم يتقبل عذرهم بعد أن أتوه صاغرين معتذرين، لأنّهم بفعلهم ذاك فضحوا ذمارهم، وجلبوا العار والذل لأبناء القبيلة كلهم، ومن ثمة فلا يستحقون العتاب، ما داموا ألحقوا الخزي بقومهم، وجعلوهم عرضة للتجريح والتطاول.
وعلى ما في هذا القول من قسوة وتعنيف، فإنّه يظل إلى اللوم والعتاب أقرب منه إلى الهجاء الذي يغوص في البحث عن المثالب والنقائص:
لحا الله الفوارس من سليط
خصوصاً أنّهم سلموا وآبوا
أجئتم تطلبون العذر عندي
ولم يخرق لكم فيها إهابُ
دعتكم خلفكم فأجبتموها
تجازم في أعاليها الجُبّابُ
كفعلكم غداة لوى حيّ
فهذا من لقائكم عذابُ
إذا لا قيتم أبداً فضحتم
ذماركم فليس لكم عتاب
فكيف بكم وقد أخزيتموها
إذا ذكر الحفائظ والشباب
ثمّ إنّ القبيلة قد تجلب العار والمذلة لنفسها إن هي خالفت القيم المتعارف عليها، وأتت بفعل يحطّ من قيمتها وينقص من هيبتها بين القبائل، كأن تتواطأ مع الأعداء –مثلاً- ضد بطن من بطونها، فذلك يعدّ خروجاً عن ناموس القبيلة وأعرافها، ففي يوم "جَدُود" منعت "يربوع" الماء عن "بكر" ثم تراجعت عن قرارها فيما بعد فسمحت بورودها، ولكنّها اشترطت لذلك بعض الغنائم وتعدّ "بكر" عدواً "لتميم" فتصدى قيس بن عاصم المنقري ليربوع وهجاها على أثر فعلتها تلك قائلاً:
جزى الله يربوعاً بأسوأ سعيها
إذا ذكرت في النائيات أمورها
ويومَ جَدُودٍ قد فضحتم أباكمُ
وسالمتم والخيلُ تدمى نُحورُها
وأصبحتمُ واللّه يفعلُ ذاكمُ
كمهنوءةٍ جرباء أيُرزَ كورُها
وأصبحتم واللّه يفعل ذاكمُ
كمؤودةٍ لم يبق إلاّ زفيرُها
وهناك حادثة شبيهة بسابقتها تتمثل في أنّ قبيلة شيبان فرّطت في فارسها بسطام بن قيس الشيباني في يوم "العظالى" بعد أن أسرته تميم، فراح شاعر القبيلة العوام الشيباني يهجو قومه من أبناء وائل، ويصبّ عليهم جام غضبه لسبب ذلك التخاذل والجبن اللذين لا يليقان بأمثالهم، خاصة أنّهم كانوا فرساناً صناديد في المعارك ا |
|
الوتر الحزين
شخصيات هامة
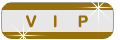


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32782
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: الهجاء بين المظاهر السلبية والإيجابية موضوع: رد: الهجاء بين المظاهر السلبية والإيجابية  13/9/2009, 20:53 13/9/2009, 20:53 | |
| |
|