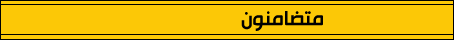الآثار السلبية للإقامة خارج البلاد
لفترة طويلة

غالبا ما يجد الأشخاص الذين يكلفون بمهام طويلة الأمد في بلدان أجنبية صعوبة في التأقلم لدى عودتهم إلى بلادهم الأصلية. وقد يترك العديد منهم عمله في غضون سنوات قليلة، وقد يترك البعض منهم بلده تماما.
شعرت هيلين مافيني، بعد15 عاما قضتها في مهام عمل بين اليابان، وسنغافورة، وأستراليا، أن الوقت قد حان للعودة إلى وطنها كندا. لكن بعد وقت قصير من عودتها، أدركت أنها ارتكبت خطأ كبير، كما تقول.
وتقول مافيني في رسالة إلكترونية: "عدنا إلى كندا في عام 2013 لأننا كنا نفكر في الاستقرار. وبعد عام واحد، لم يحدث ذلك. لقد وجدت أنه من الصعب التكيف مرة أخرى في بلدي، وشعرت أنني مختلفة جدا، وأن الأشياء تغيرت كثيرا. وقد وجدنا الشتاء الطويل صعبا جدا، وأن البلد أصبح هادئا جدا مقارنة بالأماكن التي اعتدنا العيش فيها سابقا".
ومن غير المستغرب أن مافيني، البالغة من العمر 46 عاما، وهي مستشارة في مجال التربية والتعليم، انتقلت مؤخرا إلى كمبوديا، حيث استلم زوجها وظيفة جديدة.
وتظهر استطلاعات رأي جديدة أن البيانات الشخصية للمغترب تتغير. ومن المرجح الآن أن تكون العمالة الوافدة في الوقت الراهن إما آسيوية، أو أوروبية غربية، أو أميريكية شمالية، بحسب أحد التقارير. ويأخذ المغتربون سلسلة متتابعة من المهام الأقصر أمدا، أو يتفقون على العمل في الخارج لمدد أطول. كما أن الناس أنفسهم يجدون أعمالا لهم في الخارج. وسواء بالاختيار أو التصميم، فالعديد منهم يجد نفسه يعيش بعيدا عن الوطن لمدة عقد أو أكثر.
اضطرابات العودة إلى الوطن
لكن هنالك سلبيات للعيش خارج الوطن. فالغياب عنه لمدة طويلة يمكن أن يحدث دمارا لشعور الشخص بهويته، وهو شعور يزداد حدة مع طول الوقت بعيدا عن الوطن، ويتوقف على عدد المرات التي يزور فيها ذلك الشخص وطنه، وفقا لنيكولا ماككافري، وهي طبيبة نفسية مقرها النرويج.
ولا يستطيع بعض المغتربين التكيف لفترة طويلة مع حياته الجديدة في وطنه القديم، ويعاني من صدمة ثقافية عكسية. وفي بعض الحالات، يعود المغترب إلى وطنه ولا يتمكن من استئناف حياته من حيث تركها.

كثير من المغتربين يشعرون بصدمة ثقافية عند العودة إلى بلدانهم بعد سنوات طويلة في الخارج
تقول مافيني التي تحمل جنسية مزدوجة، كندية وبريطانية: "كلما طال وقت غيابي، كلما قل شعوري بالانتماء لأي جنسية".
وحتى بالنسبة للمغتربين الذين يذهبون في مهام أقصر أمدا فإن العودة إلى الديار يمكن أن تثبت أنها ثورة كبيرة. والغالبية العظمى من الشركات (78 في المئة حسب دراسة حول التنقل بين البلدان للعمل) لا تتابع عملية الحفاظ على الموظفين بعد عودتهم إلى أوطانهم.
لكن تلك الشركات التي تفعل ذلك، تقول 52 في المئة منها إن ما يتراوح ما بين صفر و عشرة موظفين تركوا العمل في غضون سنة أو اثنتين من عودتهم للوطن، بينما قال 24 في المئة منهم إن ما بين 11 و 30 موظفا يتركون عملهم في تلك الفترة.
تقول نيكي توماس، المدربة في مجال الأداء الوظيفي في لندن: "العديد من الناس يبدأ في العودة إلى دياره عندما يرغب في الاستقرار وتكوين أسرة".
تضيف توماس، التي أمضت عامين للعمل في هونغ كونغ: "الفكرة وراء ذلك هي تربية الأطفال في نفس البلد الذي ولدوا فيه، وإعطاء هؤلاء الأطفال نفس جواز السفر، وهوية أهلهم. كذلك فإنك ترى وطنك من خلال نظارات وردية بعد تركه، وفي الوقت الذي تكبر فيه الأجيال، فإنك تريد أن تكون في 'الوطن' من أجل والديك". المشكلة هي أن تلك التوقعات البراقة قد لا ترقى إلى الواقع. فالعالم يستمر في التحرك أثناء غيابك. وتتذكر توماس الصدمة التي أصابت أصدقاءها البريطانيين الذين صادقتهم في هونغ كونغ لدى التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول: "أعتقد أن ذلك أخافهم، إذ وجدوا أن وطنهم لم يعد كما تركوه".
ورغم أن العديد من المنظمات تنفق أموالا هائلة، أحيانا تصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب السنوي للموظف، على تكاليف اغتراب الموظفين، فإن عملية العودة غالبا ما تتوزع ما بين خدمات لوجستية بسيطة مثل الرحلات الجوية، وتكاليف الانتقال، والرسوم المدرسية.
فرفاهية الموظفين وأسرهم، حتى لو كانوا قد أمضوا خمس سنوات أو أكثر خارج الوطن، نادرا ما تؤخذ في عين الاعتبار.
تقول توماس: "إنه شيء يتم تجاهله بشكل كبير، وهو شيء يحتاج إلى إعادة النظر بشكل جدي. فالعديد من الناس الذين يعودون إلى أوطانهم يريدون مغادرتها مرة أخرى لافتقارهم للدعم".

متسوقون في أحد شوارع كوالالمبور بماليزيا
والأسوأ من ذلك، ربما قبل الموظفون بمهام دولية اعتقادا منهم أنها ستسرع مسار حياتهم المهنية عندما يعودون إلى ديارهم، ليجدوا أنفسهم يقومون بدور لا يستخدم سوى القليل من المهارات التي اكتسبوها في الخارج وحسب.
صدمة ثقافية عكسية
تقول جيني كاستلينو، مديرة بمؤسسة كارتس: "العيش والعمل في الخارج يمكن أن يغير الموظف وأفراد عائلته بشكل كبير، وبطريقة ربما لم يتوقعوها أبدا".
ورغم أن توافر الوظائف قد يكون عاملا في قرار العودة إلى الوطن، وخاصة في هذه الأوقات الاقتصادية المضطربة، فالعديد من المغتربين يعودون إلى وطنهم ليكونوا أقرب إلى أسرهم.
وهذا هو السبب الذي جعل مي هو لي، العالمة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتي تبلغ 39 عاما، تعود إلى ماليزيا في عام 2009 بعد عشر سنوات قضتها في الولايات المتحدة.
ومع أن هو لي كانت قد استعدت لعودتها لبلدها قبل عام من ذلك، إلا أن ما عانته من اضطرابات نفسية، بعد عودتها جاء بمثابة الصدمة بالنسبة لها. وقد اتخذت لي في الأشهر القليلة الأولى من منزل والديها ملاذا لها، بعد أن تركت الصخب والضوضاء في نيويورك، ومختبرها في جامعة كولومبيا، لتعود إلى مدينة إيبوه في شمالي ماليزيا، حيث وتيرة الحياة الأبطأ، والأهدأ.
كانت لي قد خاضت مقابلة لوظيفة مع منظمة أميركية للحفاظ على التنوع البيولوجي في ماليزيا، وذلك عندما كانت في الولايات المتحدة، ولكن لم يكن يمكنها العمل إلا بعد تأكدها من توفر التمويل لذلك الدور الوظيفي.
تقول لي: "كانت كوالالمبور مكانا مختلفا تماما عما كانت عليه من قبل. لم أتمكن من التعرف على أي شيء، أو أي شوارع على الإطلاق. ولم يكن لدي سيارة، لذا كان الوضع صعبا جدا. لقد افتقدت وسائل النقل العام في نيويورك".
إضافة إلى ذلك، فإن ممارسات العمل في وطنها سببت لها صدمة أيضا، وتضيف: "كان علي التحول إلى الطريقة الآسيوية في العمل".
"أطفال الثقافة الثالثة"
تذكر كارين، وهي مواطنة بريطانية تقيم في ماليزيا حاليا مع زوجها، وتفضل أن تعرف باسمها الأول فقط، أن السنوات الـ 22 التي أمضياها في الترحال أصبحت أكثر صعوبة عندما كبر ابناهما الاثنان.

دخول المدارس الدولية بات أكثر صعوبة للوافدين بسبب الإقبال عليها من السكان المحليين
وكلاهما الآن يدرس في الجامعة في المملكة المتحدة، ولأنهما لم يعيشا أبدا مع والديهما في ماليزيا، فهما لا يعتبرانها وطنا لهما.
أما عالمة الاجتماع الأميركية، روث هيل أوسم، فقد صاغت مصطلح "أطفال الثقافة الثالثة" لوصف الأطفال الذين يقضون معظم سنوات تكوينهم خارج بلدانهم.
وكان الحافز وراء بحثها الذي أجرته حول هذا الأمر هو تجربتها مع أطفالها الذين تربوا في الهند، حيث أقامت هناك بعد أن أرسلت في إطار مشروع بحثي في الخمسينيات من القرن الماضي. ويميل أطفال الثقافة الثالثة العاديون، كما تقول هيل أوسم، إلى أن تكون لديهم إجابات متعددة حول انطباعهم عن بلدهم الأصلي، فهم لديهم أصدقاء من دول عديدة، وفي كثير من الأحيان لديهم القدرة على التحدث بأكثر من لغة، وهذا يؤثر على إجاباتهم بالفعل.
أما مافيني فتصف أطفالها بأنهم "مرنون"، لكنها تقول إنه قد يكون من الصعب عليهم تحديد فكرة الوطن بشكل دقيق. وكانت مافيني قد كتبت كتابا بعنوان "الخطوة التالية لسامي"، للمساعدة في توجيه الأطفال الآخرين الذين يعيشون حياة الترحال، ومناقشة فكرة الوطن والهوية لديهم.
في الواقع، تحدد مافيني بداية حياة الاغتراب لديها عندما كان عمرها 15 عاما، عندما قبل والدها وظيفة في مختبر للأبحاث في اليابان. لذا، فليس من المستغرب أنها اختارت أسلوب حياة مماثل لنفسها.
أما ابنتها التي تبلغ 20 عاما الآن، فهي تدرس الضيافة في أوتاوا، وكالعديد من أطفال الثقافة الثالثة، يبدو أنها ورثت حياة الترحال وعدم الاستقرار في مكان واحد من والديها. فلا خطط لديها للبقاء في كندا، وطموحها هو السفر إلى جميع أنحاء العالم.
bbc