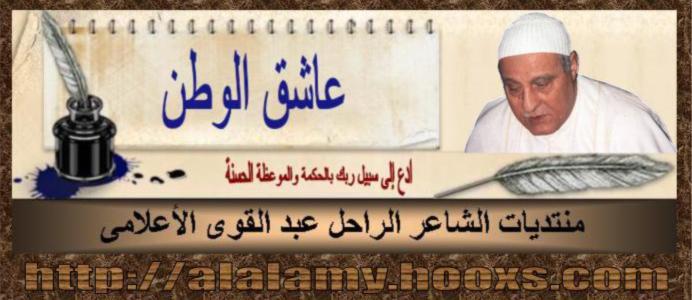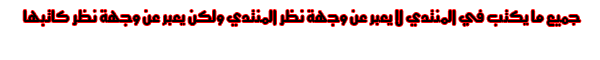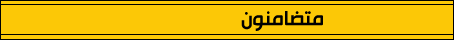|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
الوتر الحزين
شخصيات هامة
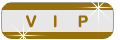


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 00:39 14/5/2010, 00:39 | |
| خبل
أ. د. عبد الله الدايل - -
09/11/1429هـ
جاء في المصباح: " (الخبل) بسكون
الباء: الجنون وشبهه كالهوج والبَلَه وقد (خَبَلَه الحزن) إذا أذهب فؤاده،
و(خَبَلَه) فهو مخبول، ومخبل والخَبَل – بفتحها: الجنون، وخبلته خبلاً فهو مخبول:
إذا أفسدت عضوَّا من أعضائه، أو أذهبت عقله، و(الخَبَال) يطلق على الفساد والجنون"
لذلك فقولهم: فلانٌ خِبِل – بكسر الخاء والباء، أو خَبَل – بفتحهما – له ما يعضّده
في الفصاحة، وجاء كلا الوصفين على أوزان الصفة المُشَبَّهة.
خَتَلَه
أ. د. عبد
الله الدايل - - 12/11/1429هـ
كثيراً ما نسمعهم يقولون: خَتَلَه –
فهذه الكلمة بتصاريفها ليست عاميَّة، كما يظنَّ بعضهم، بل هي فصيحة، يقال: خَتَلَ،
يَخْتِلُ، وخَاَتَل يُخَاتِلُ، والمعنى خَدَعَه كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في
الوسيط: "(خَتَلَه) خَتْلاً: خَدَعَه عن غفلة..
ويقال: خَتَلَه في الحرب:
داوَرَه وطلبه من حيث لا يشعر .. وخَتَلَ الصيدَ:
تَخَفَّى له. فهو خاتل. وخَتُول، وخَتَّال".
ولا يخفى أنَّ (خاتل): اسم فاعل.
أمَّا (خَتُول) و(خَتَّال) فهما صيغتا مبالغة.
ومثل ذلك: خَاتَلَه أي خادعه
وراوغه. و(تَخاتَلُوا) أي تخادَعُوا.
يتبيَّن أنَّ (خَتَلَه) و(خَاتَلَه) وما
تصرَّف منهما – فصيحة وليست عاميَّة.
غِلاَف لا غُلاَف
أ. د. عبد الله الدايل -
- 14/11/1429هـ
كثيراً ما نسمعهم يقولون: غُلاَف الكتاب – بضمِّ الغين،
وهذا غير صحيح، والصواب: غِلاف – بكسرها – كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في
المختار، "(الغِلافُ) بكسر الغين: غِلاف السّيف والقارورة، و(غَلَفَ) الشيءَ جعله
في الغِلاف. وأَغْلَفَه جعل له غِلافاً وجعله في الغِلاف".
وفي الوسيط:
"(الغِلاف): الغِشَاء يُغَشَّى به الشيءُ كغِلاف القارورة
والسيف والكتاب .. والغِلاف: الظَّرف توضع فيه الرسالة ونحوها والجمع
غُلُف".
يتبيَّن أنَّ صِحَّة الضبط غِلاَف – بكسر الغين – لا غُلاَف –
بضمَّها.
هَضْبَة لا هَضَبَة
أ.
د. عبد الله الدايل
كثيرا ما نسمعهم يقولون: هَضَبَة – بفتح الضاد –
للجبل المنبسط الممتد على وجه الأرض وهذا غير صحيح، والصواب: هَضْبَة – بسكون الضاد
– جاء في المصباح المنير: "(الهَضْبَة): (بسكون الضاد): الجبل المنبسط على وجه
الأرض، والأكمة قليلة النبات، والمطر القويّ أيضا، وجمعها هِضَاب: مثل كَلْبَة
وكِلاب" ويقال: رجلٌ هَضْبَة أي كثير الكلام، كما في المعاجم اللغوية.
يتبين أن صواب النطق: هَضْبَة – بسكون الضاد – لا هَضَبَة
– بفتحها.
قابَلَ فلانٌ فلاناً
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيرا ما نسمعهم يقولون: تقابَلَ فلانٌ بفلان باستعمال حرف الجرّ
(الباء)، وهذا غير صحيح، والصواب: قابَلَ فلانٌ فلانا – أي لَقِيِه بوجهه، ويقال
أيضا: قابَلَ الشيءَ بالشيء أي عارضه، كما يقال: قابَلَ الكتاب بالكتاب.
يتبيّن أنّ الصواب: قالبتُ فلانا لا تقابلتُ بفلان.
ولو قيل: تقابل فلانٌ، وفلان بالواو العاطفة لكان صوابا، لأنّ
المعنى: لَقِيَ كلٌّ منهما الآخر بوجهه، أمّا قولهم:
تقابل
فلانٌ بفلان – باستعمال حرف الباء مع الفعل (تَقَابَلَ) فغير
صحيح.
خَرِبَ خَرَبَ وخَرَّبَ وأَخْرَبَ
أ.
د. عبد الله الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: (خَرِبَ)،
و(خَرَبَ) و(خَرَّبَ) و(أَخْرَبَ) فهذه الكلمات وما تصَّرف منها فصيحة،
وليست عاميَّة كما يظنّ بعضهم.
جاء في
الوسيط: "( خَرِبَ) خَرَباً، وخَرَاباً: تَعَطَّل ... و(خَرَبَ) الشيء:
ثَقَبَه وشَقَّه. ويقال خَرَبَ دينه: أفْسَدَه بريبة أو شَكّ وخَرَبَ الشيء:
عَطَّلَه عن أنْ يُؤتِيَ منفعته ... و(أَخْرَبَه): صَيَّرَه خَرَاباً، وخَرَّبَه:
أَخْرَبَه".
وفي المصباح: "(خرب) المنزل فهو
(خراب) ... وأخربته، وخَرَّبته".
وفي المختار:
"(خَرِبَ) الموضع خَرَاباً، فهو خَرِبٌ، ودارٌ (خَرِبَةٌ)، وأَخْرَبَها
صاحبها. وخَرَّبُوا بيوتهم".
وأخيراً أختم كلامي بالشاهد القرآني، قال
تعالى: "يُخْرِبُونَ بُيِوُتَهُمْ بِأَيْدِيِهْمِ" سورة الحشر، من الآية (2).
ما يؤكٌد فصاحة الكلمة.
أسماء الأشهر عند العرب
====================
كانت بعض القبائل العربية
العاربة ومنهم قبيلة " عاد " تسمي
الأشهر على الشكل التالي :
مُؤْتَمِر : محرَّم
نَاجِر : صَفَر
خُوَّان : ربيع الأول
بُصّان : ربيع الآخر
رُبى : جمادى الأولى
حَنِيْن :
جمادى الآخرة
أصَمّ : رجب
عَاذِل : شعبان
نَاتِق : رمضان
وَعِل : شوّال
وَرْنَة : ذوالقعْدة
بُرَك : ذو الحجّة |
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
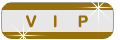


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 00:50 14/5/2010, 00:50 | |
| معاني أسماء الأشهر والأيام
الشهر هو الزمن أو الوقت الذي يستغرقه القمر للدوران
دورة كاملة حول الأرض، ولهذا أسمته العرب شهراً لأنه يشهر بالقمر. ويتراوح عدد أيام
الشهور بين 28 يوم (29 يوم في السنة الكبيسة) و31 يوم. أما مصدر كلمة أسبوع فهو
الرقم سبعة وهو عدد أيامه.
الأشهر العربية:
يقال أن أسماء الأشهر العربية وضعت في مطلع القرن الخامس
الميلادي. أما معانيها فهي كما يلي:
محرم: هو أول الأشهر
العربية. وسمي بهذا الاسم لأنه أحد الأشهر الحرم التي حرم القتال فيها.
صفر: قيل أن ديار العرب كانت تصفر أي تخلو
من أهلها للحرب. وقيل لأن العرب كانت تُغير فيه على بلاد يقال لها الصفرية. وقيل
لترك العرب أعداءهم صفراً من الأمتعة، وقيل لاصفرار مكة من أهلها.
ربيع الأول وربيع الآخر: سميا بهذا الاسم في فصل الربيع
وظهور العشب.
جمادى الأولى: جميع الأشهر
العربية مذكرة إلا جمادى الأولى والآخرة. وكان جمادى الأولى يسمى قبل الإسلام باسم
جمادى خمسة، وسمي جمادى لوقوعه في الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء.
جمادى الآخرة: كان يسمى قبل الإسلام باسم جمادى ستة أما
اسمه الحالي فكما ورد سابقا.
رجب: كان
العرب في الجاهلية يعظمون هذا الشهر بترك القتال، ولا يستحلونه فيه. واسمه من رجب
الشيء أي هابه وعظمه وقيل رجب أي توقف عن القتال.
شعبان: تشعبت القبائل في هذا الشهر ـ وقت التسمية ـ
للإغارة بعد قعودها عنها في رجب. وقيل يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء.
رمضان: كان يسمى قديما (ناتق) ولما غير
الاسم وافق زمن الحر والرمض، والرمضاء هي شدة الحر، ويقال رمضت الحجارة إذا سخنت
بتأثير أشعة الشمس.
شوال: قيل إن الإبل
كانت تشول بأذنابها أي ترفعها وقت التسمية طلبا للإخصاب وقيل لتشويل ألبان الإبل،
أي نقصانها وجفافها، وقيل شوال لارتفاع درجة الحرارة وادبارها.
ذو القعدة: قيل إن العرب كانوا يقعدون فيه عن الأسفار،
وقيل قعودهم عن القتال لأنه من الأشهر الحرم.
ذو
الحجة: هو شهر الحج. وكان العرب قديما يقيمون فيه حجهم إلى
الكعبة.
مَرْجُوج
أ. د. عبد الله
الدايل
يظنُّ بعضهم أنَّ هذا اللفظ عامّي، وليس كذلك، بل هو فصيح، كما في
المعاجم اللغويَّة.
جاء في المختار:
"(رَجَّهُ): حَرَّكَه وزَلْزَلَه، و(ارتَجَّ) البحر اضطرب"، وفي
المصباح: "(رَجَجْتُ الشيء رجًّ): حَرَّكته فارتَجَّ".
واسم المفعول:
مَرْجُوج يقال: رُجَّ فهو مَرْجُوج – ثم أصاب اللفظ تطوّر دلاليّ فأصبح يطلق لفظ
(المَرْجُوج) على من به اضطراب عقلي أو نفسي أو على المُتَسَرِّعَ لقولهم: فلان
(مَرْجُوج) على سبيل الجدّ أو الهزل.
وأقَرَّ مجمع اللغة العربية في
القاهرة لفظ (الارتجاج) وهو اختلاف في وظائف المخّ من ضربةٍ على الرأس، أو هزَّة
عنيفة.
يتبيَّن أنَّ كلمة (مَرْجُوج) عربيَّة
فصحى.
أسماء ساعات النهار عند العرب
أطلق أجدادنا العرب اسماً لكلّ
ساعة من ساعات النهار :
الصباح : أوَّل ساعة من النهار
،
والبُكور: ما قبل طلوع الشَّمس ،
والغَدَاة : مابعد طلوع الشَّمس ،
والضُّحى
: ارتفاع الشَّمس ، ورَأْد الضُّحى ، والإشراق ، والضَّحَاء ، والشُّرُوق ،
، والجُنوح ،
والهاجِرة أو الهجيرة : متى
استوت الشَّمس في كبد السَّماء ،
والظَّهِيْرَة ،
والرَّوَاح ، والأصيل ، والمساء ، والعصر أو القَصْر : ما بعد المساء ،
والطُّفُول أو الطَّفَل ، والعشيَّة : آخر ساعة من النهار،
والشَّفَق : أول ساعة من الليل وهو وقت صلاة المغرب ،
والعِشاء : بعدما يغيب الشَّفق ،
والعَتَمة : إذا اشتدّت ظلمة الليل ،
والسُّحَرة : آخر الليل قُبَيل الغَلَس ،
والغَلَس : ظلام آخر
الليل قبيل البلجة ،
والتنوير : ما بعد صلاة
الفجر
مقصور لا قاصر
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون، وهذا الأمر قاصِرٌ
على بعض الزملاء، يريدون لا يتجاوزهم إلى غيرهم، وهذا خطأ، والصواب:
وهذا الأمر مقصورٌ على بعض الزملاء. لأنَّ المعنى لا يتجاوزهم أي لهم خاصّة. أمَّا
(قاصر) فمعناه ناقص أو لم يبلغ شيئاً معيّناً – فمقصور هو اللفظ المناسب في هذا
السياق؛ يقال: قَصَرْتُ على نفسي كذا فهو مقصورٌ عليّ أي محبوسٌ عليّ لا يتجاوزني.
ونُحِسُّ بهذا الفرق بين (قاصر) و(مقصُور) في المعاجم
اللغويَّة.
يتبيَّن أنَّ صواب القول: هذا
الأمر مقصورٌ على بعض الزملاء لا قاصِرٌ عليهم.
عندما يكون
المعنى أنَّه محصور فيهم لا يتجاوزهم
بَعَثْتُه لا بَعَثْتُ به
أ. د. عبد
الله الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: بعثت بفلان إلى
فلان – بتعدية الفعل (بعث) بحرف الجرّ (الباء) وهذا غير صحيح، والصواب:
بعثتُ فلاناً إلى فلان – بتعديته بنفسه إلى المفعول به، وخاصة إذا كان المفعول به
عاقلاً. وقد أشارت إلى ذلك المعاجم اللغويَّة كالمختار،
والمصباح، وغيرهما، جاء في مختار الصحاح: "(بَعَثَهُ) و(ابتعثه) بمعنى واحد
أي أرسله، وبعثه من منامه أَهَبَّه وأيقظه وبَعَثَ الموتى نَشَرَهُم" وورد في
المصباح المنير: "(بعثت) رسولاً بعثاً: أوصلته وابتعثته كذلك ... وكل شيء ينبعث
بنفسه، فإن الفعل يتعدَّى إليه بنفسه فيقال: بَعَثْتُه".
يتبيَّن أنَّ صواب القول: بعثته لا بعثتُ
به.
خِصْب لا خُصُوبة
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: خُصُوبَة الأَرْض، وهذا خطأ،
والصواب: خِصْب – بكسر الخاء كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في المصباح:
"(الخِصْبُ): النماء والبركة، وهو خلاف الجَدْب، وهو اسم من أَخْصَبَ المكان فهو
مُخْصِب".
وفي المختار: "يقال: بَلَدٌ خِصْب وأَخْصَاب
أيضاً وَصَفُوه بالجمع"، وفي المعجم الوسيط: "(خَصِبَ) خِِصْباً: كَثُر فيه العشب
والكَلَأ فهو خَصِبٌ وخَصِيبٌ وهو وهي مِخْصَابٌ". وعلى الرغم من ذلك
أَقَرَّ مجمع اللغة العربيَّة في القاهرة كلمة (خُصُوبَة) تسامحًا وتوسُّعًا في
الاستعمال اللغويّ كما يبدو، وهذا اجتِهاد منهم؛ لأنَّ المعاجم اللغويَّة القديمة
تخلو من كلمة (خُصُوبَة).
يتبيَّن أنَّ صواب القول:
خِصْب لا خُصُوبة؛ إذ يقال: خِصْبُ الأرض والمكان والبلد لا خُصُوبة الأرض
.
تَوَّهَهُ
أ. د. عبد الله
الدايل
يظنُّ كثيرون أنَّ كلمة (تَوَّهَهُ) عاميَّة، وليست كذلك بل هي فصيحة
ومعناها: أَضَلَّهُ وضيَّعه، ورَصَدَ لها في
المعجم
الوسيط ثلاثة معانٍ: "(تَوَّهَهُ): أَضَلَّهُ الطريق، وأَهْلَكَهُ، وتَوَّهَ
نَفْسه: حَيَّرها". ويقال من الجذر نفسه: تَاهَ، وتَيَّهَ، جاء في
المختار: "تاه يَتِيهُ: تَكَبَّرَ، وتاهَ في الأرض يَتِيهُ: ذَهَبَ مُتَحَيِّراً،
وتَيَّهَ نَفْسَه، وتَوَّهَ نَفَسه بمعنى واحد: أي حَيَّرَها وطَوَّحَهَا. وما
أَتْيَهَهُ وأَتْوَهَهُ!". أي ما أَشَدَّ ضياعه!
يتبيَّن أنَّ قول بعضهم: تَوَّهَهُ، وتَوَّهَنِي، وتَوَّهْتَنِي –
فصيح وليس عاميَّاً
عُصْفُور لا عَصْفُور
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمع بعضهم يقول: عَصْفُور بفتح العين، وهذا خطأ، والصواب:
عُصْفُور – بضمِّها – كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في المختار: "و(العُصْفُور)
طائر والأنثى (عُصْفُورة)" (بضمِّ العين)، وفي المصباح: "و(العُصْفُور) بالضمّ
معروف، الجمع عصافير".
وزاد في الوسيط: "العُصْفُور:
عظمٌ ناتئٌ في جبين الفرس، وهما عُصْفُوران يَمْنة ويَسْرَه، والعُصْفُور: مسمار
السفينة. والجمع عصافير. ويقال: نَقَّتْ عصافير بطنه: جاع. وطارت عصافير رأسه:
تَكَبَّر".
يتبيَّن أنَّ
الصواب: عُصْفُور بضمِّ العين لا عَصْفُور بفتحها.
باقَ الشيء يَبُوقُه
أ. د. عبد الله الدايل
يظنّ
كثيرون أنَّ كلمة (باقَ) التي بمعنى سَرَقَ عاميَّة، وليست كذلك، بل هي فصيحة ولها
معانٍ سَلْبيَّة متنوِّعة كما في المعاجم اللغويَّة يقال: باقَ بَوْقًا: فَسَدَ،
وغابَ، وباقت السفينة: غرِقَت، وباقَ الرجل: كَذَبَ، وجاء بالشرّ، وغَدَرَ،
وسَرَقَ، وباقُوا عليه بمعنى اجتمعوا عليه فقتلوه ظُلْماً (ينظر
المعجم الوسيط، ("باق").
يتبيَّن أنَّ قولهم: باقَ
فلانٌ الشيء: بمعنى سَرَقَه. وهو تعبير فصيحٌ، وليس
عاميّاً.
مَناحَة لا مَأْتَم
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيرا ما نسمعهم يقولون: كُنّا في مَأْتَم فلان، وهذا فيه نظر،
والأجود: كنا في مَناحة فلان، وهو الأصح كما في المعاجم اللغوية، لأن (المأتم) يكون
في الخير والشر، أما (المناحة) فتكون في الشرّ فقط. أَتِمَ بالمكان يَأْتَم: أقام،
واسم المصدر والزمان والمكان (مَأْتَم) ومنه جاء في المصباح: "قيل للنساء يجتمعن في
خير أو شر (مَأْتَم) مجازا، قال ابن قتيبة: والعامَّة تخصُّه بالمصيبة، فتقول كُنا
في (مَأْتَم) فلان، والأجود في مَنَاحَتِه".
وفي
المختار: "(التّناوُح) التقابل، وناحت المرأة نِياحاً. وتقول: كُنا في (مَنَاحَة)
فلان".
وورد في الوسيط: " (ناحت) الحمامة: سَجَعَت، وناحت المرأة
على الميِّت: بكت عليه بجزع وعويل.. والمَنَاحَة: النُّوَاح.. يقال: كُنا في مناحة
فلان. والنساء يجتمعن للحُزُن".
وجاء فيه أيضا: "(المأتَم): الجماعة من
الناس في حُزْن أو فَرَح، وغَلَبَ استعماله في الأحزان. وجمعه (مآتم)".
يتبين أنّ الأجود في هذا السياق: مَنَاحَة لا
مَأْتَم.
|
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
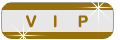


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 00:54 14/5/2010, 00:54 | |
| استشاظ غضباً لا استشاط
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: استشاط غضباً – بالطاء، وهذا غير صحيح،
والصواب اسْتَشَاظَ – بالظاء – كما في المعاجم اللغويَّة؛ لأنَّ الفعل (شاظَ) معناه
هاجَ ووَخَزَ، واشْتَدَّ – يقال: شَاظَ الغضبُ أي اشْتَدَّ. فإذا قيل (اسْتَشَاظَ)
غضباً – كان المعنى أبلغ في الدلالة على الغضب، ثم إنَّ شَاظَ من الجذر (ش و ظ)،
ومن الجذع (شوظ) ومعروف أنَّ (الشُّواظ) اللهب، ووهَج الحر وهما أقرب إلى الغضب –
أمَّا (شاط) بالطاء فهو من الشوط يقال شَاطَ الفرس أي عَدَا وجَرَى، وأُجْهِدَ.
جاء في المعجم الوسيط: "(شاظَ) به المرض: هاجَ
ووخَزَه، وشاظ الغضب: اشْتَدَّ.
يتبيَّن أنَّ صواب النطق: استشاظَ غضباً بالظاء لا اسْتَشَاطَ –
بالطاء.
[size=21][size=25]هذا أمرٌ مَزِيْدٌ فيه لا مُزَاد
فيه
أ. د. عبد الله الدايل
كثيراً ما
نسمعهم يقولون: هذا أمرٌ مُزَادٌ فيه – بضمِّ الميم وفتح الزاي، وهذا غير صحيح،
والصواب: مَزِيد فيه – بفتح الميم وكسر الزاي؛ لأنَّ فعله أصلاً ثلاثي وهو (زادَ)،
فاسم المفعول منه (مَزِيد) والأصل مَزْيُود – وحسب القانون الصرفي تحَّولت
(مَزْيُود) إلى (مَزِيد) أمَّا (مُزَاد) فهي اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي
(أزاد) وليس مراداً في هذا السياق لأنَّ الأصل أنْ يقال: زادَ في كذا أو على كذا
وليس أَزَادَ في كذا.
يتبيَّن أنَّ صواب القول: هذا
أمرٌ مَزِيْدٌ فيه لا مُزَادًٌ فيه؛ لأنَّ (أزادَ) غير مسموع وغير مستعمل – ولم
يُذكر في المعاجم اللغويَّة.
كُلْوَة وكُلْية لا كِلْوَة
أ. د. عبد
الله الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: كِلْوَة – بكسر الكاف – للعضو الذي
يُنَقِّي الدم ويُفْرِز البول وهذا غير صحيح، والصواب: كُلْيَة أو كُلْوَة – بضمِّ
الكاف فيهما، كما في المعاجم اللغويَّة كالمصباح والمختار.
جاء في المصباح:
"و(الكُلْيَة): من الأحشاء معروفة، و(الكُلْوَة) بالواو لغة لأهل اليمن، وهما بضمِّ
الأول، قالوا ولا يُكْسَر".
وفي المختار: "ولا تقل كِلْوَة بالكسر" والجمع
كُلْيات وكُلًى – بضمّ الكاف أيضا.
وفي المصباح معلومة طريفة نسبها صاحب
المصباح للأزهري؛ إذ قال ما نصُّه: "وقال الأزهري: (الكُلْيَتان) للإنسان ولكلّ
حيوان، وهما لحمتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين وهما منبت زرع
الولد".
يتبيَّن أنَّ صواب القول: كُلْوَة أو كُلْيَة
بضمِّ الكاف لا كِلْوَة بكسر الكاف.
اللُثْغَة
أ. د. عبد
الله الدايل
كثيرا ما نسمعهم يقولون في وصف ثقل اللسان بالكلام أو عند
ظهور حُبْسة في اللسان: عند فلان لَثْغَة ـ بفتح اللام أو لَتْغَة ـ بالتاء ـ وهذا
خطأ، والصواب: لُثْغَة ـ بضم اللام ـ ثم حرف الثاء، وهي تحول اللسان من حرف إلى حرف
كقلب السين ثاءً، والراء غيناً.
والوصف من ذلك: (ألْثَغ)، و(لَثْغَاء) بالثاء،
وليس ألْتَغ ولَتْغَاء ـ بالتاء.
جاء في مختار الصحاح:
"(اللُّثْغَة) في اللسان ـ بالضم ـ أن يُصَيِّر الرَّاءَ غيْناَ أو لاماً، والسين
ثاءً ... فهو (ألْثَغُ) وامرأةُ (لَثْغَاءُ).
يتبين أن صواب
النطق: لُثْغَة لا لَثْغَة ولا لَتْغَة و(ألْثَغ) بالثاء لا (ألْتَغ)
بالتاء |
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
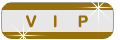


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 01:14 14/5/2010, 01:14 | |
| يَتَصَنَّت للحديث
أ. د. عبد الله الدايل
كثيرا ما نسمعهم يقولون: فلانٌ يَتَصَنَّت للحديث أي
يتسمّع له بتقديم الصاد على النون وهذا خطأ، والصواب: فلانٌ يَتَنَصَّت للحديث
بتقديم النون على الصاد - لأن فعله: (نَصَتَ)، فلا مُسَوِّغ لتقديم (الصاد) على
(النون) فليس في المعاجم اللغوية (صَنَتَ) بل فيها (نَصَتَ) وهو الذي يوافق النطق
العربي الصحيح.
ففي "المعجم الوسيط": "نَصَتَ له نَصْتاً: سكت مُسْتمِعا،
و(أَنْصَتَ): اسْتَمَعَ وأحسن الاستماع للحديث، وانْتَصَتَ له: نَصَتَ، و(تَنَصَّت)
تَسَمَّع وتَكَلَّفَ النَّصْتَ، واسْتَنْصَتَ: وقف مُنْصِتاً، والنُّصْتةُ:
الإنْصَات".
ومثل ذلك في "مختار الصحاح" و"المصباح المنير".
يتبيّن أنّ صواب
النطق: يَتَنَصَّتُ لا
يَتَصَنَّتُ.
أنا
شاكرٌ لا ممنُونٌ
أ. د. عبد الله الدايل
كثيراً
ما نسمعهم يقولون: أنا ممنونٌ – وهذا غير صحيح، والصواب: أنا شاكر، لأنَّ كلمة
(ممنُون) كما في المعاجم تعني: القويّ، وأقصى ما عند الرجل – جاء في الوسيط:
"(الممنُون): القويُّ. وأقصى ما عند الرجل. يقال: بلغت ممنونه: أقصى ما عنده" وتعني
مقطوع، ففي المصباح: "يقال: مننتُ الشيء منًّا: إذا قطعته، فهو ممنُون" أي أنَّ
كلمة (ممنون) تعني: مقطوع، يؤكِّد ذلك قوله تعالى: "فَلَهُمْ أَجرٌ غَيْرُ
مَمْنُون" سورة التين، من الآية رقم (6). أي غير مقطوع.
يتبيَّن أنَّ صواب
القول: أنا شاكرٌ صنيعك، لا أنا ممنُون؛ لأنَّ أشهر معاني (المَنّ): القَطْع
والنقص، والإنعام – أي أنها من الأضداد.
شهر
الله (المُحَرَّم) لا (مُحَرَّم)
ا. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: (مُحَرَّم) أوَّل شهور السنة, وهذا غير
صحيح, والصواب: المُحَرَّم لأنه لا يأتي إلاَّ معرّفاً بأل.جاء في المختار:
"و(المُحَرَّم) أوَّل الشهور" هكذا نطقت العرب. وجاء في الوسيط: "و(المُحَرَّم):
أوَّل شهور السنة الهجرَّية, وهو ثالث الأشهر الحُرُم الثلاثة المتتابعة. ولا يأتي
المُحَرَّم إلاَّ مُعَرَّفاً بأل. وجمعه المحَارِم والمحاريم والمحرَّمات".
وفي المصباح:"وأدخلوا عليه الألف واللام لمحاً للصفة في الأصل, وجعلوه
علماً بها, مثل النجم والدبران, ونحوهما.. فالأشهر الحُرُم أربعة وهي رجب, وذو
القعدة, وذو الحجَّة, والمُحَرَّم"
هذا
ألف لا هذه ألف
أ. د. عبد الله
الدايلكثيراً ما نسمعهم يقولون: هذه ألفُ
ريال بالتأنيث، وهذا خطأ، والصواب: هذا ألفُ ريالٍ بالتذكير، لأن العدد "ألف" مُذّكَّر. ويُقال: ألفٌ مُؤَلَّف بالتذكير أي تام ولا يقال: ألْفٌ مُؤَّلَّفة بالتأنيث، لأن "ألف" كما في المعاجم اللغوية مذكر. جاء في الوسيط: "(الأَلْفُ): عشر مئات. ويقال: ألْفٌ مؤلّفٌ: تامٌّ. وجمعه آلاف، وأُلُوف". وفي المختار: "(الألف) عدد وهو مذكر يقال: هذا ألفٌ واحد، ولا يقال: واحدة".
من أقوال العرب في دلالات العين
أوضاع العين
أوضاع العين هى تلك
التى تأتى من تطابق إشارات العين وحركتها من جهة وبين المعنى الذى تؤديه من جهة
أخرى .. وقد عكف علماء اللغة على جمع هذه الأوضاع، فجمعوا منها مايشبه المعجم الذى
صنف أوضاع وحركات العين .
قال الحسن بن الهيثم :
" المعانى الجزئية
التى تدرك بحاسة البصر كثيرة وهى : الضوء و اللون و البعد و الوضع و التجسم و الشكل
و العظم و التفرق و الإتصال و العدد و الحركة و السكون و الخشونة و الملاسة و
الشفيف و الكثافة و الظل و الظلمة و الحُسن و القبح " .
ومن أبرز معانى العين :
1 – زَرَّت ...[بمعنى إذا توقدت العين من خوف أو غيره ]
2
– شخصت ... [ بمعنى إذا لم تكد العين تطرف من الحيرة ]
3 – رمق ... [ بمعنى
إذا نظر الإنسان إلى الشىء بمجامع عينه ]
4 – لَحَظَ ... [ بمعنى إذا نظر
الإنسان من جانب أذنه ]
5 – لمح ... [ بمعنى إذا نظر الإنسان بعجلة ]
6 – حَدَجَ ... [ إذا نظر بحده ]
7 – رشق ... [ إذا نظر بشدة ]
8 – شَفَنَ ... [ إذا نظر نظرة المتعجب أو الكاره ]
9 – شَزَرَ ...
[ إذا نظر بعداوة ]
10 – نظر ... [ إذا إلتفت إليه بمحبة ]
11 –
توضحه ... [ نظر إليه نظرة استثبات ]
12 – استكفه _ استوضحه _ استشرفه ..[
كمن وضع يده على حاجبيه ليستبين الشيىء ]
13 – استشفه ... [ كمن يرفع الثوب
إلى فوق لينظر إلى عيب فيه ]
14 – لاحه ... [ كمن نظر إلى شيىء اختفى فجأة
]
15 – نفضه .. [ الذى ينظر إلى جميع من فى المكان حتى يعرفه ]
16
– تصفحه .. [ [ نظر فى كتاب ]
17 – حدّقَ .. [ توسيع حدقة العين لشدة النظر
]
18 – برقَ ... [ غياب سواد العين من الفزع ]
19 – حمَّج ... [
فتح العين بالتهديد أو الإفزاع ]
20 – دَنْقَسَ _ طَرْفَشَ .. [ كسر عينه
من النظر ]
21 – أسجد ... [ أدام النظر مع سكون ]
22 – تبصر ... [
نظر إلى الأفق ]
23 – أثأر ... [ أتبع الإنسان الشيىء ببصره ]
24 –
فتر ... [ النظر فى السكون وهى عنوان الضعف ]
أقوال العرب فى دلالات العين
· إمتلاء العين
جاء فى معنى امتلاء
العين ، أى انبساطها بمحاسن الشخص الذى تنظر إليه حتى لا تتسع لغيره ، كما قال
الشاعر :
هى الدرُّ منثــورا إذا ما تكلمت .. .. وكالدر
مجموعا إذا لم تتكلمِ
تُعَبّـدُ أرباب القـلوب بدَلهــا .. .. وتملأ عين
الناظر المُتـوسمِ
· بريق
عينيه
يبعث البريق شدة النظر .. وهى مفردة تحمل معنى الخوف و
الفزع الناتجين عن الغضب وما يشبهه من مثيرات تبعث الإنسان على الغليان وتجعله فى
موقف الحيران .
فعلقت بكفهـــا تصفيقا .. .. وطفقت
بعينها تبـريــقــا
نحـــو الأميــــر تبتغى التطليقا
· البكاء
الدموع علامة البكاء ، وهو إشارة من إشارات العين التى تدل على الحزن
الشديد ، وما أجمل المزاوجة بين دمعة العين ومعنى الحزن الذى تبعثه دوافع كثيرة
كهجر الحبيب وفقدان الأهل والألم .. ومن أمثله هذا ما أنشده صلاح الدين الصفدى :
فلا تسـلنى عن وجدى وعن .. .. قلقى وســـائل الدمع
يُنْـبِـيـكــا
هَـذِى دُمُوعى عن حالى مترجمة .. .. وهـذه أَلْسُـنُ
الشكوى تناجيكــا
· حركة
الجفون والحواجب
الحواجب فوق العين هى أداة تشكيل مفردات
العين وهى تساعد على فهم أغراض العين بشكل كبير :
ولما
رأيــن البين قد جد جــده .. .. ولم يبــق إلا أن تبين الركائب
دنونا
فسلمنـا ســلاما مُخَالسـا .. .. فردت علينـا أعين وحـواجب
تصــد بـلا بغض
ونخلس لمحـة .. .. إذا غفلت عنا العيون الـرواقب
وكسر الحاجب مع
نظرة العين يؤديان رسالة الحب بما فيها من لوعة وفرحة :
ألا مَـنْ لقلب لا يزال رَمـيـّـة .. .. لِلَمْحَةِ طـرف أو لكسرة
حاجب
· الحدج
رمى البصر مع حدة النظر .. قال أبو النجم العجلى :
تقتلنا منهــا عيــون كأنهـا .. .. عيــون المهـا ما طرفهن بحادج
· لون حُمْرَة العين
احمرار العينين إشارة تلفظها العين دليل وجد وفقد وما
يشبههما من هم وغم ، وإذا احمرت العين ، تحدثت بما فيها من سقم ومرض .
قالوا اشتكت عينه فقلت لهم .. .. من كثرة القتل مسها
الوصب
حمرتها من دماء من قتـلـت و الدم .. .. فى النصل شاهد عجب
وحمرة العين تحمل دلالة أخرى تتمثل فى الخداع و المكر .
إنى نهيت ابن عمار وقلت له .. .. لا تأمنن أحمر العينين
و الشعرة
حمج
الحمج وضع تأخذه العين بحيث تصغر بغية النظر ومن أمثلتها
قول أبى العيال الهذلي :
وحمج للجبــان المــو ت .. ..
حتـــــى قلبه يجب
· حملق
وتعنى الفزع
رأت رجـلا أهوى
إليها فحملقت إليــه .. .. بمآقــى عينها المتقلب
وكما تدل أيضا
على الشراسة :
و الليث إن أوعــد يومــا حملقا .. ..
بمقلــة توقـد فصــار أزرقا
· خزر
الخزر أن ينظر بمؤخرة العين وهى لفظة تحمل
أيضا معنى الغضب :
ما بــال قومك يــا ربـاب .. ..
خُــزرا كــأنهم غِـضــاب
رنــا
الرنا يكون بإدامة النظر مع سكون الطرف ، والعين حين
تديم نظرها وهى ساكنة فإنها ترنو وهى إشارة تؤدى معنى المراقبة ، قال عمر بن أبى
ربيعة :
وترنو بعينيها إلىَّ كمــا رنا .. .. إلى ظبية
وسط الخميلة جُؤذُرُ
وقال المتنبى :
ترنو إلىَّ بعين الظبــى مجهشة .. .. وتمسح الطــل فوق الورد بالعنم
· شزر
يشبه لحظ العين ، وهو النظر بمؤخرة العين ، وهو تعبر العداوة
و الكيد ، وهو أكثر ما يكون فى حال الغضب ، يقول فى هذا صريع الغوانى :
جعلنـا علامــات المودة بيننا مصايد .. .. لحظِ هُــن
أخفى من السحر
فأعرف فيها الوصل فى لين طرف .. .. وأعرف فيها الهجر فى
النظر الشــزر
شفن
هو النظر باعتراض ، وتدل على التعجب ، جاء فى قول رؤية
بن العجاج :
يقتلن بالأطراف والجفــون .. .. كــل فتى
مرتقب شفون
صفح
ليس الصفح النظر فى كتاب فقط ، ولكنه أيضا النظر فى وجوه
الناس للتعرف إليهم ، و الصفح يكون بفتح الجفون وامعان النظر للوقوف على خفايا
الأمور ، أنشد ابن الأعرابى :
صَفَحْنـا الحُـمُول
للسلام بنظرة فلم .. .. يـك إلا وَمْـؤُها بالحواجب
· ضيق العين
انبساط العين دليل
رضاها وسعادتها ، أما ضيقها فيشير إلى حالتها من التعب والحيرة ، وقد ستخدم تعبير
ضيق العين كناية عن البخل ، ومن شواهد ذلك قول ابن النبيه :
يصــد بطرفه التركى عنى .. .. صدقتم إن ضيق العين بخـل
· غض
الغض هو
كسر البصر وكفه ، وهو يشمل تحول البصر وانصرافه وقصره عن الشيىء ، أى أعرض عنه
بالطرف ومال عنه بالنظرة .. وتستعمل تعبيرا عن الحياء وأحيانا تكون إشارة تعنى
الخوف من رفع النظر :
وما كان غـض الطرف منا سَجِيَّـة
.. .. ولـكـنـنـا فـى مَذْحِج غُـربـان
· غمز
تعنى إشارة الغمز إذا صدرت من العين العيب،
والشخص المغـامز هو الشخص المعايب ، وعليه فإن الشخص الذى يغمز ، يسعى لإظهار عيب
فى الشخص الذى ينظر إليه :
ومن يطـع النسـاء يـلاق
منهـا .. .. إذا غمزن فيــه الأقــورينا
والأقورينا هنا تعنى
الدواهى
· اللحظ
اللحـاظ فى الإنسان هى شق العين الذى يلى الصدغ ،و اللحظ هو أن ينظر
الإنسان بلحاظ العين :
كَـذَبْتَ يا من لَحَانى فى
محبتــه .. .. ما صورة البدر إلا دون صورتــه
يـارب إن لم يكن فى وصله طمع
.. .. ولـم يـكن فَرجُ من طول جفونه
فاشف السقام الذى فى لحظ مقلته .. ..
واستر مــلامة خديه بلحيــته
· نفض
النفض أن ينظر الشخص إلى جميع ما فى المكان
بغية التعرف عليه ، وهى إشارة من العين تدل على الهيبة و المهابة ، وهى تصدر عن
الملوك وذوى النفوذ و الشأن
إلــى ملك يستنفض القوم
طرفه .. .. له فوق أعواد السرير زئيـــر
|
|
|
|
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
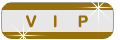


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 01:26 14/5/2010, 01:26 | |
| حَلَقَ لحيته لا ذقنه
أ. د. عبد الله
الدايل
أ. د. عبد الله الدايل
هناك كثيرون لا يفرِّقون بين (اللحية)
و(الذقن) فيقولون: حَلَقَ ذِقْنَه، وهذا غير صحيح، والصواب: حَلَقَ لحيته؛ لأنَّ
(اللحية) كما في المعاجم اللغوية هي: الشعر النازل على الذّقن أما (الذقن) فهو
مُجتمع اللحيين، و(اللحى): عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان، أي أنّ الذقن هو
التقاء عظمي الحنك.
جاء في المصباح: "(الذقن) من الإنسان: مجتمع لحييه،
وجمع القِلٌّة: أذقان وجمع الكثرة ذُقُون. و(اللحية): الشعر النازل على الذقن،
والجمع (لحى) و(اللحى): عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت
الشعر، وهو أعلى وأسفل، وجمعه (أَلْحٍ ولُحى)".
يتبيَّن أنَّ الصواب: حَلَقَ لحيته لا حَلَقَ ذِقْنَه؛ لأنَّ
(اللِّحْيَة): شعر الخدّين والذّقن
غُرَبَاء لا أغْرَاب
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: أغْراب – في جمع (غريب)، وهذا غير صحيح،
والصواب في جمع (غريب): غُرَباء – أكدت ذلك المعاجم اللغوية كالمختار، والمصباح
والوسيط، وهو الذي يوافق النطق العربي الصحيح.
جاء في المصباح: "(غَرُبَ)
الشخص غَرَابَةً: بَعُدَ عن وطنه، فهو (غريب)، وجمعه (غُرَباء)".
وفي
الوسيط: "(غَرُبَ) عن وطنه: غَرَابَةً، وغُرْبَة: ابتعد عنه، و- الكلام غَرَابةً:
غَمَضَ وخَفِيَ. فهو غريب. والجمع غُرَباءُ. وهي غريبة. والجمع غَرَائب".
يتبيَّن أن الصواب في جمع (غريب): غُرَباء لا
أغْراب.
تَقَزَّزَ من كذا لا قَرَفَ منه
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: قَرَفَ فلان من كذا يريدون (تباعَدَ) منه، وهذا
غير صحيح، والصواب: تَقَزَّزَ منه؛ كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في المختار:
"(التَقَزُّز) التباعد من الدّنس، وقد (تَقَزَّزَ) من كذا" ... و(القَرَف) مُدَاناة
المرض"، وفي الوسيط حصرٌ لمعاني (قرف) تؤكّد بعدها عن معنى (تَقَزَّز).
جاء
في الوسيط: "(قَرَفَ): كَذَبَ وخَلَّط، وقَرَفَ لعياله: كَسَبَ من هنا، ومن هنا،
وقَرَفَ الشيء: خَلَطَه، وقَرَفَ فلاناً: عابَه، وقَرَفَ الجِلْد: قَشَرَه"
وقَرِفَ: دانى المرض" و(المُقْرِفُ): غير الحسن، والنذل الخسيس".
أما
(تَقَزَّزَ) فقد أورد لها الوسيط معانَي مختلفة عن القَرَف، جاء في الوسيط:
"تَقَزَّزَ: تباعد عن المعاصي والمعايب ... وتَقَزَّزَ من الشيء: عافه وأباه، يقال:
تَقَزَّزَ من أكل الضَّبّ ونحوه".
يتبيَّن أنَّ الصواب: تَقَزَّز من كذا لا قَرَفَ
منه..
|
مُؤَهِّل لا مُؤَهَّل
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمع بعضهم يقول: فلان يحمل مُؤَهَّلاً جامعيًّا – بفتح
الهاء مع التشديد – وهذا خطأ، والصواب: (مُؤَهِّل) – بكسر الهاء مع التشديد؛ لأنَّه
اسم فاعل يقال: أَهَّلَ يُؤَهِّل فهو مُؤَهِّل – فالشهادة التي يحصُل عليها الشخص،
أو التخصّص الذي يتقنه يُؤَهِّله للقيام بعمل معيَّن، إذاً فهو مُؤَهِّلٌ للفرد
لأمرٍ من الأمور والشخص مُؤَهَّل أي أنَّ الشخص الذي يحصل على دبلوم أو شهادة
جامعيَّة يعدُّ مُؤَهَّلاً، أمَّا الشهادة التي يحصل عليها في تخصّص مُعَيَّن فهي
(مُؤَهِّل).
يتبيَّن أنَّ الصواب أنْ يقال:
(مُؤَهِّل) للشهادة. و(مُؤَهَّل) للشخص.
سُيَّاح لا سُوَّاح
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون في جمع (سائح): سُوَّاح، بالواو وهذا غير
صحيح، والصواب: سُيَّاح بالياء، لأنَّه يقال: ساحَ يَسِيح، كما في المعاجم
اللغويَّة وهو الذي يوافق النطق العربيّ الصحيح، جاء في المصباح والمختار: "(ساحَ
في الأرض يسيح سَيْحاً وسياحة)" بمعنى ذَهَبَ وسارَ، واسم الفاعل (سائح)، والجمع
(سُيّاح، وليس في اللغة: سَاحَ يَسُوحُ – بالواو بل فيها: ساحَ يَسِيحُ – بالياء.
وللفعل (ساحَ) عدّة معانٍ كما في المعاجم اللغويَّة يقال: ساحَ الماء أي
جرى، وساحَ فلان في الأرض أي سارَ، وذهبَ للتعبّد، وساحَ: لَزِمَ المسجد، وأدام
الصوم، والمضارع: يَسِيحُ – بالياء.
و(السائح): الصائم الملازم للمسجد،
والمتنقّل في البلاد للتنزّه أو للاستطلاع والبحث والكشف ونحو ذلك. والجمع
سُيَّّاح، والمصدر: السِّياحة. و(السَّيَّاح): الكثير السياحة (صيغة مبالغة).
يتبيَّن أنَّ الصواب: سُيِّاح بالياء (جمع سائح) لا
(سُوَّاح) بالواو – كما أنَّ الصواب: سَيَّاح بالياء لا سَوَّاح
بالواو.
رِزْمَة لا رُزْمَة
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: هذه رُزْمَةُ وَرَقٍ – بضمِّ الراء – وهذا خطأ،
والصواب أن يقال: هذه رِزْمَة وَرَقٍ – بكسرها – لأنَّ الرِّزْمَة بكسر الراء: ما
جُمِعَ في شيءٍ واحد – كما في المعاجم اللغويَّة وهو الذي يوافق الاستعمال اللغويّ
الصحيح – جاء في المعجم الوسيط: "(الرِّزْمَةُ): ما جُمِعَ في شيءٍ واحد. يقال:
رِزْمَة ثياب، ورِزمَة وَرقٍ وهكذا. جمع رِزَم" انتهى كلامه.
وليس في
المعاجم (رُزْمَة) بضمِّ الراء، بل فيها (رِزْمَة) بكسرها وهي كما ذُكِرَ: ما
جُمِعَ في شيء واحد. وفيها كذلك: رَزْمَة – بفتح الراء وهي الوَجْبَة أي الأكلة
الواحدة في اليومِ والليلة، ورَزَمَة – بفتح الراء والزاي وهي الصوت.
يتبيَّن أنَّ صواب النطق: رِزْمَة – بكسر الراء لا رُزْمَة – بضمِّها
يا عشاق اللغة
العربية
يا عشاق اللغة التي قيل فيها :
لغـة إذا وقعـت على أسماعنـا * كانت لنـا بـردا علـى الأكبــاد
سـتظــل رابطــــة تؤلّــف بينــا * فهي الرّجـاء لناطق بالضّـاد
إخوتي
لا نعرف قدر ما نملك
إلا حين لا نملك قدرا منه ولا نقدّره حق قدره ، إلا بعد فقدانه
وهكذا كان مع ما
حبانا الله به من نعمة البيان وروعة التبيان وفصاحة اللسان العربي
المبين الذي
رفع الله به قدرنا في كل زمان ومكان فارتفعت بالعربيّة ، التي هي لغة
القرآن
فرفعت مكانتنا ومنزلتنا واستقرّت به أمورنا...
لغتنا.....
التي أعزنا الله بها من قدرة بيانيّة
وبلاغة فطريّة، نعبّر بها عمّا في أنفسنا .
ونتواصل بها همسا وحسّا..
فلا
ننسى ولن ننسى قدر لغتنا التي حفظها أهل الأمصار وأعجبوا بها..
فما بالنا ونحن
أهل العربيّة أصحاب اللسان المبين ..
فعلينا الحفاظ عليها..والدعوة إلى
تبسيطها..
وروائع الأدب وودائع اللغة تحمل بين طيّاتها هويّة لغتنا العربيّة..
التي تحفظ قدرنا وقيمنا وتراثنا..
تلكم هي لغتنا
ما أجملها من لغة !
فلنحافظ عليها .. ونحميها من الاندثار ، ونقيها من الانزلاق ،
ونخشى
ألا نعرف قدرها إلا بعد - لا قدّر الله - حين لا تجد لها مكانا بيننا..
أنا البحر في أحشائه الدر كامن * فهل سألوا الغواص
عن صدفاتي
بامكانكم الرجوع إلى كتب
اللغة للإستزادة مثل:
كتاب الفروق اللغويّة لأبي هلال العسكري
كتاب
روائع من الأدب العربي للدكتور هشام عبّاس
كتاب المؤتلف والمختلف للحسن بن بشر
الآمدي
كتاب المعجم المفصّل في اللغة والأدب د أميل يعقوب
كتاب تاريخ الأدب
العربي العصر الجاهلي د شوقي ضيف
كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد
كتاب
العقد الفريد لأحمد بن عبدربه الأندلسي
كتاب مجمع الأمثال للميداني
كتاب
لسان العرب لابن منظور
وغير ذلك من أمهات الكتب
..
( وإنه من داعي السرور ، أن أحقّق فكرة
.. قد تتوارد لكثير منّا وهو تيسير
الرجوع إلى مواقع أدبيّة والتزوّد من
ثقافتنا الأدبيّة والنحويّة واللغويّة والبلاغيه
فكان أن اجتهدت بحثا عن مجموعة
تخدم ميولنا وطموحاتنا....
أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا به وإياكم
إنه
سميع مجيب
......................... .........................
........................
وبإمكان عشّاق العربيّة
الرجوع إلى هذه الروابط - أيضاً -
للاستزادة:
http://www.khayma.com/wahbi/
http://www.alwaraq.com/
http://www.khayma.com/islambook/
http://www.arabvista.com/
http://www.arabicstory.net/
والرجوع إلى كتب اللغة
للإستزادة مثل:
http://lexicons.ajeeb.com/
المعاجم العربيه
http://lexicons.ajeeb.com/intro/mgz01.asp الوجيز في النحو
والصرف
http://www.angelfire.com/ak4/khalidfarraj/ الصرف العربي
http://www.angelfire.com/nt/anisfan/index.html أنيس الطلاب
العربي
http://literary.ajeeb.com/ المصطلحات الادبية
http://www.cultural.org.ae/new/poetry/html/Poetry9.htm
الموسوعه الشعريهhttp://www.cultural.org.ae/new/default.htm المجمع الثقافي
http://www.geocities.com/omarmaa/ المعلقات
http://www.geocities.com/farraj17/index.html تحليل النص الأدبي
http://www.angelfire.com/nd/prose/A.htm مفهوم النثر العربي
http://www.altokhais.com/ قصائد شعريه
http://www.almubarak.net/
قصائد العرب
http://almotanaby.ajeeb.com/ موقع المتنبي
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=motanaby/a001.xml المتنبي
2
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=mhfoaz/a001.xml نجيب
محفوظ
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Ln...r_moot/A001.xml الاديب
بدر شاكرالسيّاب.
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Ln...r_moot/A001.xml الكاتب
أمل دنقل
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Ln...r_moot/A001.xml الطيب
صالح
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=frahat/a001.xml يوسف
ادريس
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=fadwa/A001.xml فدوى طوقان
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=almareey/A001.xml أبو
العلاء المعري
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=almareey/A001.xml الشاعر
التونسي أبو القاسم الشابي
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=AhmadSwqy/A001.xml أمير
الشعراء أحمد شوقي
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=andlsyon/a001.xml شعراء
الأندلس
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=Nazek/A001.xml الشاعره
نازك الملائكه
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=tofeek/a001.xml الكاتب
المسرحي توفيق الحكيم
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Lnk=Kalelah/A001.xml كتاب
كليله ودمنه
http://www.arabicstory.net/ مواقع القصة القصيره
http://books.ajeeb.com/pages.asp?Ln...sat/a0001_0.xml القصة
النسائية القصيرة
http://proverbs.ajeeb.com/default.asp?hh=6 الامثال العربي
هذا وبالله التوفيــق .
|
|
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
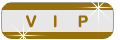


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 01:31 14/5/2010, 01:31 | |
| الضعف الإملائي
مظاهره ، أسبابه ، علاجه
إنّ مشكلة الضعف الإملائي مشكلة لطالما أقلقت المعلمين
وأولياء الأمور وطبقة
كبيرة من المثقفين، وما أسباب هذا القلق إلا لمعرفتهم بأهمية الإملاء.
إن
للإملاء منزلة كبيرة فهو من الأسس الهامة للتعبير الكتابي والضعف الإملائي
يشوه الكتابة ويعيق الفهم.
كما أن الأخطاء الإملائية تدعو إلى
احتقار الكاتب وازدرائه ولم يسلم كثير من المثقفين
وأصحاب الشهادات العليا
من الضعف الإملائي الذي أصبح يشكل لهم حرجاً كبيراً عند كتاباتهم.
ولقد علمت
مؤخراً أن بعضهم يتجنب كتابة الكلمات التي فيها همزة متوسطة أو متطرفة
ويبحث
فـي قاموسه عن كلمات رديفة تؤدي نفس المعنى ولكن دون همزات!!
إن الكتابة
الصحيحة عامل مهم فـي التعليم وعنصر أساسي من عناصر الثقافة.
ولذا كان لابد
من علاج المشكلة.
ولطالما تمنيت أن يكون الضعف الإملائي من الأمراض التي
يمكن علاجها بالأدوية والعقاقير!!
ولكن هيهات إن علاج الضعف الإملائي يتطلب
علاجاً من نوعٍ آخر يصاحبه حلم وصبر طويل.
أولاً: مظاهر الضعف الإملائي :
من تأمل كثيراً فـي مظاهر
الضعف الإملائي فإنه يراها لا تخرج عن:
أ - الهمزات
فـي وسط الكلمة:
مثل: 1- عباءة 2- فؤاد 3- مسألة 4- فجأة 5- تألمون.
يكتبها بالشكل التالي: 1- عبائة 2- فوأد
3- مساءلة 4- فجئة 5- تاءلمون.
ب - الهمزات فـي آخر الكلمة:
مثل: 1- بيداء
2- تباطؤ 3- القارئ 4- امرؤ 5- ينبئ.
يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- بيدأ
2- تباطوء 3- القاري 4- امروء 5- ينبيء
جـ - همزة الوصل
والقطع:
مثل: 1- اختبار 2- اشتراك 3- التحق 4- استخرج 5-
استقبال.
كلمات كلها بهمزات وصل يكتبها الطالب بهمزات قطع بالشكل التالي: 1-
إختبار 2- إشتراك
3- إلتحق 4- إستخراج 5- إستقبال
أو كلمات بهمزة
قطع مثل: إعراب، 2- أسماء، 3- أحمد، 4- إلمام 5- إزالة.يكتبها الطالب
بهمزات
قطع كالتالي: 1- اعراب 2- اسماء 3- احمد 4- المام 5- ازالة.
جـ - التاء المربوطة والتاء المفتوحة:
مثل الكلمات
التالية: 1- كرة 2- نافذة 3- قضاة 4- سبورة 5- صلاة.
هذه كلها كلمات تنتهي
بتاء مربوطة
يكتبها الطالب بتاء مفتوحة بالشكل التالي: 1- كرت 2- نافذت 3-
قضات 4- سبورت 5- صلات.
أو كلمات تنتهي بتاء مفتوحة مثل: 1- مؤمنات 2- بيوت
3- أموات 4- علامات5- صفات.
يكتبها الطالب بتاء مفتوحة بالشكل التالي: 1-
مؤمناة 2- بيوة 3- أمواة 4-علاماة 5- صفاة
د - اللام
الشمسية واللام القمرية:
مثل الكلمات التالية بلام شمسية: 1- الشمس 2-
النهار 3- السمع 4- التاء 5- الرعاية.
يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- اشمس
2- انهار 3- اسمع 4- اتاء 5- ارعاية.
هـ - الحروف التي
تنطق ولا تكتب:
مثل: 1- إله 2- لكن 3- أولئك 4- هذا 5- عبد
الرحمن
يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- إلاه 2- لاكن3- أولائك 4- هاذا 5-
عبدالرحمان.
و- الحروف التي تكتب ولا تنطق:
مثل الكلمات التالية: 1- عمرو (فـي حالتي الرفع والجر) 2- أكلوا 3- بذلوا 4- لن
يهملوا
5- كتبوا.
يكتبها الطالب بالشكل بالتالي: 1- عمر 2- أكلو 3-
بذلو 4- لن يهملو 5- كتبو.
ز- الألف اللينة المتطرفة:
1- علا الصقر 2- دعا الشيخ لك 3- أعيا المرض صاحبه 4- عصا الأعمى طويلة
5- بكى.
يكتبها الطالب بالشكل التالي: 1- على الصقر 2- دعى الشيخ لك 3- أعيى
المرض صاحبه
- عصى 5- بكا.
حـ- الخلط بين
الحروف المتشابهة رسماً أو صوتاً:
مثل كلمات بها حرف الظاء: 1- ظاهر 2-
نظر 3- عظم 4- ظلام 5- ظلم.
يكتبها الطالب بحرف الضاد بالشكل التالي: 1-
ضاهر 2- نضر 3- عضم 4- ضلام 5- ضلم.
أو كلمات بها حرف الضاد مثل: 1- مريض
2- عوض 3- رفض 4- محاضرة 5- بغضاء.
يكتبها الطالب بحرف الظاء بالشكل التالي:
1- مريظ 2- عوظ 3- رفظ 4- محاظرة 5- بغظاء.
وهذا
الخلط ناتج عن عدم إخراج الحرف من مخرجه بشكل صحيح.
فمخرج الضاد الصحيح هو:
إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا، ومخرج الظاء الصحيح
هو: طرف
اللسان مع أطراف الثنايا العليا.
وهناك كلمات يخطئ فيها الطالب
بسبب تشابه المخرج مثل:
1- صابر 2- استطلاع 3- غريق.
يكتبها
الطالب بالشكل التالي: 1- سابر 2- اصتطلاع 3- قريق.
ط- الإشباع (قلب
الحركات):
1- قلب الضمة واواً مثل: 1- أحبُ 2- نحنُ 3- لهُ
يكتبها
الطالب: 10- أحبو 2- نحنو 3- لهو.
2- قلب الفتحة ألفاً مثل: 1- يلعبونَ 2-
لن تندمَ 3- إن كتابَ
يكتبها الطالب: 1- يلعبونا 2- لن تندما 3- إن
كتابا
3- قلب الكسرة ياء: مثل: 1- إليهِ 2- إلى الفصلِ 3-
بالقلمِ.
يكتبها الطالب: 1- إليهي 2- إلى الفصلي 3- بالقلمي.
ثانياً أسباب الضعف الإملائي :
1- ضعف
السمع والبصر وعدم الرعاية الصحية والنفسية.
2- عدم القدرة على التمييز بين
الأصوات المتقاربة.
3- نسيان القاعدة الإملائية الضابطة.
4- الضعف
فـي القراءة وعدم التدريب الكافـي عليها.
5- تدريس الإملاء على أنه طريقة
اختبارية تقوم على اختبار التلميذ فـي كلمات صعبة بعيدة
عن القاموس الكتابي
للتلميذ.
6- عدم ربط الإملاء بفروع اللغة العربية.
7- إهمال أسس
التهجي السليم الذي يعتمد على العين والأذن واليد.
8- عدم تصويب الأخطاء
مباشرة.
9- التصحيح التقليدي لأخطاء التلاميذ وعدم مشاركة التلميذ فـي تصحيح
الأخطاء.
10- استخدام اللهجات العامية فـي الإملاء.
11- السرعة فـي
إملاء القطعة وعدم الوضوح وعدم النطق السليم للحروف والحركات.
12- قلة
التدريبات المصاحبة لكل درس.
13- طول القطعة الإملائية مما يؤدي إلى التعب
والوقوع فـي الخطأ الإملائي.
14- عدم الاهتمام بأخطاء التلاميذ الإملائية
خارج كراسات الإملاء.
15- عدم التنويع فـي طرائق التدريس مما يؤدي إلى الملل
والانصراف عن الدرس.
16- عدم إلمام بعض المعلمين بقواعد الإملاء إلماماً
كافياً ولا سيماً فـي الهمزات والألف اللينة.
17- عدم استخدام الوسائل
المتنوعة فـي تدريس الإملاء ولا سيما بالبطاقات والسبورة
الشخصية والشرائح
الشفافة.
18- عوامل نفسية كالتردد والخوف من الوقوع فـي الخطأ.
19-
كثرة أعداد الطلاب فـي الفصول.
ثالثاً
أساليب علاج الضعف الإملائي :
1- أن يحسن المعلم اختيار
القطع الإملائية بحيث تتناسب مع مستوى التلاميذ
وتخدم أهدافاً متعددة:
دينية وتربوية ولغوية.
2- كثرة التدريبات والتطبيقات المختلفة على المهارات
المطلوبة.
3- أن يقرأ المعلم النص قراءة صحيحة واضحة لا غموض
فيها.
4- تكليف الطالب استخراج المهارات من المقروء.
5- تكليف
التلاميذ بواجبات منزلية تتضمن مهارات مختلفة كأن يجمع التلميذ عشرين
كلمة
تنتهي بالتاء المربوطة وهكذا.
6- توافر قطعة فـي نهاية كل درس تشتمل على
المهارات تدريجياً ويدرب من خلالها التلميذ
فـي المدرسة والبيت.
7-
الإكثار من الأمثلة المتشابهة للمهارة التي يتناولها المعلم فـي الحصة.
8-
الاهتمام باستخدام السبورة فـي تفسير معاني الكلمات الجديدة وربط
الإملاء
بالمواد الدراسية الأخرى.
9- تدريب الأذن على حسن الإصغاء
لمخارج الحروف.
10- تدريب اللسان على النطق الصحيح.
11- تدريب اليد
المستمر على الكتابة.
12- تدريب العين على الرؤية الصحيحة
للكلمة.
13- جمع الكلمات الصعبة التي يشكو منها كثير من التلاميذ وكتابتها
ثم تعليقها على لوحات
فـي طرقات وساحات المدرسة.
14- تخصيص دفاتر
لضعاف التلاميذ تكون فـي معيتهم كل حصة.
15- معالجة ظاهرة ضعف القراءة عند
التلاميذ وترغيب القراءة للطلاب بمختلف الوسائل.
16- عدم التهاون فـي عملية
الصحيح.
17- أن يعتني المعلم بتدريب تلاميذه على أصوات الحروف ولا سيما
الحروف المتقاربة
فـي مخارجها الصوتية وفـي رسمها.
18- أن يستخدم
المعلم فـي تصحيح الأخطاء الإملائية، الأساليب المناسبة وخير ما يحقق
الغاية
مساعدة التلميذ على كشف خطئه وتعرف الصواب بجهده هو.
19-
محاسبة التلاميذ على أخطائهم الإملائية فـي المواد الأخرى.
20- ألا يحرص
المعلم على إملاء قطعة إملائية على تلاميذه فـي كل حصة
بل يجب عليه أن يخصص
بعض الحصص للشرح والتوضيع والاكتفاء بكتابة كلمات مفردة
حتى تثبت القاعدة
الإملائية فـي أذهان التلاميذ.
21- أن يطلب المعلم من تلاميذه أن يستذكروا
عدة أسطر ثم يختبرهم فـي إملائها فـي اليوم التالي
مع الاهتمام بالمعنى
والفهم معا.
22- تنويع طرق تدريس الإملاء لطرد الملل والسآمة ومراعاة الفروق
الفردية.
23- الاهتمام بالوسائل المتنوعة فـي تدريس الإملاء ولا سيما
السبورة الشخصية والبطاقات
والشرائح الشفافة.
24- تشجيع وتحفيز
الطلاب الذين تحسنوا بمختلف أساليب التحفيز والتشجيع.
25- حصر القواعد
الإملائية الشاذة والتدريب الكافـي عليها.
|
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
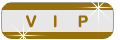


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 01:42 14/5/2010, 01:42 | |
| بَدْء لا بِدْء
أ. د. عبد
الله الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: بِدْء
العمل في الساعة السابعة صباحاً – بكسر الباء وهذا غير صحيح، والصواب: بَدْء
– بفتح الباء؛ لأنه ليس في اللغة (بِدْء) بكسر الباء، ومثل ذلك قولهم: الشعوب
البدِائَّية – بكسر الباء، والصواب: البُدائَّية بضمِّ الباء، أو
البَدائَّية – بفتحها.
جاء في الوسيط: "(البَدْء): (بفتح الباء)
أوَل كلّ شيء. يقال: فعلتُه بَدْءًا، وبَدْءَ بَدْءٍ وأَوَّلَ بَدْءٍ...
و(البُدائيّ) (بضمّ الباء) المنسوب إلى البُداءَة وما كان في الطّور الأول من أطوار
النشوء" انتهى ومثل ذلك (البُدائيَّة) وكلتاهما بضمّ الباء – وهذان اللفظان أقرّهما
مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة.
يتبيَّن أنَّ الصواب: (بَدْء) – بفتح الباء لا (بِدْء) بكسرها
والشعوب البُدَائيَّة – بضمِّ الباء لا (البِدائيَّة)
بكسرها.فِلْذَات الأكباد لا فَلَذَات الأكباد
أ.
د. عبد الله الدايل
كثيراً ما نسمعهم يقولون: فَلَذَات الأكباد – بفتح الفاء
واللام – (وهم الأولاد) وهذا النطق غير صحيح، والصواب: فِلْذَات – بكسر الفاء،
وسكون اللام، لأنَّ المفرد (فِلْذَة) بكسر الفاء وسكون اللام وهي القطعة من الشيء،
وتجمع أيضا على (أفلاذ) و(فِلَذ) – غير أنَّ الجمع القياسي (فِلْذَات)، لأنَّ
المفرد (فِلْذَة) آخره (تاء).
جاء في الوسيط:
"(الفِلْذَة): القطعة من الكبد واللحم والذهب والفِضَّة، والجمع فِلَذ، وأَفْلاذ.
وأفلاذ الأكباد: الأولاد، وأفلاذ الأرض: كنوزها".
يتبيَّن أن الصواب: فِلْذَات – بكسر الفاء لا (فَلَذات) بفتح الفاء
واللامأجمـــــل ما قيل في قيمة الكلمة
نتحدث كثيرا ولا
نسكت إلا قليلا فهل عرفنا قيمة الكلمة ؟؟
هذه أجمل معانٍ قيلت في قيمة
الكلمة :
ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم :
قال تعالى:"ما يلفظ من
قول إلا لديه رقيب عتيد"
وقال صلى الله عليه وسلم :"من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"
وقال صلى الله عليه وسلم :"الكلمة
الطيبة صدقة"
وقال علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه : "إذا تم العقل نقص
الكلام"
وقال ايضاً : "بكثرة الصمت تكون الهيبة"
وقال عمرو
بن العاص :"الكلام كالدواء إن اقللت منه نفع.وإن اكثرت منه قتل".
وقال
لقمان لولده:" يا بني اذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر انت بحسن
صمتك"
ويقول اللسان للجوارح كل صباح ومساء كيف أنتن؟ يقلن بخير اذا
تركتنا
وقال وهب ابن الورد : "بلغنا ان الحكمة عشر اجزاء تسع منها
بالصمت والعاشر في عزلة الناس"
وقال علي ابن هشام : "إذا لم يكن صمت
الفتى عن ندامة ووعي ٍفإن الصمتَ أولى وأسلمُ
وقال الإمام الشافعي رحمة
الله:"إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه فإن ظهرت
المصلحة
تكلم, وإن شك لم يتكلم لم يتكلم حتى تظهر."
وقال ايضا لصاحبه ربيع : يا
ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها.
وقيل
ايضا مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك ولحقك شره.
وقيل ايضا
الكلمة أسيرة في وثاق الرجل فإذا تكلم بها صار في وثاقها .
وقيل في
الأمثال : " رب كلمة قالت لصاحبها دعني" .
كما قيل : " خير الكلام ما قل
ودل "
وقيل : " إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب
مخارج
حروف اللغـــة العربيـــة
مخارج جمع مخرج
ومخرج لغة : هو محل الخروج
واصطلاحا: هو محل خروج الحرف عند النطق به وتميزة عن غيره
وفائدة المخارج تعتبر مثل موازين تعرف بها مقادير فتتميز عن غيرها
.
كيفية معرفة مخرج الحرف :-
لمعرفة مخرج اي حرف من حروف اللغة العربية ان ينطق به
ساكنا او مشددا او ادخال همزة الوصل عليه ، والنطق به والاصغاء اليه فحيثما انقطع
الصوت بالحرف فهو مخرجه .
وتنقسم مخارج الحروف إلى خمسة مخارج وفي تنحصر في خمسة أعضاء
عامة:-
1-
الجوف
2- الحلق
3 -اللسان
4- الشفتان
5- الخيشوم
السؤال : كيف تستطيع
معرفة مخرج أي حرف؟
الجواب: بتسكين
الحرف أو تشديده ، ثم أدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة ، وأصغ إليه ، فحيث
انقطع الصوت فهو مخرجه.
السؤال : عرف الجوف
، واذكر حروفه ، وبم تُسمى؟
الجواب
الجوف : هو الخلاء الداخل في الحلق والفم .وحروفه التي تخرج
منه هي : " الواو الساكنة المضموم ما قبلها ، والياء الساكنة المكسور ما قبلها ،
والألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا . ، وتسمى هذه الحروف
"بالحروف المدية" أو "الحروف الجوفية".
السؤال : ما الحروف التي تخرج من مخرج الحلق ، وبم
تسمى؟
الجواب:الحروف هي
:" الهمزة والهاء " وتخرج من أقصى الحلق مما يلي الصدر؛ و " العين والحاء " وتخرج
من وسط الحلق ؛ و " الغين والخاء " وتخرج من أدنى الحلق مما يلي الفم. وتسمى هذه
الحروف الستة "بالحروف الحلقية".
السؤال :
ما الحروف التي تخرج من مخرج اللسان؟ وما أسماؤها؟
الجواب
: الحروف هي : " القاف والكاف " وتخرج من أقصى اللسان مع ما
يحاذيه من الحنك الأعلى ، ولكن الكاف تحت مخرج القاف .ويقال لهما : " لهويان "
لخروجهما من قرب اللهاة.
و " الجيم والشين والياء غير المدية " وتخرج من وسط
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ، وتُسمى " بالحروف الشجْرية " لخروجها من
شجْر اللسان أي منفتحة .
" الضاد " وتخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من
الأضراس العليا ، وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا . وهي أصعب الحروف
مخرجا. وتسمى " بالمستطيلة ".
و " اللام " وتخرج من بين حافتي اللسان معا بعد
مخرج الضاد ، مع ما يحاذيها من اللثة أي لحمة الأسنان العليا .
و " النون
المظهرة " وتخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام
قليلا .
و " الراء " وتخرج من طرف اللسان مع ظهره مع الحنك الأعلى . وهذه
الحروف الثلاثة تسمى " ذلقية " أو " الذوْلقية" لخروجها من ذلق اللسان أي
طرفه.
و " الطاء والدال والتاء " وتخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا،
وتسمى هذه الحروف " نطعية" لخروجها من نطع الفم أي جلدة غارة.
و " الظاء والذال
والثاء " وتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا .وتسمى بالحروف " اللثوية "
لخروجها من قرب اللثة.
و " والصاد والسين و الزاي " وتخرج من طرف اللسان مع ما
فوق الثنايا السفلى ، وتسمى هذه الحروف " أسلية " لخروجها من أسلة اللسان أي مستدقه
.
السؤال : ما الحروف التي تخرج من مخرج
الشفتين ، وماذا تسمى ؟
الجواب :
" الفاء " وتخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا
العليا .
و " الباء والواو والميم " وتخرج من الشفتين معا ، الباء والميم
والشفتان منطبقتان ، والواو الشفتان منفتحتان . وتسمى هذه الحروف " شفوية " أو "
شفهية " لخروجها من الشفة.
السؤال : عرف
الخيشوم ؟وما الحروف التي تخرج منه؟
الجواب
:الخيشوم : هو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم،
ويخرج منه النون المدغمة والمخفاة.
|
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
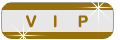


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 01:53 14/5/2010, 01:53 | |
| صفات
حروف اللغة العربيــة
السؤال : عرف الصفة لغة واصطلاحا.
الجواب : لغة : ما
قام بالشيء من المعاني كالعلم والبياض ، واصطلاحا : كيفية عارضة للحرف عند حصوله في
المخرج من جهر ، ورخاوة ، وما أشبه ذلك.
السؤال : اذكر الخلاف في عدد صفات الحروف.
الجواب
اختلف العلماء في عدد صفات الحروف، فمنهم من عدها سبع عشرة
صفة، وهو الإمام ابن الجزري.
ومنهم من زاد على ذلك فقد أوصلها بعضهم إلى أربع
وأربعين صفة، وهو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 ه.
ومنهم من
نقص عن السبع عشرة كالبر كوي فإنه عدها أربع عشرة صفة بحذف الإذلاق ، وضده،
والانحراف، واللين، وزيادة صفة الغنة ؛ ومنهم من عدها ست عشرة صفة بحذف صفة الإذلاق
وضده أيضا ، وزيادة صفة الهوائي.
السؤال : ما أقسام صفات الحروف ؟ اذكرها.
الجواب
الصفات تنقسم إلى قسمين: قسم له ضد، وقسم لا ضد له.
فالذي له ضد: الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها التوسط والرخاوة، ،والاستعلاء
وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإصمات، فهذه خمس صفات ضد
خمس بجعل ما بين الرخاوة والشدة مع أحدهما.
وأما الذي لا ضد له: فالصفير،
والقلقلة، واللين، والانحراف، والتكرير، والتفشي، والاستطالة، فهذه سبع
صفات.
السؤال : عرف الصفات التي لها
ضد .
الجواب :
الهمس: لغة: الخفاء.
واصطلاحا:
جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج ، وحروفه عشرة يجمعها:
"فحثه شخص سكت". وأقوى هذه الحروف الصاد والخاء ، وأضعفها الهاء.
والجهر:
وهو لغة: الإعلان.
واصطلاحا: انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه، وحروفه
ما عدا أحرف الهمس السابقة، وهي تسعة عشر حرفاً .والطاء أقوى هذه الحروف لما فيها
من استعلاء وشدة.
والشدة:
ومعناها لغة: القوة
واصطلاحا: انحباس جري الصوت عند
النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه، وحروفها ثمانية مجموعة في قولك: "أجد
قط بكت". والطاء أقواها لما فيها من انطباق واستعلاء وجهر.
والتوسط:
وهو لغة: الاعتدال.
واصطلاحا: اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدة، وعدم
كمال جريانه كما في الرخاوة، وحروف التوسط خمسة مجموعة في قولك: "لن عمر".
والرخاوة:
وهي
لغة: اللين.
واصطلاحا: جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج.،
وحروفها ستة عشر وهي ما عدا حروف الشدة و حروف التوسط .
والاستعلاء:
وهو لغة: الارتفاع.
واصطلاحا: ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه سبعة
مجموعة في قولك: "خص ضغط قظ"،[ ثم إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان
سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا ولذا لم تعد أحرف وسط اللسان وهي الجيم والشين
والياء غير المدية من أحرف الاستعلاء لأن وسط اللسان هو الذي يعلو عند النطق بها
فقط. ولم تعد الكاف كذلك لأنه لا يستعلى بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه
والاستفال:
ومعناه
لغة: الانخفاض.
واصطلاحا: انخفاض اللسان أي: انحطاطه عن الحنك الأعلى إلى قاع
الفم عند النطق بالحرف، وحروفه اثنان وعشرون وهي الباقي بعد حروف الاستعلاء.
والإطباق:وهو لغة:
الإلصاق.
واصطلاحا: تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند
النطق بالحرف وأحرفه أربعة، وهي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، وأقواها الطاء ،
وأضعفها الظاء [ثم اعلم أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء، وأخص منه، إذ لا يلزم من
الاستعلاء الإطباق، ويلزم من الإطباق الاستعلاء، فكل حرف مطبق مستعلٍ، ولا عكس
والانفتاح:
وهو لغة: الافتراق.
واصطلاحا: تجافي كل من طائفتي
اللسان، والحنك الأعلى عند النطق بالحرف حتى يخرج الريح من بينهما، وحروفه ما عدا
أحرف الإطباق وهي خمسة وعشرون حرفا.
والإذلاق:
أو الذلاقة لغة: حدة اللسان أي:
طلاقته.
واصطلاحا: سرعة النطق بالحروف [المذلقة] لخروج بعضها من ذلق اللسان أي:
طرفه، وهو اللام، والنون، والراء، وبعضها من ذلق الشفة، وهو الباء الموحدة، والفاء،
والميم.
فحروف الإذلاق ستة يجمعها قولك: "فر من لب".
والإصمات:
وهو لغة:
المنع.
اصطلاحا : صعوبة النطق بالحرف لعدم خروجه من ذلق اللسان أو ذلق الشفة.
أوع حروفه من الانفراد بتكوين الكلمات المجردة الرباعية أو
الخماسية.
فكل كلمة رباعية أو خماسية وليس فيها حرف من حروف الزيادة لا بد
أن يكون فيها حرف أو أكثر من الحروف المذلقة لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت، فحروف
الإصمات ممنوعة من أن تختص في لغة العرب ببناء كلمة مجردة رباعية أو خماسية.
فإذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية، وكل حروفها أصلية، وليس فيها حرف من حروف
الذلاقة فهي غير عربية، كلفظ: عسجد، اسم للذهب أعجمي، وعَسَطُوس -بفتح العين
والسين- اسم لشجر الخيزران، وحروف الإصمات ما عدا أحرف الإذلاق
المتقدمة
مَأزِق لا مَأزَق
أ. د. عبد الله
الدايل
كثيرا ما نسمع بعضهم يقول: هو في مَأزَق ـ بفتح الزاي ـ وهذا خطأ،
والصواب: هو في مأزِق ـ بكسر الزاي ـ أي في موقف حَرِج، يقال: أزَقَ يأزِق ـ بكسر
الزاي في المضارع، لذا فاسم المكان (مَأزِق) على وزن (مَفعِل) وهذا هو القياس، نصت
على ذلك المعاجم اللغوية كالمعجم الوسيط، وغيره.
ففي
المعجم الوسيط: "أزَقَ: أزْقاً: ضاق. والشيء: ضَيَّقَه ... المَأزِقُ: المَضِيق
الحَرَج جمع مآزق".
ومعنى ذلك أن (أزَقَ) من باب (ضَرَبَ) فكما تقول:
ضَرَبَ يَضْرِبُ مَضْرِب تقول: أزَقَ يَأزِقُ مَأزِق.
يتبين أن صواب النطق (مَأزِق) بكسر الزاي لا (مَأزَق)
بفتحها.
من صحيح
اللسان
بدل مفقود لا بدل
فاقد
كثيراً ما نسمعهم يقولون: أريد بدل فاقد, وهذا غير
صحيح, والصواب أنْ يقال: أريد بدل مفقود: لأنَّ (الفاقد) في الأصل: الشخص نفسه الذي
يفقد الأشياء بخلاف (المفقود) فهو الشيء الذي تبحث عنه, أو الشيء الذي ضاع منك.
فشتان بينهما.
جاء في المصباح:"(فقدته فقداً) وفُقداناً: عدمته،
فهو مفقود، وفقيد".
وفي الوسيط: "(فقد) الشيء فقداً، وفُقداناً: ضاع منه
... وفقدت المرأة زوجها – فهي (فاقد)، والمفعول (مفقود)، و(فقيد)".
يتبين أنَّ الصواب في أصل الاستعمال اللغوي أنْ يقال: أريد بدل
مفقود لا بدل فاقد.
طريقة
جميلة للتفريق بين الضاد والظاء
من المعيب أن تجد نصاً
بليغا قد نُسقت كلماته واختيرت ألفاظه وانتقيت معانيه ثم تجد صاحبَه قد نقله في
صورة مشوهة بأخطاء الكتابة والإملاء …
أعود وأقول : وجدت في أحد المواقع
كتابا قد حملته قديما لأحد العلماء وهو ابن الحداد المهدوي ،
وقد أعجبت
بفكرة صاحبه ، وحسن جمعه .
وفكرة
الكتاب:
أن صاحبه قد أثبت أن :
في اللغة العربية
ثلاثا وتسعين كلمة تكتب بحرف (الظاء) وما سواها فيكتب بحرف (الضاد) … وقد وجدت أن
منها الغريب غير المستعمل ، فنقيتها وصفيتها ، واخترت أشهرها وما هو متداول اليوم
فوجدتها اثنتين وثلاثين كلمة (32كلمة)… اعرفها بـ(الظاء)(ظ) وما عداها
فبـ(الضاد)(ض) … وتسلم بعدها من الخطأ والزلل في هذا الباب إن شاء الله !!
1- الحَظّ: بمعنى النصيب .
2-الحِفْظُ: وهو ضد النسيان .
3-الحَظْرُ: وهو المنع .
4-
الحَظْوَةُ: وهي الرفعة .
5- الظلم .
6- الظليم: وهو ذكر النعام .
7-الظبي : وهو الغزال .
8- الظبة: وهي طرف السيف .
9-
الظعن: وهو السفر بالنساء .
10-الظرف.
11-الظريف .
12-
الظَّنُّ .
13- الظِّلُّ .
14-الظفر : وهو ضد الخيبة .
15-
الظهر..
16- الظماء .
17-الكظم : وهو كتم الحزن .
18-اللحظ
: وهو النظر.
19-اللفظ .
20- النّظْمُ .
21-النظافة .
22- النظَر.
23- العظم.
24- العظيم.
25- العَظَل :
وهو الشدة ، من قولهم : أمر معظل .
26- الغيظ : أعني الحنق .
27-
الفظاظة : وهي القسوة .
28 -الفظاعة : من الأمر الفظيع ، وهو الشنيع .
29 - التقريظ : مدح الحي بالشعر ..
30- المواظبة.
31 -
الوظيفة.
32- اليقظة : ضد النوم .
ملحوظة : (الكلمات المذكورة هي جذور ، أي لما تفرع منها من تصاريف ما
لها من الحكم )
ختاما : خذ هذه
القاعدة التي استفدتها من الكتاب : أي كلمة تبدأ بأحد هذه الأحرف :
أ-ت-ث-ذ-ز-ط-ص-ض-س لا يوجد فيها حرف (ظاء) بتاتا !!
هذا والله
أعلى وأعلم
|
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
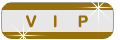


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن موضوع: رد: إلى محبي لغة القرآن  14/5/2010, 02:08 14/5/2010, 02:08 | |
| لنتجنب هذا الخطأ الشائع ......
البعض
يستخدمون (نفذ) بمعنى الفناء
كقولهم ( نفذ الماء )
الفرق بين نَفِدَ و
ونَفَذَ
أن الأولى ( نفِد) بالدال وبكسر الفاء بمعنى : فنى وذهب ، ومصدره:
نفداً ونفادًا ..
قال تعالى : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
)
والثانية
(نفذ) بالذال وفتح الفاء بمعنى : مضى ووصل، و مصدره: نفوذا ونفاذا ..
قال تعالى : ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار
السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان)..
صُفْرَة البيض لا صَفار البيض
صحيح اللسان:
كثيرا ما نسمعهم
يقولون: صَفار البيض، وهذا غير صحيح، والصواب أن يقال: صُفرة البيض، أو أن يقال:
(صَفْراء) البيض أو (مُحُّ) البيض، هذا هو الاستعمال الصحيح، فليس في اللغة صَفَار،
بفتح الصاد، بل فيها: أصْفَر وصَفْراء، وصُفْرَة، واصْفَرَّ واصْفِرار ـ هكذا تُقاس
الألوان ـ أي أن الألوان تأتي على أوزان مُعَيَّنة كأفْعَل فَعْلاء، وفُعْلَة..
إلخ. وهي من أوزان الصفة المُشَبَّهة.
جاء في
المختار: "(الصُّفُرَة) لون الأصْفَر، وقد (اصْفَرَّ) الشيء و(اصْفَارَّ)...
أما (صِفار) بكسر الصاد فهو ما بقي في أسنان الدابة من
التبن والعلف كما في الوسيط، و(الصُّفار) بضم الصاد: الصَّفير، ودود البطن، والمرض
المعروف بالصُّفَار.
يتبين أن
الصواب:
صُفْرَة البيض لا صَفار البيض
صحيح اللسان
أرسل إليه رسالةً
لا
أرْسَلَ إليه
برسالة
كثيراً ما نسمعهم يقولون: أرسلَ إليه برسالة –
باستعمال حرف الجرّ (الباء) بعد الفعل، وهذا غير صحيح، والصواب أن يقال: أرسلَ إليه
رسالة – بإسقاط حرف الجرّ، لأن الفعل (أرسَلَ) يتعدّى بنفسه، فهكذا نطقت العرب. جاء
في المصباح: "أرسلت رسولا" بعثته برسالة يؤدّيها... وأرسلتُ الطائر من يدي: إذا
أطلقته... وأرسلت الكلام إرسالا: أطلقته من غير تقييد".
وقد ورد الفعل
(أرْسَلَ) في القرآن الكريم متعديا بنفسه، قال تعالى: "ألَمْ تَرَ أنَّا أرْسَلْنَا
الشَّيَاطِينَ على الكافرين تَؤُزُّهُمْ أزًّا" سورة (مريم)، آية (83).
يتبيّن أن الصواب أن يقال: أرسَلَ إليه رسالة لا
(أرْسَلَ إليه برسالةٍ).
صحيح
اللسان
اللُجَيْنُ
حديثنا هنا ليس عن (اللُجَيْنُ): الشركة الصناعية التي
يعرفها أهل الأسهم وغيرهم – كما قد يُفْهَمُ من العنوان. بل هو متعلق بمعنى كلمة
(اللُجَيْنُ)، فقد سُئِلْتُ عن معناها كثيرا، فذكرت أنها كلمة عربية فصيحة معناها:
الفِضّة – كما في المعاجم اللغوية كالوسيط، والمختار، وغيرهما، وأن هذه الكلمة جاءت
على أحد أوزان التصغير وهو (فُعَيْل).
يقال: لُجَيْن، واللُجَيْن بمنزلة
كُمَيْت والكُمَيْت، جاء في مختار الصحاح: "(اللُجَيْنُ) بالضم: الفِضّة – جاء
مُصَغّرا مثل الثُّرَيَّا والكُميْت".
و(كُمِيت) اسم
جبل في "مرات"، جاء على وزن (فُعَيْل) – أحد أوزان
التصغير.
بمناسبة اللجين
أذكر
قصيدة رائعة للأخطل الصغير يقول فيها
:
يا عاقد
الحاجبين
يـاعاقد
الـحاجبين على الجبين اللجين
إن كنت تقصد قتلي.. قـتلتني مـرتين
مـاذا
يـريبك مني ومـاهممت بـشين
أصُـفرةٌ في جبيني أم رعشة في اليدين
تَـمر قـفز
غزالٍ بين الرصيف وبيني
وما نصبت شباكي ولا أذنت لـعيني
تـبدو كأن لاتراني
ومـلء عينك عيني
ومـثل فعلك فعلي ويلي من الأحمقين
مولاي لم تبق مني حـياً
سوى رمقين
صبرت حتى براني وجدي وقرب حيني
ستحرم الشعر مني وهـذا لـيس بهين
أخاف تدعو القوافي عليك في المشرقين
|
|
  | |
الوتر الحزين
شخصيات هامة
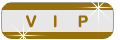


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32783
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 | |
  | |
|