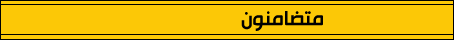ويلاحظ أن الشاعر كلما توغل في موضوع قصيدته، وازدادت حماسته لما يعاني أو يصف منه، عليه ازداد توغله في طريق الصناعة الفنية، لكن من خلال ما اعتمده منذ بداية القصيدة من مبنى التضاد، ويصل في هذا الجزء من القصيدة من خلال التضاد إلى ما يمكن عده ضرباً من التناقض أو التعارض الظاهري (paradox)(20) فهذا الفتح الذي يبدو أعلى من أن يحيط به طرفا الأدب- الشعر والنثر، وبينهما تضاد- ربما كان أولى بالفهم الاتجاه إلى القول باستحقاقه أن يخلد في الشعر والنثر. ذلك الفتح الذي تحتفل به كل من السماء والأرض- وهما طرفا ثنائية أيضاً- بطريقتها الخاصة، فتتفتح السماء بالعطاء، وتتشقق الأرض بالعطاء الناتج عن عطاء السماء، وتأخذ زينتها، ومن هذا التعانق الذي يحدثه الشاعر بين السماء والأرض تنثال المعاني الروحية المصاحبة لهذا الفتح التي تشعها كلمة الفتح ابتداء.
ويتبدى التناقض من خلال وصفه يوم وقعة عمّورية بأن يصور المنى فيه (حفلاً معسولة الحلب) ثم يسلب ذلك كله بقوله: انصرفت. وعندما يجعل عمّورية أماً لهم يفدّونها بكل أم وأب (وهما طرفا ثنائية أيضاً) ثم ينفي كل ذلك عنهم بقوله: لو رجوا أن تفتدي.
وعندما يجعل عمّورية وهي فراجة الكرب عندهم مدخلاً للكربة السوداء إليهم، وعندما يأتيها- من الفأل البارح- الذي يتمسكون به لولعهم بالتكهن والتنجيم لجاهليتهم- الخراب والوحشة. وأوضح من ذلك أن يصف جنود الروم في عمّورية بأنهم كلهم (فارس بطل) ثم يسلب هذا الوصف كل جدوى أو فاعلية، عندما يخبر عنهم بأنهم كلهم- في هذه المعركة- (قاني الذوائب من آني دم سرب)، مختضب بدمه من سنة السيف، لا من سنة الإسلام في خضاب الشيب بالحنّاء. أي أن الشاعر مازال متمسكاً ببنية التضاد لكنه يعقدها شيئاً فشيئاً مع تصاعد الموقف وتعقد جو المعركة في هذه القصيدة. فكان اكتشافه التناقض الظاهري (paradox) وسيلة فنية اعتمد عليها في تشكيل تجربته أو صناعة قصيدته في هذا المقطع من قصيدته على وجه الخصوص، وإن سقطت منه أشياء في سائر القصيدة مثال قوله:
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها …… تنال إلا على جسر من التعب
وغيره من أبيات القصيدة، الأمر الذي يرجع إلى ولع أبي تمام ببنية التضاد.
ومن أثناء هذا المقطع تطلُ صورة عمّورية أماً بكراً! تمنعت على الفرس كما صدت عن العرب- وهذه ثنائيات متضادة أيضاً- برزة (أي حيية ومتبرجة) شابت لها الليالي، وهي لم تشب. يالها من أنثى عجيبة! تدخر عفافها للمعتصم! يستعين الشاعر على تصويرها فضلاً على الكلمات المتضادة، بالكلمات الأضداد مثل: الفأل- برحا- برزة..، حيث تدلُّ كل كلمة بنفسها على معنيين متضادين في وقت واحد. لعل تصوير عمّورية في صورة الأنثى الخالدة التي تجمع طرفي الحياة أو النقيضين، ضرباً من التناسب في الصنعة الفنية- يتفق مع ما يذكره الشاعر في المقطع التالي من تضحية المعتصم بنسائه وعاجل لذته بمثل قوله:
لبيتَ صوتاً زبطرياً هرقتَ له ….. كأسَ الكرى ورضابَ الخُردِ العُرُبِ
عداك حَرُّ الثغورِ المُستضامةِ عن …. بردِ الثغورِ وعن سلسالِها الحصبِ
فقد اختار المعتصم الثغور/ الحرب، على الثغور/ النساء، فاختار الحرب والمشقة على البرد واللذة. وكانت تضحيته هذه من أجل الأنثى الخالدة عمّورية.
وإذا كان هذا التشخيص للمدينة في صورة الأنثى له ما يبرره من توظيف فني فإن له أيضاً ما يدعمه في الذهنية العربية، فالمدن- لدينا نحن العرب- نساء، بل ونساء أبكار أيضاً- عرائس (فحائل عروس الشمال، وجدة عروس البحر الأحمر- والإسكندرية عروس البحر الأبيض- والمنيا عروس الصعيد- وهكذا تتعدد العرائس؛ فالعقلية العربية تستسيغ فكرة تعدد الزوجات!) ولعل ذلك الربط بين المدينة والأنوثة- خاصة في هذا النص الذي يدور حول عمّورية المدينة المفتوحة للمعتصم- يرجع إلى ارتباط البطولة لدينا نحن العرب- كوراثة ثقافية تاريخية إن جاز التعبير عن العصور العربية الأولى- بالرحلة والسفر، تماما كما ترتبط لدينا أيضاً- كوراثة عن تلك العصور- بالفحولة، ومن تلك الاستعمالات الواضحة الدلالة، ما كانت تطلقه العرب على الشاعر المتميز- أي البطل في مجال الشعر- من وصف (الشاعر الفحل). كذلك كانت تضحية المعتصم السابقة من أجل إحراز نساء الروم. فقد حاول أبو تمام تصوير عظمة انتصار المسلمين بكثرة ما حازوه من سبى رومي. يقول الشاعر:
والحربُ قائمةٌ في مأزقٍ لجج ….. تجثو القيامُ به صغراً على الركبِ
كم نِيلَ تحت سناها من سنا قمرِ ….. وتحت عارضها من عارضٍ شنبِ
كم كان في قطع أسبابِ الرقابِ بها ….. إلى المخدّرة العذراءِ من سببِ
كم أحرزتْ قضبُ الهندي مُصلتة ….. تهتزُ من قُضبٍ تهتزُ في كثبِ
بيضٌ إذا انتضيت من حجبِها رجعتْ ….. أحقَّ بالبيضِ أتراباً من الحُجُبِ
خليفةَ اللهِ جازي اللهُ سعيَك عن ….. جرثومِة الدينِ والإسلامِ والحسبِ
وعلى الرغم من أن الشاعر ابتدأ هذه الصورة التي استطرد إليها عن السبي الذي حازه المسلمون معتمداً على التضاد في البيت الأول منها بقوله (تجثو القيام به...) إلا أنه أضاف إليه ضروباً من التكرار اللفظي عن طريق الجناس (قضب وقضب- بيض وبيض) ورد الإعجاز على الصدور (أسباب وسبب- بيض وبيض- من حجبها والحجب).
ومن خلال هذا الجو الديني الذي تتنفس فيه القصيدة، والذي سنوضحه مفصلاً فيما بعد إن شاء الله، والذي يشير إليه البيت الأخير من هذا المقطع، يمكن عد صورة النساء السبايا تلميحاً لم يجرؤ الشاعر على التصريح به عما كان ينتظر المعتصم وجنوده من أجر لمن يستشهد منهم في هذه الموقعة، أو هي إشارة إلى أجر المجاهدين عجلت لهم منه في الدنيا البشرى بما ينتظرهم من جزيل الأجر في الآخرة، وفي هذا السياق تشع كلمة أتراباً- إذا قُرئت على أنها تمييز- لكلمة البيض في البيت قبل الأخير- دلالات دينية لورودها في سياق الحديث عن الحور العين، وذلك في قوله تعالى (إنا أنشأناهن إنشاء* فجعلناهن أبكاراً* عرباً أترابا* لأصحاب اليمين) سورة الواقعة: الآيات 35- 38.
مما يرشح لهذا الاحتمال الذي قدمناه لتفسير هذه الصورة في القصيدة، خاصة وأن الشاعر قد قدم المصاحب اللفظي المعهود لهذه الكلمة (أتراباً) في البيت السابق:
لبيت صوتأ زبطرياً هرقتَ لهُ ….. كأسَ الكرى ورضابَ الخُردِ العُرُبِ
ثم تكون نقلة فنية من الشاعر نحو تعقيد الصورة من خلال بنية التضاد تتساوق مع توغله في القصيدة، في المقطع التالي: يقول الشاعر:
لقد تركتَ أميرُ المؤمنينَ بها ….. للنارِ يوماً ذليلَ الصخرِ والخشبِ
غادرتَ فيها بهيمَ الليلِ وهو ضحىً ….. يشلهُ وسطَها صبحٌ من اللهبِ
حتى كأنَّ جلابيبَ الدجى رغبتْ ….. عن لونها وكأنّ الشمسَ لم تغبِ
ضوءٌ من النارِ والظلماءُ عاكفةٌ ….. وظلمةٌ من دُخَانٍ في ضُحَىً شحبِ
فالشمسُ طالعة من ذا وقد أفلتْ ….. والشمسُ واجبة من ذا ولم تجبِ
تصرّح الدهرُ تصريحَ الغمامِ لها ….. عن يوم هيجاءَ منها طاهرٍ جنبِ
لم تطلعِ الشمسُ فيه يومَ ذاك على ….. بانٍ بأهلٍ ولم تغربْ على عزبِ
ما ربعُ ميةَ معموراً يطيفُ به ….. غيلانُ أبهى ربيً من ربعها الخربِ
ولا الخدودُ وقد أدمينَ من خجلٍ ….. أشهى إلى ناظري من خِّدها التربِ
سماجةٌ غنيت منا العيونُ بها ….. عن كلِ حسنٍ بدا أو منظرٍ عجبِ
وحسنُ منقلبٍ تبقى عواقبه ….. جاءتْ بشاشتهُ من سُوءِ منقلبِ
ويلاحظ أن التقنية الجديدة التي يستعملها أبو تمام من التضاد في هذا المقطع هي ما أسماه الشاعر (بنوافر الأضداد) الذي يشتمل فيه البيت على وصفين متضادين، الأمر الذي لاحظه وأشار إليه- من قبل- أستاذنا الدكتور شوقي ضيف، وذكر له عدداً من الأمثلة منها قول أبي تمام:
بيضاء تسري في الظلام فيكتسي ….. نوراً وتسربُ في الضياءِ فيظلمُ
الذي يعلق عليه بقوله: "أرأيت إلى هذا التضاد وهذا الضياء المظلم؟ إن حقائق الأشياء تتغير في شعر أبي تمام على هذه الصورة التي نرى فيها الضياء المظلم..."
ومنها قول أبي تمام في وصف الشراب:
جهميةُ الأوصافِ إلا أنهم ….. قد لَقبوها جوهرَ الأشياءِ
الذي يعلق عليه الدكتور شوقي ضيف بقوله: (فهي جهمية أي ليس لها اسم، لأن الأسماء في رأي جهم بن صفوان تطلق على الجواهر والأعراض.. "فقد رقت- كما ذكر التبريزي- حتى كادت تخرج من أن تكون عرضاً أو جوهراً أو أن تسمى شيئاً إلا أنها لفخامة شأنها لقبت جوهر الأشياء" فهي مسماة وغير مسماة في الوقت نفسه) (21).
وعندما ننظر في أبيات هذا المقطع من القصيدة، فإننا نلاحظ في البيت الثاني أن بهيم الليل قد تحول إلى ضحى، وأن ذلك الظلام يطرده من قلب عمّورية صبح لكنه من اللهب، (فجمع بين الترك والطرد وبين ظلمة الليل والصبح فطابق بين موضعين (22)). فهناك ظلام لكنه ليس بظلام فقد تحول إلى ضحى، وهناك صبح لكنه ليس بصباح حقيقي فإنه من لهب. والصورة في البيت التالي استطراد لتفسير السابقة؛ فالدجى وهو قائم موجود كأنه رغب عن جلابيبه فهو يحاول تبديلها، وكأن الشمس- وهي غير موجودة- قائمة لم تذهب. وفي البيت الرابع يقدم صورتين لمشهد واحد تبدوان متناقضتين لأول وهلة: ضوء من النار يحاول تبديد الظلام العاكف على المدينة، وظلمة من الدخان تذهب لون الضحى وتشحب ضياءه، فيغالبه الظلام , والبيت الخامس تفسير لهذه الصورة واستطراد لها، فبعد ما ذكره ترى شمساً طالعة في الليل مع أن الشمس الحقيقية قد ذهبت. وترى ظلمة في النهار مع أن الوقت ضحى. وفي البيت السادس يتكشف الدهر ويتجسد موقفه إزاء عمّورية، فيصيبها بيوم طاهر جنب، يفسر الشاعر حقيقة اليوم في البيت التالي له؛ بما يذكره من مفارقة يحدثها يوم عمّورية، الذي لم تطلع شمسه على بان بأهله من الروم إذ قتل، وفي المقابل لم تغرب على عزب من المسلمين إذ أنكحتهم رماحهم سبايا الروم.
ثم يعمق أبو تمام المفارقة- من خلال توظيف التراث- عندما يجعل ربعها الخرب- أي عمّورية- غاية في البهاء! فيقرنه بربع مية معموراً يطيف به ذو الرمة تقديساً وشوقاً، ويفضله عليه. فعمّورية محبوبة، تزداد مع الخراب حسناً! وفي سياق الحب، وتناسباً مع تصويره عمّورية امرأة كانت عصية شموساً قبل المعتصم، يراها أبو تمام- في البيت التاسع- من خلال مشهد الخراب الذي تلذذ به سادياً- امرأة لصق خدها- وكانت تصعره في ذي قبل- بالتراب، ومشهدها- ذليلة لصقت بالدقعاء- أشهى لديه من مشهد خدود الحسان وقد أدمين من خجل. وشتان ما بين المشهدين، ولكن الشاعر يصنع شعره من خلال الصور المتقابلة؛ المتناقضة والمتفارقة! وإن كان يعترف في بيت تقريري بأن منظرها سمج في الحقيقة، لكنه يستقبله استقبالاً مفارقاً لما يناسبه إذ يستلذه! فيجمع بين نوافر الأضداد أيضاً. ويختم هذا المقطع بالتضاد أو التقابل الواضح بين حسن المنقلب لدى المسلمين، الذي جاء من سوء المنقلب لدى الروم.
وهكذا نرى أبا تمام قد أوغل في كتابة قصيدته من خلال ما أسمته البلاغة العربية الطباق، وبلغ في تعقيده، فتدرج إلى استخدام التناقض الظاهري paradox ثم إلى استخدام نوافر الأضداد.
واعتماد أبي تمام على فن المطابقة من البلاغة العربية أمر قد لاحظه القدماء، وعلله بعض المحدثين؛ فقد ذكر أستاذنا الدكتور شوقي ضيف:
(وإن من يدرس أبا تمام يرى هذه الأضداد متصلة بأخلاقه، فهو تارة كريم جداً، وتارة بخيل جداً، وهو تارة متدين وتارة ملحد مسرف في إلحاده)(24). فيعلل ولع أبي تمام بفن المطابقة في شعره بطبيعة أخلاقه القائمة على التضاد. أي أن بنية التضاد تعد أساساً لأخلاق أبي تمام وفنه على السواء.
ونضيف إلى ما قاله القدماء والدكتور شوقي ضيف التأكيد على أن هناك مصدراً مهماً نقترح إفادة أبي تمام منه- في هذا الصدد- بحكم ثقافته الواسعة (25) وبفعل الجو الديني الذي يتنفس فيه شعره في الجهاد الإسلامي، ذلك المصدر هو القرآن الكريم.
فقد استعمل القرآن الكريم- كما لاحظ البلاغيون القدماء ابتداء بابن المعتز ت 296هـ في كتاب البديع.. بصفة عامة الطباق. ونلاحظ أن هناك من السور المكية القصيرة التي تبدأ بالقسم سوراً اعتمدت بنية التضاد أساساً لمبناها يتغلغل خطابها على سبيل المثال: سورة الليل يقول الله سبحانه وتعالى:
والليل إذا يغشى/ والنهار إذا تجلى/ وما خلق الذكر والأنثى/ إن سعيكم لشتى/ فأما من أعطى واتقى/ وصدق بالحسنى/ فسنيسره لليسرى/ وأما من بخل واستغنى/ وكذب بالحسنى/ فسنيسره للعسرى/ وما يغني عنه ماله إذا تردى/ إن علينا للهدى/ وإن لنا للآخرة والأولى/ فأنذرتكم ناراً تلظى/ لا يصلاها إلا الأشقى/ الذي كذب وتولى/ وسيجنبها الأتقى/الذي يؤتي ماله يتزكى/ وما لأحد عنده من نعمة تجزى/ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى/ ولسوف يرضى)
وفي هذه السورة الكريمة نجد أنفسنا إزاء ثنائيات متضادة متتابعة تشمل شتى المجالات:
1- من ظواهر الطبيعة: الليل × والنهار - يغشى × تجلى.
2- من البشر والخلق: الذكر × والأنثى.
3- من أعمال البشر: أعطى × بخل- اتقى × استغنى- صدق × كذب.
4- من حساب الله ومجازاته: الحسنى × العسرى- الآخرة × الأولى- سيجنبها الأتقى × يصلاها الأشقى.
وهكذا تتابع الثنائيات والمحصلة: أن تثبت الآيات الكريمة لله سبحانه وتعالى الخلق والأمر.
وتعمق التقابل بين الكفر والإيمان الذي هو قسمة طبيعية شأن الليل والنهار، وترتب على هذه القسمة في السلوك: الأشقى × والأتقى قسمة في الجزاء الجنة × والنار.
وهذه الثنائيات هي ما نلتقي به في سورة مكية قصيرة أخرى مبدوءة بالقسم أيضاً هي سورة الشمس: يقول الله تعالى:
(والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها.) صدق الله العظيم. فتطالعنا الثنائيات الآتية التي تتغلغل في أثناء الكون، ومجالات الخلق، والجزاء:
1- من ظواهر الطبيعة التي تشهد بوجود الخالق سبحانه ووحدانيته:
الشمس × القمر
النهار × الليل
السماء × الأرض
جلاها × يغشاها
وهذه القسمة تعادل القسمة إلى إيمان × وكفر، فمن السماء النور والهداية وعلى الأرض البشر والظلام، ولابد أن تتعانق السماء والأرض ليعم الخير ويتحقق مجتمع اللّه.
2- النفس البشرية التي سواها الخالق سبحانه:
فجورها × تقواها
دساها × زكاها
3- الجزاء والمحاسبة:
خاب × أفلح
4- مثال رجل السماء والهداية، ومثال رجل الأرض والضلال:
رسول الله صلى الله عليه وسلم × أشقاها
وهكذا تتتابع الثنائيات لتكون لها المحصلة السابقة نفسها من إثبات الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى، وتعميق التقابل بين الكفر والإيمان على مستوى السلوك وعلى مستوى الجزاء على السواء.
وتتأكد من خلال تلك الثنائيات- القسمة الجديدة أو الثنائية الجديدة التي أتى بها الإسلام وهي الحياة الدنيا والآخرة التي ينقسم موقف الإنسان فيها ثنائياً أيضاً إلى مؤمن وكافر، فينقسم جزاؤه تبعاً لذلك إلى الجنة والنار. هذه الثنائيات الإسلامية: الدنيا × الآخرة، الكافر × المؤمن، الجنة × النار، قسمة جديدة على عقل العربي الجاهلي الذي لم يكن يعرف سوى قسمة ثنائية واحدة هي الحياة × الموت فقط.
وحري بنا- ونحن ندرس شعر الجهاد الإسلامي الذي يتضمن هذه القسمة الإسلامية الجديدة أن نعقد الصلة بينه وبين القرآن الكريم الذي أتى بهذه القسمة التي تمثلها الشاعر الإسلامي الحقيقي وأقام تفكيره الفني وفق معطياتها.
يرشح لهذه النتيجة ما سنذكره الآن من تمثل أبي تمام- في هذه القصيدة للتفسير الإسلامي للتاريخ الذي أتى به القرآن الكريم.
****
بدر من أبي تمام في قصيدته البائية التي ندرسها هنا، ما يمكن أن نعده تفسيراً للواقعة التاريخية أو الحدث التاريخي وبياناً لمكوناتهما أو عناصرهما.
من ذلك قوله:
لو يعلمُ الكفرُ كم من أعصُرٍ كمنت ….. له العواقبُ بين السُّمر والقُضُبِ
تدبيرُ معتصمٍ باللهِ منتقم ….. لله مرتقب في الله مرتغبِ
ومُطعم النصر لم تكهم أسنتهُ ….. يوماً ولا حُجبت عن روحِ مُحتجبِ
لم يغزُ قوماً ولم ينهد إلى بلد ….. إلا تقدمه جيشٌ من الرعبِ
لو لم يقد جَحفلاً يوم الوغى لغدا ….. من نفسه وحدها في جحفلٍ لجبِ
رمى بك اللهُ برجيها فهدّمَها ….. ولو رمى بك غيرُ اللهِ لم يصبِ
من بعد ما أشبوها واثقينَ بها ….. واللهُ مِفتاحُ بابِ المعقلِ الأشبِ
إن الحمامين من بيضٍ ومن سُمُرِ ….. دلوا الحياتين من ماءٍ ومن شجرِ
عداك حَرُّ الثغورِ المستضامةِ عن ….. بردِ الثغورِ وعن سلسالها الحصبِ
أجبته معلناً بالسيف منصلتاً ….. ولو أجبتَ بغيرِ السيف لم تجبِ
حتى تركتَ عمودَ الشركِ مُنعفراً ….. ولم تُعرجْ على الأوتادِ والطنبِ
لما رأى الحربَ رأي العينِ توفلس ….. والحربُ مشتقة المعنى من الحربِ
غداً يصرفُ بالأموالِ جريتها ….. فعزه البحرُ ذو التيار والحدبِ
هيهات زُعزِعت الأرضُ الوقورُ به ….. عن غزو محتسبٍ لاغزو مكتسبِ
ولّى وقد ألجمَ الخطىُّ منطقَهُ ….. بسكتة تحتها الأحشاءُ في صخبِ
أحذى قرابينه صِرفَ الردى ومضى ….. يحتثُ أنجى مطاياه من الهربِ
موكلاً بيفاعِ الأرضِ يشرفه ….. من خِفةِ الخوفِ لا من خِفةِ الطربِ
خليفةَ اللهِ جازي اللهُ سعيكَ عن ….. جرثومةِ الدينِ والإسلامِ والحسبِ
بَصُرتَ بالراحة الكبرى فلم ترها ….. تُنَالٌ إلا على جسر من التعبِ
إن كان بين صروفِ الدهرِ من رحمٍ ….. موصولةٍ أو ذمامٍ غيرُ منقضبِ
فبين أيامكِ اللاتي نُصرتَ بها ….. وبين أيامِ بدرٍ أقربُ النسبِ
ونقف أولاً عند تفسيره للحادثة التاريخبة فنراه تفسيراً إسلامياً للتاريخ تبدو ملامحه منذ البيت الأول الذي تحدث فيه عن عاقبة الكفر التي كانت حتمية وإن تأجلت. والبيت الثاني الذي يجعل المعتصم بالله يدبر من أجل أن ينتقم من الروم بالله ولله، يراقب الله ويرجو ما عند الله.
وفي البيت الثالث تحدث عن انتصار المعتصم الذي يتم في إطار من رزق الله ومشيئته فهو (مُطْعَم النصر) بصيغة اسم المفعول أي مرزوقه من الله سبحانه وتعالى الذي جاهد المعتصم في سبيله كما بدا من البيت السابق. وقوله (مطعم النصر) في سياق الجهاد في سبيل الله يمكن أن يمثل تناصاً مع سياقات قرآنية متعددة، منها قول الله تعالى: " قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم " الأنعام 14.
وقوله تعالى- على لسان إبراهيم عليه السلام- "الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين" الشعراء79. حيث يرد في الآية الأولى الإطعام مسنداً إلى الله الخالق مرتبطاً بالنصر وفي الثانية يرد مرتبطاً بالهداية.
وفي البيت الرابع يحدث الشاعر تناصّاً مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم (نصرت بالرعب- وفي رواية: مسيرة شهر) (26). ولا يفعل الشاعر ذلك من قبيل المبالغات في المدح التي يتوهمها بعض قراء الشعر ويهربون إلى القول بها عندما يعجزون عن استكناه أسرار الشعر، وإنما هي تعبير فني نراه متساوقاً مع ما سيعقده الشاعر من صلة بين هذه الغزوة وبين غزوة بدر الكبرى التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بما تشعه من دلالات روحية ثرة تكتسبها موقعة عمّورية من خلال هذا الاقتران.
وفي البيت السادس تناص آخر مع آية قرآنية كريمة هي قول الله تعالى: " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " الأنفال 17. ويقصد الشاعر من وراء هذه العلاقة مع نص الآية الكريمة أن يظهر عمل المعتصم هذا من خلال مشيئة الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي يزيد معنى توفيق الله له ويقترب في هذا البيت من معنى التسليط الذي تذكره الآية الكريمة (ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير) الحشر 6. وورد أيضاً في قوله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم) النساء 90.
ويكرر الشاعر في البيت السابع إسناد الفتح إلى الله سبحانه، ولم يبق أبو تمام للمعتصم من دور يمدح به أو من معنى مدحي يخص ذاته سوى قوله:
لو لم يقْد جحفلاً يومَ الوغى لغدا ...... من نفسَه وحدها في جحفلٍ لجبِ
وعندما أراد أن يثبت له أنه من نفسه ورباطة جأشه في جحفل، جاء نفيه- في مطلع البيت- بعد الشرط مثبتاً أنه كان يقود في هذه المعركة جحفلاً حقيقياً. كما أن الشاعر لما أراد أن يظهر المعتصم ممدوحاً بشخصه دون جيشه فذكر أن غزوه غزو محتسب لا غزو مكتسب جاء قوله (غزو محتسب) يظهر المعتصم من خلال معان روحية، تنكر فيها الذات احتساباً وتتلاشى وسط التماس الأجر من الله. بخلاف غزو المكتسب الذي تظهر فيه ذاته الأنانية ذات البطولة المستعلنة التي تحاول الكسب المادي. ولما حاول الشاعر أن يؤكد المعنى المدحي السابق وأن يظهره في سياق حكمة عامة جاء قوله يدمج شخصية المعتصم في شخصية جنوده ويذيبها فيها بدلاًمن أن يكرس تمييزه وذلك في قوله التالي:
إن الأسودَ أسودَ الغيلِ همتُها يوَم الكريهةِ في المسلوبِ لا السلبِ
مما يرجح لدينا انشغال الشاعر بمعاني الجهاد والفتح قبل انشغاله بمعاني المدح وشخصية الممدوح.
هذا مع ملاحظة أن استطراده لذكر شخصية ملك الروم الذي يستكمل به عناصر الواقعة التاريخية أو ملامح المعركة، والذي استخدم فيه مقدرته التصويرية لرسم صورة كاريكاتيرية مضحكة وساخرة لملك الروم، هذا التصوير- أظنه- يخدم شخصية المعتصم ويرسم أشياء من ملامحها عن طريق تقديم النموذج السلبي أو النموذج الضد، ولكن هذه الملامح المستخلصة تخدم الجانب الإنساني من شخصية المعتصم قبل أن تخدم الجانب البطولي منها، وتعلي من قيم الجهاد الإسلامي فالمعتصم يحتسب جهاده لا يكتسب به في مقابل ملك الروم الذي يفرق الأموال ليحفظ نفسه وينجو بها. وإذا كان ملك الروم يضحي بجنده بل بأخلص المقربين إليه، فإن المعتصم مع جنوده يحافظ عليهم ويقاتل بهم، وهمهم العدو لا الغنائم.
ثم يعود ليؤكد إسلامية هذه الغزوة، فالمعتصم (خليفة الله) ينفذ مشيئته وجهاده سعي مشكور يدافع به عن الدين والإسلام، وكذلك عندما يجعل بين هذه الغزوة لعمّورية، وغزوة بدر صلة رحم ونسب، والإسلام يؤكد على أهمية صلة الرحم ويدعمها. ويلاحظ أن الشاعر في كل القصيدة وفي البيت الأخير:
فبين أيامكَ اللاتي نُصرتَ بها ......وبينَ أيامِ بدرٍ أقربُ النسبِ
على وجه الخصوص يبدو أبو تمام مقتصد اً في أوصاف المدح مغايراً لمألوف الشعراء في المبالغة، فلا ينسب إلى المعتصم النصر أو يجعله من عند نفسه، بل يجعله من عند الله سبحانه وتعالى. مما يؤكد ما قررناه من قبل من التزامه التفسير الإسلامي للتاريخ الذي لايغفل الجانب الغيبي بل يقدره حق قدره، ويبرز عمل الإنسان وجهده واضحاً من خلال مشيئة إلهية كلية سابقة وشاملة ونافذة وعلم رباني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يتجلى هذا المعنى للتفسير الإسلامي للتاريخ (27) من خلال آيات قرآنية كريمة متعددة منها قوله تعالى: " لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه " آل عمران 152
وقوله تعالى " فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين" الحشر2.
وقوله تعالى: " قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين " التوبة 11. إلى آخر هذه الآيات الكريمة التي تبدو فيها إرادة البشر متضمنة في إرادة إلهية أشمل في تناسق تام. ومما سبق يبدو لنا أبو تمام من خلال هذه القصيدة شاعراً إسلامياً حقيقياً يستقي من القرآن الكريم أدواته الفنية التي يشكل بها تجربته الشعرية متمثلة في بنية التضاد، كما يستمد من القرآن الكريم رؤيته في تفسير التاريخ.
-4-
ونلجأ إلى الموازنة بين قصيدة أبي تمام السابقة وقصيدة للمتنبي لنحقق هدفين
1- تأكيد ما سبق أن قررناه بصدد أبي تمام، فالتباين يكشف عن الملامح المميزة لكل منهما.
2- الكشف- الذي وعدنا بتحقيقه عن مبنى التفكير الفني ووجهة نظر المتنبي في تفسير التاريخ من خلال هذه العينة من شعره. لتكون الخطوة المقبلة بحثاً شاملاً لهذه القضية في كل النتاج الشعري لهذين الشاعرين الكبيرين.
ويلاحظ- فيما نحن بصدده- أن هناك تأثيراً متبادلاً وتراسلاً أو بعبارة أشمل وأدق علاقة جدلية بين تفسير الشاعر للتاريخ وبين مبنى التفكير الفني في شعره، ونبدأ أولاً بالبحث عن بنية يقوم عليها التفكير الفني للمتنبي في هذه القصيدة:
-أ-
تشكل الذات محوراً فنياً لبنية التفكير الفني في شعر المتنبي فتبدأ قصيدة الحرب المختارة له وهي مما قاله في مدح سيف الدولة الحمداني بغناء حزين لذاته يقول فيه:
ليالي بعد الظاعنين شكولٌ ….. طوالٌ وليلُ العاشقين طويلُ
يبن لي البدر الذي لاأريده ….. ويخفين بدراً ما إليه سبيلُ
وما عشت من بعد الأحبة سلوةً ….. ولكنني للنائبات حمولُ
وإن رحيلاً واحداً حال بيننا ….. وفي الموت من بعد الرحيل رحيلُ
إذا كان شمُ الروح أدنى إليكم ….. فلا برحتني روضةٌ وقبولُ
وما شرقي بالماءِ إلا تذكراً ….. لماءٍ به أهل الحبيبِ نزولُ
يحرمه لمع الأسنة فوقه ….. فليس لظمآن إليه وصولُ
أما في النجوم السائرات وغيرها ….. لعيني على ضوء الصباح دليلُ
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي ….. فتظهر فيه رقةٌ ونحولُ
لقيت بدرب القلةِ الفجر لقية ….. شفت كبدي والليلُ فيه قتيلُ
ويوماً كأن الحسن فيه علامةٌ ….. بعثت بها والشمسُ منك رسولُ
وماقبل سيفِ الدولة أثار عاشق ….. ولا طلبت عند الظلام ذحولُ
ولكنه يأتي بكلِ غريبةٍ ….. تروق على استغرابها وتهولُ
ويلاحظ ابتداء أن الشاعر مشغول بهموم شخصية لها وجود على مستوى الواقع يشير إليها الجزء الأخير من قصيدته الذي نذكره الآن قبل أن نتحدث عنها على مستوى الفن في مقدمته. يقول المتنبي قبيل نهاية قصيدته:
أنا السابقُ الهادي إلى ما أقوله ….. إذا القول قبل القائلين مقولُ
وما لكلامِ الناسِ فيما يريبني ….. أصولٌ ولا لقائليه أصولُ
أُعادي على ما يوجبُ الحبَ للفتى ….. وأهدأُ والأفكار في تجولُ
سوى وجع الحسادِ داو فإنه ….. إذا حل في قلب فليس يحولُ
ولا تطمعن من حاسدٍ في مودةٍ ….. وإن كنت تبديها لم وتفيلُ
وإنا لنلقي الحادثاتِ بأنفسٍ ….. كثيرُ الرزايا عندهن قليلُ
يهون علينا أن تصابَ جسوُمنا ….. وتسلم أعراضٌ لنا وعقولُ
فهذا الختام يكشف لنا أن المتنبى على مستوى الواقع كان يعاني مشكلة في مجلس الدولة لعلها تتعلق بأصالة شعره- وهو سر وجوده وكل كيانه الذي يمثل به في مجلس الدولة ويمارس دوره فيه- ولذلك يؤكد في البيت الأول سبقه وابتكاره لشعره دون غيره من الشعراء ممن يكرر شعر غيره. ويدفع في البيت الثاني اتهامات وجهت إليه ويصفها بأنها- كقائليها- غيرُ ذاتِ أصول، وينفي عن نفسه في البيت الثالث أن يكون فيه ما يعاب، ويحاول أن يظهر- كعادته- عدم اكتراثه بخصومه، الذين يطعن في موقفهم ويشكك في أهمية أقوالهم أنها صادرة عن الحُساد. وعلى الرغم من تظاهره بعدم الاكتراث بأعدائه، وأنه لا يطلب عون سيف الدولة عليهم، إلا أن هذا التظاهر يتضمن رغبة واستمداداً لعون سيف الدولة على كبتهم، ويبرر تظاهره بعدم الاستمداد لعون سيف الدولة، بأن الحسد من أعدائه دائم لا محالة لأنه ثابت على شخصيته لا يغادرها، كما يبرره بقوة نفسه التي يصغر عندها كبير الرزايا، فإنه يحرص على عرضه وكرامته ولا يبالي بما يصيبه من مشقة وجهد أو خسارة مادية، ولكن إلحاحه على ذكر الحساد- مرتين في بيتين متتاليين- يكشف عن شقائه بهم.
وإذا كان المتنبي قد عبر تعبيراً صريحاً عن مشكلته في مجلس سيف الدولة في ختام قصيدته، فقد قدم هذه المشكلة من خلال معادلات فنية في مقدمة القصيدة.
وتتمحور الصور الشعرية في المقدمة- وهي متنامية- حول ذات الشاعر- ويتشكل بناؤها من خلال طرح الموضوعي واختيار ما يخص الذات منه. ففي البيت الأول: نجد ليل الآخرين- وإن كانوا هنا للمماثلة عاشقين- ليلاً طويلاً، وفي المقابل نجد ليله الخاص يتحول إلى ليال شكول، والليل- كما في لسان العرب- (واحد بمعنى جمع، ولكنه جمع على ليال)، والشكول المتماثلة، المتشابهة التي لا تريم، ثم يؤكد ذلك بوصفها بقوله: طوال. أي أن ما يخصه من حال العشاق لا يماثلهم فيه، بل يزيد عليهم فيه.
ويبدو الأمر أكثر وضوحاً في البيت الثاني، الذي يظهر فيه بدر الآخرين الذي لا يريده، ولكن الشاعر إنما يريد بدر ذاته، وإذا كان بدر الآخرين واضحاً ظاهراً، فإن البدر الخاص بالشاعر مخفي، لا يستطيع الشاعر إليه سبيلاً. ويحمل التعبير بالنفي: ما إليه سبيلاً. إحساس الشاعر باليأس الحاد منه.
ومع البيت الثالث لابد من النظر إلى المسكوت عنه في الخطاب مقارناً بالمعلن فيه لتبين قسمة الأشياء بين الذاتي والموضوعي. فالمعلن في الخطاب هو القسم الذاتي: وما عشت من بعد الأحبة سلوة والمسكوت عنه هو الموضوعي: أي عاش غيري بعد الأحبة سلوة وعلى ذلك فالعيش في هذا البيت- عيشان-: عيش الآخرين وهو سلوة؛ وعيش الشاعر، أو عيشه الذاتي: وهو تَحمّلٌ للنائبات وتصبر عليها.
ونتبع نفس المنهج مع البيت الرابع فإذا المعلن عنه في خطابه: هو القسم الذاتي: وإن رحيلاً واحداً حال بيننا والمسكوت عنه هو الموضوعي: فغيره يعاني رحيلاً واحد اً وعلى ذلك فالشاعر يعاني رحيلاً بعده رحيل والمحصلة حرمان دائم من المحبوبة. فنرى غزل المتنبي يطارده الموت ويقبع في خلفية صورته، ويبقى- وفق آليات الشفاهية وإنشاد الشعر- سائداً باقياً في الأذهان بعد إنتهاء لحظة الغزل. فالمحبوبة كأنها حياة تسلمه إلى الموت عندما تفتقد. وجو الحرمان الذي كان يتنفس فيه غزله جعله يرتبط بالموت. وغريب أن يؤدي الغزل لدى المتنبي وكأنه رثاء- إلى التأمل في مشكلة الموت. من ذلك قوله من قصيدته: (ما لنا كلنا جو يا رسول...)!
زوّدينا من حُسنِ وجهكِ مادا ….. مَ فحُسنُ الوجوه حالٌ تحولُ
وصلينا نَصَلك في هذه الدن ….. يا فإنّ المقامَ فيها قليلُ
من رآها بعينها شاقه القط ….. انُ فيها كما تشوقُ الحمولُ
ويشرح اليازجي البيت الأخير بقوله: (يريد أن المقيم في الدنيا على وشك تخليتها والرحيل عنها، فمن رآها بعينها أي من صور نفسه في مكانها ورأى أهلها على أهبة فراقها شاقه النظر إليهم، كما يشوقه النظر إلى حمول الراحلين) العرف الطيب ص 457. وهكذا يقود الغزل- المحروم- عند المتنبي إلى الموت!
والماء- وله وجوده الموضوعي عند الآخرين حيث تنبني عليه حياتهم- يتحول عند المتنبي إلى ماء يغص به ولا يسيغه كغيره فيحرم منه أوتتسع صورته فيصبح الماء الذي تنزل به المحبوبة التي حرم منها. وورود المحبوبة في هذا السياق يساوي بينها وبين الماء وهي صورة عربية جاهلية نجدها في رحلة الظعائن عند زهير في معلقته على سبيل المثال حيث ارتباط وجود المحبوبة بالماء وهي صورة من واقع الحياة العربية، لكنها دخلت الفن وسكنت الشعر. والماء/ المحبوبة في البيت السابع الذي استطرد فيه الشاعر إلى التغزل بالأسنة والمنعة يتفرد موقف الشاعر منه فهو الظمآن الذي يحرم منه ولتقديم الخبر والجار والمجرور المتعلقين به دوره في تأبيد نفيه عنه واستبعاد الأمل فيه تماماً وتأكيد حرمانه.
والنجوم السائرات لديه- بخلاف الآخرين- لا تشكل هادياً يهدي عينيه إلى ضوء الصباح، ويؤدي قوله (وغيرها) دوره في تأكيد معنى النفي الذي يلصقه بالنجوم السائرات. ويكون حديثه عن الليل والنجوم والصباح ثم عن الفجر معبراً عن تناسب أجزاء الصناعة فضلاً على ما تحمله من دلالات نفسية. وكذلك رؤية المحبوب: لا تصيب الآخر وهو- هنا- الليل بشيء لكنها تصيب المتنبي بالرقة والنحول. وهذه الصور وإن كان فيها قدر باهظ من الوعي، فإن دلالاتها النفسية ما زالت قادرة على الإشعاع.
تلك كانت حاله قبل سيف الدولة أو قبل حرب سيف الدولة أما بعدهما أي بعد سيف الدولة/ الحرب، فالمتنبي: يلتقي الفجر، ويتحول الليل- بما له من دلالات مشعة في نفس المتنبي- إلى قتيل، والمحصلة شفاء نفس الشاعر مما كانت تجد وحل مشكلاته. وعندما يستطرد المتنبي إلى إكمال الصورة السابقة فيتحدث عن يوم المعركة فإن اللافت للنظر إليه أن يبدأ وصل الشاعر لمحبوبته بهذا اليوم فترسل إليه علامة منها هي الحسن كما ترسل الشمس رسولاً منها، وكأن مشكلات الشاعر من الظلام ومن الحرمان من محبوبته ذات البدر مرة وذات الشمس مرة أخرى قد حلت مع يوم حرب سيف الدولة. ولذلك شعر المتنبي أنه نسب إلى سيف الدولة أشياء لم تكن تنسب إلى أحد من قبله؛ فقد نسب إليه أنه ثأر للشاعر العاشق! وأنه ثأر له من الظلام أيضاً!.
وعندما يفيق المتنبي من هذه الأجواء النفسية ليدخل في أجواء الوعي والمدح يبرر ذلك- على عادة الشعراء في المدح- بما يسمى حسن التخلص أو الخروج الذي يثبت فيه لسيف الدولة القدرة على فعل الخوارق والغرائب بقوله:
ولكنه يأتي بكل غريبة ….. تروق على استغرابها وتهول
ويتخذ من هذا البيت سبباً يلج منه إلى عالم المديح. أي أن فن المتنبي في هذه القصيدة- وربما في كل شعره- يتخذ من الذات محوراً يدور عليه، يحوّر ظواهر الطبيعة والأشياء ليعبر عن قسمه منها أو نصيبه أو اختياره الذاتي ولذلك لا نعجب إذا وجدنا القصيدة- على الرغم من كونها نصاً شعرياً في الحرب- تدور حول ذاتين: ذات المتنبي أولاً ثم ذات سيف الدولة. هذا مع استخدامه في هذا السياق الذاتي أدوات فنية جزئية من البلاغة التقليدية، تأتي في مقدمتها ألوان التكرار اللفظي وقليل من المطابقة والتشبيه، ولكنها لا تمثل اختياره إنما كان اختياره- الذي أوضحناه- أن يدير الأشياء حول ذاته.
- ب-
يمتد المتنبي بطريقته في التفكير الفني إلى تفسير الواقعة التاريخية بل إن قلب هذه القضية يكون أكثر إصابة للحقيقية، إذ أن تفسيره البطولي للواقعة التاريخية، وله دوافعه المتعددة لديه ومنها اعتداده بذاته قد لازمه في كل ما صدر عنه من شعر، وترك أثره في طريقته الفنية وبنائه للصورة الشعرية. ويلاحظ بهذا الصدد- أي تفسير الواقعة التاريخية- اعتناق المتنبي للتفسير البطولي أو الفردي للتاريخ، الذي يجعل الفرد- بعيداً عن سياقات بيئته، الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية- قادراً على صنع الحادثة التاريخية وتوجيه عجلة التاريخ في فردية واستبداد تأمين.
ولعل اعتناق المتنبي لهذا الضرب من التفسير للتاريخ- الذي سنعرض الأدلة عليه من شعره- يرجع إلى ما يأتي:
1- اعتداده الشديد بذاته وثقته بقدرتها على الفعل وإحساسه بالتفرد مما يؤدي إلى إغترابه في كثير من شعره، ونظراً لشهرة هذا الأمر سنورد عليه أمثلة قليلة منها قوله في قصيدته: واحر قلباه
سيعلمُ الجمعُ ممن ضم مجلسنا ….. بأنني خير من تسعى به قدمُ
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ….. وأسمعت كلماتي من به صممُ
وقوله:
أنا تِربُ الندى وربُّ القوافي ….. وسمامُ العدا وغيظُ الحسودِ
أنا في أمةٍ تداركها اللهُ ….. غريبٌ كصالحٍ في ثمودِ
وقوله:
ليس التعللُ بالآمالِ من أربي ….. ولا القناعةُ بالإقلال من شيمي
ولا أظنُّ بناتِ الدهرِ تتركني ….. حتى تسدَّ عليها طرقَها هممي
سيصحبُ النصلُ مني مثل مضربه ….. وينجلي خبري عن صمّة الصممِ
لأتركن وجوه الخيلِ ساهمةً ….. الحرب أقومَ من ساقٍ على قدمِ
ومن حديث المتنبي عن ذاته وقدراته قوله:
طوال الردينيات يقصفها دمى ….. وبيض السريجيات يقطعها لحمي
كأني دحوتُ الأرضَ من خبرتي بها ….. كأني بنى الإسكندر السدَّ من عزمي
وقوله:
أفكر في معاقرة المنايا ….. وقودِ الخيلِ مشرفة الهوادي
زعيم للقنا الخطى عزمي ….. بسفك دم الحواضر والبوادي
إلى غير ذلك من الكثرة الكاثرة من أبيات شعره.
2- علاقة المتنبي بالتشيع: وأمر نشأته في بيئة شيعية بالكوفة، واتهامه باعتناق مذاهبهم كالقرمطية مشهور، تحدث عنه طه حسين في كتابه (مع المتنبي)، وتحدث عنه محمود شاكر في كتابه (المتنبي).
والشيعية مسئولة- إلى حد كبير- عن إشاعة هذا التفسير البطولي للتاريخ، بما قالت به من فكرة الإمامة (ودورها في إقامة العدل وتصحيح التاريخ بوصفها لطفاً من الله تعالى) (28) فالإمامة- عندهم- (لطف من الله ومن ثم يجب على الله تعالى نصب الإمام أي تعيينه، لأنه المعصوم الذي يحفظ الشرائع ويحرسها ويردع عن الفساد ويحث على الصلاح) (29). وقد ردد المتنبي عقائد الشيعة في الإمامة في شعر صباه، من ذلك ما قاله (وهو في المكتب يمدح رجلاً وأراد أن يستكشفه عن مذهبه).(30)
يا أيها الملك المصفّى جوهراً …..من ذات ذي الملكوت أسمى من سما
نورٌ تظاهر فيك لا هوتيه …..فتكادُ تعلمُ علمَ ما لن يُعَلَما
ويهمُّ فيك إذا نطقت فصاحةً …..من كل عضوٍ منك أن يتكلَّما
(العرف الطيب ص 11)
وقال المتنبي في مدح محمد بن زريق الطرسوسي:
بشرٌ تصورَّ غاية في آيةٍ …..تنفي الظنون وتفسد التقييسا
لو كان ذو القرنين أعمل رأيه …..لما أتى الظلماتِ صرن شموساَ
أو كان صادف رأس عازر سيفه …..في يوم معركة لأعيا عيسى
أو كان لجُّ البحرِ مثلَ يمينه …..ما انشقّ حتى جازَ فيه موسى
أو كان للنيرانِ ضوءُ جبينه …..عُبدتْ فصار العالمون مجوسا
لما سمعت به سمعت بواحد …..ورأيته فرأيت منه خميسا
(العرف الطيب ص 53)
ونقف عند البيت الأول من هذا المثال الثاني ففيه نجد عقيدة الشيعة في الإمام المعصوم. قال الشارح: (يقول إن الله صوره بشراً وجعله غاية للناس تنتهي إليها كمالاتهم بأسرها. وكان ذلك الخلق في آية من خوارق العادات تنتفي بها ظنون الناس فيه، فلا تقع على حقيقة كنهه ويفسد قياسهم له بغيره لأن الشيء إنما يقاس بمثله ولا مثل له) (31).
ونقف عند البيت الأخير الذي يشير في رأينا إلى تطور هذه العقيدة الدينية الشيعية الغالية إلى ضرب من التفكير الفني لدى المتنبي، عندما تتحول من موقف واختيار ومعنى عقدي إلى معنى مدحي مفرط، وقد وقف الشراح عند انتهائه في مجال المدح ولم يربطوه ببدايته العقيدية المسرفة؛ قال الشارح في تفسيره: (إنه يقوم بنفسه مقام الجيش ويغني غناءه) (32).
ونرى خلافاً لابن الرشيق في العمدة أن العقيدة الشيعية الغالية التي عرفها المتنبي كثقافة وربما اعتنقها في صباه كعقيدة كانت الباب الذي ولج منه المتنبي إلى الغلو في معاني المدح لا ما ذهب إليه ابن الرشيق من العكس: أي أن الغلو والإفراط في رأيه قد أدّيا بالمتنبي إلى هذا الصدام مع العقيدة الإسلامية. (33)
ومما أفرط فيه من المدح على النحو الذي يؤكد ما ذكرناه من تدرجه من الغلو في العقيدة إلى الغلوّ في معاني المدح قوله:
لو كان علمك بالإله مقسماً …..في الناس ما بعث الإله رسولا
لو كان لفظك فيهم ما أنزل الـ …..فرقان والتوراة والإنجيلا
لو كان ما تعطيهم من قبل أن …..تعطيهم لم يعرفوا التأميلا
فلقد عُرِفت وما عُرِفت حقيقةً …..ولقد جُهِلت وما جُهِلت خُمُولا
نطقت بسؤددك الحمَام تغنياً …..وبما تجشمها الجيادُ صهيلا
ومن مبالغاته التي تدرج إليها من العقيدة الغالية إلى المدح بقوله:
عدوك مذمومٌ بكل لسان ….. ولو كان من أعدائك القمرانِ
ولله سرٌ في عُلاَك وإنما …..كلامُ العِدا ضربٌ من الهذيانِ
لو الفلكُ الدوارُ أبغضتَ سعيه …..لعوقه شيءٌ عن الدوران
وقد امتد اعتناق المتنبي لفكرة البطل/ الفرد الناتجة لديه عن المصدرين السابقين إلى آرائه السياسية الواضحة في مثل قوله:
وإنما الناسُ بالملوك وما …..تفلحُ عربٌ ملوكها عجمُ
لا أدبٌ عندهم ولا حسبُ …..ولا عهودٌ لهم ولا ذممُ
بكل أرضٍ وطئتُها أممٌ …..ترعى بعبدٍ كأنها غنمُ
ولا يهمنا من هذه الأبيات أن نشير إلى عروبيته وإنما يهمنا أن نشير إلى إعلائه لدور الفرد في صناعة التاريخ وتشكيل مصير الجماعة، فالناس بالملوك، والملك الأعجمي عبد يرعى غنماً.
* * *
ونقف عند القصيدة موضوع دراستنا لنكشف عن رأيه في تفسير التاريخ الذي عددناه- فيما سبق- امتداداً لتفكيره الفني أو ذا علاقة جدلية به يقول المتنبي:
رمى الدربَ بالجُرد الجيادَ إلى العِدا …..وما علموا أن السهامَ خيولُ
وما هي إلا خطرةٌ عرضتْ له ..بحرَّان لبتها قناً ونصولُ
همامٌ إذا ما همَّ أمضى همومَه ..بأرعنَ وطءُ الموتِ فيه ثقيلُ
وخيلٍ براها الركضُ في كل بلدةٍ …..إذا عرست فيها فليس تقيلُ
فلما تجلى من دَلُوك وصنجةٍ …..علتْ كلَّ طودٍ رايةٌ ورعيلُ
سحائبُ يمطُرن الحديدَ عليهم …..فكلُ مكانِ بالسيوف غسيلُ
فخاضت نجيعَ القومِ خوضاً كأنّه …..بكلِ نجيعٍ لم تخضهُ كفيلُ
وبتن بحصن الران رزحى من الوجى …..وكلُ عزيزٍ للأميرِ ذليلُ
وفي كلِ نفسٍ ما خلاه ملالة …..وفي كل سيفٍ ما خلاه فلولُ
لبسن الدجى فيها إلى أرض مرعش …..وللروم خطبٌ في البلادِ جليلُ
فلما رأوه وحدَهُ قبل جيشِه …..دروا أن كلَّ العالمين فضولُ
وأنَّ رماحَ الخطِ عنه قصيرةٌ …..وأن حديدَ الهندِ عنه كليلُ
فأوردهم صدرَ الحصانِ وسيفَه …..فتى بأسهُ مثلُ العطاءِ جزيلُ
جوادٌ على العلات بالمالِ كله …..ولكنه بالدارعين بخيلُ
فودَّع قتلاهم وشيّع فلَّهم …..بضربٍ حزونُ البيضِ فيه سهولُ
على قلبِ قسطنطينَ منه تعجبٌ …..وإن كان في ساقيه منه كبولُ
نجوتَ بإحدى مهجتيك جريحةً …..وخلّفت إحدى مهجتيك تسيلُ
أغركم طول الجيوش وعرضها …..علىٌّ شروبٌ للجيوش أكولُ
إذا لم تكنْ لليث إلا فريسة …..غذاه ولم ينفعك أنك فيلُ
وإن تكن الأيامُ أبصرن صولةُ …..فقد علّم الأيامَ كيفَ تصولُ
فدتك ملوكٌ لم تُسمُ مواضياً ….. فإنك ماضي الشفرتين صقيلُ
إذا كان بعضُ الناسِ سيفاً لدولةٍ …..ففي الناسِ بوقاتٌ لها وطبولُ
فنلتقي في هذه الأبيات بثلاثة عناصر متجاورة ومتفاعلة هي: سيف الدولة وهو القائد والممدوح، والعنصر الثاني: جيش سيف الدولة، والعنصر الثالث هو عدو سيف الدولة: قسطنطين ابن الدمستق. ويلاحظ ابتداء أن هذه العناصر الثلاثة تصب كلها في تيار إعلاء العنصر الأول (سيف الدولة) وتمجيده على النحو الذي يؤكد انتحاء المتنبي- في هذه القصيدة- نحو ما يسمى التفسير البطولي أو الفردي للتاريخ وذلك على النحو التالي؛ مع ملاحظة صعوبة الفصل التام بين ما يخص كل عنصر من العناصر الثلاثة.
أولاً: سيف الدولة
نراه في البيت الأول فاعلاً (رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا) وينسب إليه الفضل في حدوث حركة الاجتياح التي حصلت من المسلمين لبلاد الروم: (فما هي إلا خطرة عرضت له..) فالفعل التاريخي رهن بخطرات سيف الدولة! وفي البيت الثالث يكيلُ له صفات المدح التي تجعل منه قادراً على الفعل: (همام إذا ما هم..) فإنه يمضي همه بواسطة جيشه القوي ذي الوطأة الثقيلة وكذلك بواسطة خيله. وعندما يتحدث عن حركة الجيش وانتقاله من مكان استولى عليه إلى آخر، يسند الفاعلية إلى سيف الدولة فلما تجلى عن دلوك وصنجة...) حتى عندما تخوض خيول المسلمين في المعركة في دم الأعداء قد يسند إلى سيف الدولة أنه بكل نجيع لم تخضه كفيل.
وفي البيت الحادي عشر يقرر على لسان الروم أن سيف الدولة جيش بمفرده قبل جيشه وأن الناس بعده فضول. ويجعله في البيت الثاني عشر أقدر على الفعل من الرماح والسيوف فالرماح عنه قصيرة والسيوف عنه كليلة، وهذه الصورة سبق أن وصف المتنبي بمثلها نفسه:
طوال الردينيات يقصفها دمى ….. وبيض السريجيات يقطعها لحمى
وورد مثلها في مدح أحد العلويين من شعر صباه:
ياليت لي ضربة أتيح لها …..كما أتيحت له محمدها
أثر فيها وفي الحديد وما …..أثر في وجهه مُهذّدها
وفي البيت الثالث عشر يشير إلى أنه لقى أعداءه بنفسه وقتلهم بحد سيفه وجعل صدر فرسه مورداً لأسلحتهم (34) كما ساوى الشاعر بين شجاعة سيف الدولة وعطائه؛ فهو (فتى بأسه مثل العطاء جزيل).
ثم ينسب إليه في البيت الخامس عشر كل بطولة في المعركة (ودّع قتلاهم وشيّع فلهم). وينسب إليه في البيت العشرين أن له صولاً علّم الأيام كيف تصول. ثم يوظف اسم سيف الدولة في مدحه عندما يجعله اسماً على مسمى وأن الملوك لم تسمّ باسمه لأنها ليست لها صفات السيف ومضاؤه. ويكمل الصورة في البيت التالي- وهو البيت الثاني والعشرون من أبياته التي أوردناها- عندما يقارن بين ممدوحه وغيره من الملوك فممدوحه سيف للدولة فاعل مؤثر قاطع وأعداؤه طبول وأبواق لا يغنون غناءه ولا يؤثرون تأثيره.
والعنصر الثاني: جيش سيف الدولة
والحديث عنه يكشف عن قوته (سحائب يمطرن الحديد عليهم...) لكنه يسلبه الفاعلية- في الغالب- ويسندها إلى سيف الدولة كما سبق أن أشرنا في مثل قوله (رمى الدرب بالجرد الجياد...) وعندما أسند الفاعلية في تحركات الجيش إلى سيف الدولة (فلما تجلى من دلوك وصنجة...) حتى عندما يتحدث عن الخيل بالأفعال الماضية المناسبة للسرد (خاضت- كرّت- رعن بنا- طلعن عليهم) نجده يعتمد في هذه الأفعال على معنى السرد لا معنى الفاعلية. فجيش سيف الدولة وكذلك خيله كلها وسيلة لإنفاذ همته فهو وحده دون جيشه الهمام.
ويلاحظ إصرار المتنبي على نسبة الفضل إلى سيف الدولة على الرغم من جيشه حتى لتبدو بينه وبين جيشه علاقة عدائية تجعله يصر على إتعاب جيشه لينفذ سيف الدولة همته على الرغم من جيشه مثال ذلك قوله:
وخيل براها الركض في كل بلدة …..إذا عرّست فيها فليس تقيل
وأوضح منه قوله:
وبتن بحصن الران رزحى من الوحى …..وكل عزيز للأمير ذليل
فخيله متعبة لإنفاذ همته ليس ذلك فقط فإنما هي قد ذلت له ضمن من أو ما ذل له، فكأنها تساوت مع أعدائه فإنها قد تعرضت لإذلاله لها. وهذه الصورة مما تكرر شعر