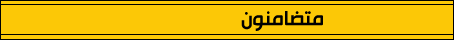ادعاء أن الإسلام دين حرب وليس دين سلام

مضمون الشبهة:
يزعم بعض الطاعنين أن الإسلام ليس دين سلام، ولو كان كذلك لما فرض فيه الجهاد القتالي، ويتساءلون: كيف تتفق الدعوة إلى الجهاد مع الدعوة إلى السلام؟!! ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في الغايات السامية للجهاد في الإسلام.
وجوه إبطال الشبهة:
إن المتأمل المنصف لحقيقة الإسلام وطبيعة أحكامه ومقاصد شرائعه،يدرك أنه دين سلام للبشرية كلها، عربها وعجمها،بكل مللها ونحلها.
الباعث على الحرب والقتال في الإسلام هو دفع الاعتداء، لا البدء به، قال عز وجل: )وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (190)( (البقرة).
السلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، وهو أصل في عقيدة الإسلام، وعنصر من عناصر تربيته، وهدف يعمق الإحساس به في ضمير الفرد، وفي واقع المجتمع، وفي بناء الأمة.
الجهاد القتالي في الإسلام لم يكن قط دون ضوابط وآداب، فللجهاد ضوابط قبل بدء القتال، وفي أثناء القتال وبعده.
التاريخ والمنصفون من غير المسلمين يشهدون بعدالة الفتح الإسلامي، سماحة المسلمين مع أهل البلاد المفتوحة.
التفصيل:
أولا. الإسلام دين سلام للبشرية كلها، عربها وعجمها، بكل مللها ونحلها[1]:
مع عناية الإسلام البالغة بقوة المسلمين أفرادا وأمة، وأمره ببذل ما في الوسع للإعداد للقتال، وإعداده الأمة كلها لتكون عند الحاجة جيشا يقاتل في سبيل الله، وتربيتها على الأخذ بأسباب القوة والصبر على الجهاد، فإنه لا يعتبر الحرب هي الأصل في الحياة، إنما يعدها ضرورة لدفع العدوان والظلم، ويعد السلام هو الأصل والهدف الذي يعمل لتحقيقه.
إن العالم في حاجة ماسة إلى قوة تدافع فيه عن الحق، وتكفل الحرية لجميع الناس، وتقف في وجه الدول الطاغية التي تستذل الشعوب وتمتص دماءها وتتحكم في مصائرها، والإسلام يريد لأمته أن تكون هي هذه القوة، تحافظ على أمن العالم وسلامته، والانتصار للحق في كل مكان، بصرف النظر عن الدين والجنس والوطن، ومن ثم كان لا بد لها من القوة: قوة الإيمان بالحق، وقوة النفوس، وقوة الإعداد، فالسلام الذي يريده الإسلام إذن، ليس سلام الضعف والاستكانة، ولا السلام على حساب مثله الرفيعة في الحياة.
والسلام في مبادئ الإسلام أعمق من أن يكون مجرد رغبة يدعو إلى تحقيقها في الحياة، إنما هو أصل في عقيدته، وعنصر من عناصر تربيته، وهدف يعمق الإحساس به في ضمير الفرد وفي واقع المجتمع وفي بناء الأمة، إنه يتصور الحياة وحدة إنسانية غايتها التعارف والتعاون بين الجميع، ولا يتصورها صراعا بين الطبقات، ولا حربا بين الشعوب، ولا عداوة بين الأجناس: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم( (الحجرات:13)، ويتصور الأديان كلها دينا واحدا بعث الله به رسله للبشرية الواحدة.
والمؤمنون الذين آمنوا بهذا الدين أمة واحدة - في كل زمان ومكان - ويصور النبي هذه الوحدة بالبناء الواحد الذي لا يشغل منه إلا موضع لبنة: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين»[2].
ثم يخطو الإسلام خطوة كبيرة في سبيل تحقيق هذا الهدف، وذلك بتقرير حقوق الإنسان، تلك الحقوق التي لم يصل إليها حتى اليوم نظام ولا شريعة ولا فلسفة، في عمقها وأصالتها ورفعتها، فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق كريم وكائن ممتاز، كرمه ربه بنفحة علوية من روحه، وزوده بالمواهب والطاقات التي تمكنه من تعمير الأرض والرقي بالحياة، وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في أرضه، وسخر له في حياته كل ما يحتاج إليه لتحقيق رسالته: )ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (70)( (الإسراء).
ويرمي الإسلام إلى تحقيق هذه الكرامة للإنسان في واقع الحياة، للإنسان بوصفه إنسانا، بصرف النظر عن دينه وجنسه ولونه ووطنه، فأعطاه حق الحياة الحرة الكريمة، ففرض لكل جاهل أن يتعلم، ولكل محتاج أن يعان، ولكل مريض أن يداوى، ولكل خائف أن يؤمن، وصان عرضه وماله ومسكنه، وحرم دمه أن يسفك، وحريته أن يعتدى عليها، وضميره أن يتحكم فيه، ولم يترك هذه الحقوق عرضة للعبث والضياع، ولم يصغها في أسلوب الحكم والنصائح، إنما جعلها من صميم العقيدة لها حرمة الإيمان، كما جعلها فرضا على المجتمع والدولة.
وأكد حرمة الدم البشرى، فحرم سفكه إلا بالحق، لا فرق بين إنسان وإنسان: )ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق( (الأنعام:151).
وعظم من حرمة النفس البشرية، ومن زور الاعتداء عليها، فاعتبر النفوس كلها واحدة، من اعتدى على إحداها فكأنما اعتدى عليها جميعا؛ لأنه اعتدى على حق الحياة، ومن قدم لإحداها خيرا فكأنما قدم الخير للإنسانية بأسرها، قال عز وجل: )من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا( (المائدة:32).
وعلى أساس احترام النفس الإنسانية كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يربي أصحابه، فقد جاء عن جابر قال: «مرت بنا جنازة، فقام النبي وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، فقال: "أوليست نفسا»[3]؟
وبهذا الفقه كان المسلم يتحرج من سفك الدماء في أحرج المواقف؛ فحينما حاصر الثوار أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ومنعوا عنه الماء، وأجمعوا على قتله، حاول الصحابة أن يقاتلوا الثوار فأبى عثمان، يقول أبو هريرة: دخلت على عثمان يوما الدار، فقلت له: جئت لأنصرك، وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا، قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك، مأجورا غير مأزور[4].
وروح الإسلام ومبادئه ومنهجه في التربية ترمي كلها إلى إقرار السلام وتعميق حبه في ضمير المسلم وسيادته في المجتمع، وليس في الدنيا شريعة ولا نظام يفرض على أتباعه رياضة أنفسهم على السلام إلا الإسلام؛ ففي فريضة الحج مثلا يحرم على المسلم أن يقتل حيوانا أو يهيج طائرا أو يقطع نباتا أو يؤذي إنسانا بيد ولا لسان: )الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج( (البقرة:197).
وكذلك الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني صائم، إني صائم»[5].
وهي تربية عملية على تذوق حياة السلام، وتعود ممارستها في الحياة، والتعامل على أساسها في المجتمع.
ومما يؤكد أن الدعوة للسلام تحتل المقام الرئيس في أهداف الإسلام العامة ومقاصد شريعته السامية ما يأتي[6]:
أكد القرآن الكريم أن المقصود الأعظم من اعتناق الإسلام الاهتداء إلى طرق السلام والنور، قال الله عز وجل: )يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين (15) يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم (16)( (المائدة)، و بالاستقراء في كتاب الله - سبحانه وتعالى - نجد أن لفظ "السلام" وما اشتق منه يزيد على 133 آية قرآنية، بينما لم يرد لفظ "الحرب" إلا في ست آيات فقط.
إن اسم "الإسلام" من "مادة السلام"[7].
من أسماء الله - عز وجل - السلام، قال الله عز وجل: )هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون (23)( (الحشر).
تحية المسلم لرسول الإسلام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في التشهد: "... السلام عليك أيها النبي... " وعند قبره الشريف كذلك.
تحية المسلم لنفسه وللمسلمين أحياء وأموات في الصلاة في التشهد "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين... ".
تختم الصلاة عند المسلمين - فرضا ونفلا - بصيغة "السلام عليكم... ".
التحية المشروعة للمسلم لإخوانه "السلام عليكم... ".
من أسماء الجنة "دار السلام" قال الله عز وجل: )لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون (127)( (الأنعام). )والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (25)( (يونس).
وليلة القدر التي نزل فيها القرآن كلها سلام: )سلام هي حتى مطلع الفجر (5)( (القدر).
تحية المؤمنين في الجنة "السلام" قال الله عز وجل: )تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما (44)( (الأحزاب).
هناك آيات قرآنية محكمة تحض على السلام، منها: )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (208)( (البقرة). )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم (61)( (الأنفال). )يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا (94)( (النساء). )إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (90)( (النساء). )فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير (15)( (الشورى). )لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (

( (الممتحنة(.
وفي الحديث الشريف:
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: «أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"، ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجرى السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»[8].
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يربي المسلمين على إيثار السلام، واستنفاد الحيلة في دفع العدوان وعدم القتال: جاء عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: "فانشد بالله"، قال: فإن أبوا علي؟ قال: "فانشد بالله" قال: فإن أبوا علي؟ قال: "فانشد بالله"، قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار»[9].
وعلى أساس هذه الأصول يعتبر الإسلام السلام هو الأصل، ويعتبر الحرب ضرورة لا يلجأ إليها إلا مقاومة للظلم والعدوان، وحين لا يكون بد منها، أما الحروب العدوانية أو الهجومية بالمفهوم الحديث - فهي حروب لا يعرفها الإسلام: )وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (190)( (البقرة).
وكذلك يأمر القرآن بوقف الحرب بمجرد طلب العدو للصلح، حتى ولو كان في طلبه مظنة خيانة أو غدر، أو كان يبغي من وراء وقف القتال كسب الوقت للإعداد لحرب ثانية )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم (61) وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين (62)( (الأنفال).
ثانيا. الباعث على الحرب في الإسلام دفع الاعتداء لا البدء به:
إن الباعث الوحيد على الجهاد في الإسلام - رد الاعتداء ودفعه، وليس في الإسلام دعوة إلى المبادأة بالقتال ألبتة، ويوضح هذا الشيخ محمد أبو زهرة فيقول: إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية في الحروب يرى أن الباعث على القتال، ليس هو فرض الإسلام دينا على المخالفين، ولا فرض نظام اجتماعي، بل الباعث على القتال في الإسلام هو دفع الاعتداء.
وها هنا قضيتان إحداهما نافية والأخرى مثبتة:
أما النافية، فهي أن القتال ليس للإكراه في الدين، ودليلها قوله عز وجل: )لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي( (البقرة:256)، ولقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا حاول أن يكره بعض ولده على الدخول في الإسلام، وجاءت امرأة عجوز إلى عمر بن الخطاب في حاجة لها، وكانت غير مسلمة، فدعاها إلى الإسلام فأبت، فتركها عمر، وخشي أن يكون في قوله - وهو أمير المؤمنين - إكراه، فاتجه إلى ربه ضارعا قائلا: "اللهم أرشدت ولم أكره"، وتلا قوله عز وجل: )لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(، لقد نهى القرآن الكريم عن الفتنة في الدين، واعتبر فتنة المتدين في دينه أشد من قتله، وأن الاعتداء على العقيدة أشد من الاعتداء على النفس؛ ولذا جاء فيه صريحا: )والفتنة أشد من القتل( (البقرة: ١٩١).
وأما القضية المثبتة، فهي أن القتال لدفع الاعتداء، وقد نص عليها القرآن أيضا، إذ يقول: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (194)( (البقرة)، وإن القرآن بمحكم نصوصه جعل الذين لا يقاتلون المؤمنين في موضع البر إن وجدت أسبابه، وأن الذين يقاتلون هم الذين يعتدون؛ فقد جاء فيه: )لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (

( (الممتحنة).
ومع أن القتال شرع لدفع الاعتداء، إلا أن القرآن لم يأمر بالحرب عند أول بادرة من الاعتداء، أو عند الاعتداء بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير القتال؛ فقد جاء فيه: )وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين (126) واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون (127)( (النحل).
هذه نصوص واضحة تثبت - بلا ريب - أن حرب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الأخيار من بعده لم يكن الباعث عليها إلا دفع الاعتداء، ولم يكن الباعث عليها فرض رأي أو دين، ولكن يجب علينا أن نفرض أن كل مبدأ سام يتجه إلى الدفاع عن العقيدة وعن الحرية الشخصية يهم الداعي إليه أن تخلو له وجوه الناس، وأن يكون كل امرئ حرا فيما يعتقد، يصطفي من المذاهب بحرية كاملة ما يراه أصلح للاتباع في اعتقاده، وما يراه أقرب إلى العقل في نظره، فإذا كان طاغية أو ملك قد أرهق شعبه من أمره عسرا، وضيق عليه في فكره، وحال بينه وبين الدعوات الصالحة تتجه إليه، فإن حق صاحب الدعوة إذا كان في يده قوة أن يزيل تلك الحجز التي تحول بينه وبين دعوته ليصل إلى أولئك المستضعفين، وتخلو وجوههم لإدراك الحقائق الجديدة وإعلان اعتناقها إن رأوا ذلك وآمنوا به، ولكن محمدا النبي الأمين - صلى الله عليه وسلم - لم يلجأ إلى ذلك ابتداء حتى لا يظن أحد في الأخلاف أن محمدا قاتل ليفرض دينه على الناس، أو ليكرههم عليه؛ ولذلك سلك طريقين:
أولهما: أن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء في عصره يدعوهم إلى الإسلام، ويحملهم إثمهم وإثم من يتبعونهم إن لم يجيبوا دعوته، ولذلك جاء في كتابه إلى هرقل: " أسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الأريسين" أي: الرعية من الزراع وغيرهم )قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله( (آل عمران: ٦٤).
ثانيهما: أنه بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يعلن الحقائق الإسلامية ليتعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها من يريد اتباعها، وقد اتبعها فعلا بعض أهل الشام ممن يخضعون لحكم الرومان، وعرف المصريون وغيرهم حقيقتها، حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرفها، وتسامعت بها البلاد المتاخمة للعرب.
وما اتجه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قتال الفرس و الروم، إلا بعد أن ثبتت حقيقتان:
أولاهما: أن الروم قد ابتدءوا فاعتدوا على المؤمنين الذين دخلوا في الإسلام من أهل الشام، فكان ذلك فتنة في الدين وإكراها للمسلمين على الكفر، وما كان محمد - صلى الله عليه وسلم - ليسكت على ذلك، وقد جاء لدعوة دينية، وإنه إن كان لا يحمل الناس على اعتناق الإسلام كرها، إلا أنه لا يمكن أن يسكت عمن يحاولون أن يخرجوا أتباعه من دينهم كرها، إنه لا يريد أن يعتدي، ولا أن يعتدى عليه؛ ولذلك اعتبر هذا العمل من جانب الرومان اعتداء على دينه وعليه؛ لأنه صاحب الدعوة فلا بد أن يزيل هذه الفتنة.
الأخرى: أن كسرى عندما بلغه كتاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم بقتل من حملوه، وأخذ الأهبة ليقتل النبي - صلى الله عليه وسلم ـواختار من قومه من يأتيه برأسه الشريف الطاهر، ولكن أنى لكسرى وأمثاله من الطغاة أن يمكنهم الله - عز وجل - من ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم ــ وقد علم بالأمر - ما كان ليسكت حتى يرتكب كسرى هذا الإثم، بل إنه القوي العادل الحصيف؛ ولذلك كان لا بد أن يصرعه وجيشه قبل أن يصرعه هو.
لهاتين الحقيقتين اتجه النبي - صلى الله عليه وسلم - لقتال الرومان والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولئك الرومان ومحاربيهم، كما قاتل المشركين لمنع هذه الفتنة، إذ يقول القرآن الكريم: )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين (193)( (البقرة)[10].
ويقول ابن تيمية في قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الروم: "وأما النصارى فلم يقاتل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم، حتى أرسل رسله إلى قيصر وإلى كسرى، وإلى المقوقس والنجاشي، وملوك العرب بالشرق والشام، فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم، فالنصارى هم الذين حاربوا المسلمين أولا، وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما، فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل محمد - صلى الله عليه وسلم - سرية أمر عليها زيد بن حارثة، ثم جعفرا، ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من أرض الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستشهد الأمراء الثلاثة - رضي الله عنهم - وأخذ الراية خالد بن الوليد[11].
وبهذا يتبين أن قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إلا دفعا للاعتداء، والاعتداء الذي حدث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على صورتين:
إحداهما: أن يهاجم الأعداء النبي - صلى الله عليه وسلم ـفيرد كيدهم في نحورهم.
ثانيتهما: أن يفتن الأعداء المسلمين عن دينهم، ولا بد أن يمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الاعتداء على حرية الفكر والعقيدة.
وفي الصورتين نجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفرض دينه، ولا يكره أحدا عليه، ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي هي مبدأ من مبادئه، إذ قد جاءت مقررة في القرآن، إذ يقول عز وجل: )لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي( (البقرة: 256). فالحق أن قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - كان دفاعا عن حرية الرأي وحماية العقيدة من أن يفتن صاحبها.
وما انتقل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه حتى كانت كل البلاد التي حوله قد تحركت لتفتن المؤمنين عن دينهم، وقد ابتدأ الرومان فعلا، فلم يكن بد من الاستعداد لهم، وهم كسرى بأن يقتله؛ ولذا أوصى - صلى الله عليه وسلم - بأن يذهب جيش كثيف إلى الشام، وجعل أسامة بن زيد أميرا عليه، وجعل من جنوده الشيخين الجليلين أبا بكر - وعمر رضي الله عنهما.
ولما آلت الخلافة إلى أبي بكر، ثم عمر أرسلا الجيوش إلى كسرى وهرقل بعد أن خمدت الردة، وصارت الكلمة لله ولرسوله وللمؤمنين في شبه جزيرة العرب.
وكذلك كان القتال في عهد الخلفاء الراشدين جميعا، لا في عهد الخليفتين الأولين فقط، ولقد سارت المعركة في طريقها بين الفرس ومن وراءهم من الشرق، وفي الشام وما وراءها من ملك هرقل، وأمن الناس بهذه الحرب في عقائدهم، ولم يكن الأمن خاصا بالمسلمين، بل إن اليعقوبيين من المسيحيين أمن لهم اعتقادهم فحيل بين الرومان وبين ما يشتهون من محاولة حملهم على "الكثلكة"، أي: حملهم على الدخول في المذهب الكاثوليكي؛ ولذا رحبوا بالفاتحين من المؤمنين، ولم يكن قتال إلا مع الرومان، حتى إذا هزموا في أول صدمة، صارت المعركة بين المسلمين والمصريين مناوشات وليست حروبا، وانتهى الأمر بالتسليم لعدالة الإسلام، الذي يحمي الحريات، وخصوصا حرية الاعتقاد.
ثالثا. السلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، وهو أصل في عقيدة الإسلام:
وإذا كان القتال في الإسلام لدفع الاعتداء، وليس للحمل على اعتقاد معين، فإن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم حتى يقع اعتداء، فإن كان الاعتداء، فإن الحرب تكون أمرا لا بد منه، ردا للشر بمثله، ولتحمي الفضيلة نفسها من الرذيلة كما قررنا، وإن ذلك الأصل ثابت بالنصوص القرآنية، وثابت بالوقائع التاريخية في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي القرآن الكريم: )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (208)( (البقرة)، وفيه أيضا: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم (61)( (الأنفال)، وفي القرآن أيضا: )يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا( (النساء: ٩٤)، وإن كل هذه النصوص قاطعة في أن الأصل هو السلام حتى يكون الاعتداء، فالذين آمنوا بمقتضى النص الأول يدعون إلى الدخول في السلم بكل ضروبه وأشكاله، ولا شك أنه لو كان الأصل هو الحرب ما دعوا إلى هذا الأمر السامي، والنص الثاني يدعو إلى الميل إلى السلم والدخول فيه إن مالوا إليه، ولو كان القتال للكفر ما كان السلم إلا بعد الإيمان، ولكنه دعا إلى الجنوح إلى السلم إن مالوا إليه، ولو لم يكن إيمان، والنص الثالث ينهى عن القتال إذا ألقى العدو إلى المسلمين السلام.
وقائع التاريخ تشهد بأن القتال فرض على المسلمين:
إن الوقائع التاريخية في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - تؤكد أن القتال في الإسلام كان دفاعا، وأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سلم، وذلك يتبين من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع سيفا على مخالفيه، حتى كان منهم اعتداء بالفعل أو تربص بالاعتداء:
فأما كفار قريش، فقد مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم بدعاية الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد والتطهر من أرجاس الجاهلية ومظالم العصبية، ما ترك بابا من أبواب الدعوة بالموعظة الحسنة إلا دخله، تحقيقا لأمر الله له )ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن( (النحل:125)، ولكنهم آذوه وآذوا أصحابه، ولم يتركوا بابا من أبواب الأذى إلا دخلوه فجاهدهم - صلى الله عليه وسلم - بالصبر والمصابرة، حتى هموا بقتله، وجمعوا من كل قبيلة شابا ليضربوه ضربة رجل واحد، وأحاطوا بداره ليفعلوا فعلتهم، ولكن الله - عز وجل - نجاه، فخرج من بيته مهاجرا، وكان أصحابه من قبله قد هاجروا فرارا بدينهم الذي ارتضوا، وعندئذ جاء الإذن بالقتال، كما قال عز وجل: )أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (39) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز (40)( (الحج).
وكان القتال مقصورا على قريش لا يعدوهم؛ لأنهم هم الذين اعتدوا، واستمروا على اعتدائهم باستمرارهم على أذى المستضعفين الذين بقوا بمكة لا يستطيعون عنها حولا، وكانت غزوتا بدر وأحد خاصتين بقريش، ولكن قريشا جمعوا له الجموع من العرب جميعا في غزوة الأحزاب، فتضافروا جميعا على اقتلاع المدينة الفاضلة من أرض العرب، فكان لا بد من قتال العرب كافة؛ لأنهم جميعا قد اعتدوا؛ ولذا نزل قوله عز وجل: )وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين (36)( (التوبة)، فقد اعتدوا جميعا فكان حقا على المؤمنين أن يردوا اعتداءهم جميعا: )ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز (40)( (الحج).
وأما اليهود، فعندما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة لم يستبح دماءهم، بل سالمهم وعقد معهم عقد جوار يجعل لهم حقوقا وعليهم واجبات، وكان حلفا كريما، لم يفكر في نقضه، فلم يكن المؤمنون وعلى رأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، واستمر - صلى الله عليه وسلم - على عهده نحو ثلاث سنين، حتى بعد غزوة بدر، التي خذل الله بالإيمان فيها الشرك كله، فقد أذلت فيها قريش، ولكن كانت الخيانة من اليهود في غزوة أحد في السنة الثالثة، ثم في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، حين اجتمعت العرب كلها لتجتث الإسلام من موطنه، وكانت خيانات لو تمت لذهب أهل الإيمان، وكان لا بد من نبذ العهد، كما يقرر القرآن: )وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين (58)( (الأنفال).
وأما النصارى، فقد بينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحاربهم إلا بعد أن قتلوا المؤمنين في الشام، ولم يحارب النصارى كافة بل حارب الرومان فقط، وقد كان على أتم ولاء مع نصارى العرب، وأنه لم يحارب الرومان بوصفهم نصارى، بل حاربهم بوصفهم معتدين، وأن النصارى من العرب قد جاء القرآن بالثناء عليهم في قوله عز وجل: )لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون (82) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين (83)( (المائدة).
وبهذا الاستقراء التاريخي نجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حارب أحدا لم يعتد عليه، أو لم يدر الأمر ضده، أو لم يتآمر على الإسلام مع أعدائه، وهو الذي يقرر الحقائق الإسلامية وحده، وإنه يقرر أن من سالم المسلمين لا يحل لهم أن يقاتلوه، ومن اعتدى عليهم لا يحل لهم أن يتركوه[12].
رابعا. الجهاد القتالي في الإسلام له ضوابط وآداب، قبل بدء القتال، وفي أثناء القتال، وبعده:
تقرر سلفا أن باعث الجهاد في الإسلام رد الاعتداء، وتحطيم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية، أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها، ومع أن الإسلام حدد الهدف - وهو جد نبيل - إلا أنه لا يقر مبدأ " الغاية تبرر الوسيلة"، ولذا حدد المدى ووضع الضوابط والقيود، لينأى بنفسه وبأتباعه عن هذه الشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء، إذ ينفر منها حسه وتأباها تقواه. ومن أفضل من تناولوا هذه الضوابط بالتفصيل الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه " نظرية الحرب في الإسلام" فيقول:
ضوابط قبل المعركة:
لا يبتدئ القتال في الإسلام إلا بعد تخيير المقاتلين بين أمور ثلاثة: الإسلام، أو العهد، أو الحرب، وقد ذكرنا أنه بعد أن انتشر الإسلام في البقاع صار المسلمون في وسط أعداء يتحينون الفرصة للانقضاض على الإسلام وأهله، وإن سكنوا فليستعدوا ويضربوا الضربة التي يرونها قاصمة، فكان لا بد من أن يسبقهم الإسلام قبل أن يسبقوه، والهجوم في أحيان كثيرة يكون الطريق الوحيد لرد الاعتداء.
ولكن الإسلام لا يريد أن يأخذ مخالفيه على غرة، بل هو يعلنهم قبل الهجوم، وإعلانه دليل على أنه لا يقصد بالقتال أن يستولي على أرض، أو يحكم الرقاب، أو يتحكم في مصائر العباد، بل يريد أن يأمن جانبهم، إما بالعهد يعقدونه، أو بالإسلام يعتنقونه، فإن لم يكن واحد من الأمرين، كانت نية الاعتداء واضحة بينة، فلا بد أن يقوا أنفسهم منه.
وقد سار المسلمون على ذلك المنهاج في فتوحاتهم، وصار من بعد ذلك أمر الإسلام مشهورا، وقد نسي بعض القواد أن يخير بين هذه الأمور، فهجم من غير تخيير، ومن هؤلاء "قتيبة بن مسلم الباهلي" الذي فتح ما وراء النهر، وانساب في الأرض حتى أوشك أن يصل إلى الصين، وحدث وهو يغزو سمرقند ويقاتل أهلها أن دخل صغد - من أعمالها - من غير هذا التخيير بين الأمور الثلاثة، فشكوا إلى "عمر بن عبد العزيز"، وقالوا: ظلمنا قتيبة وغدر بنا فأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والإنصاف، وطلبوا أن يؤذن لهم ليقدموا على أمير المؤمنين، ويبسطوا قضيتهم فأذن لهم، ولما علم شكواهم كتب إلى واليه ذلك الكتاب:
"إن أهل سمرقند شكوا ظلما وتحاملا من قتيبة عليهم، حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس إليهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم، فأخرج العرب إلى معسكرهم قبل أن يظهر عليهم قتيبة".
فأجلس الوالي لهم القاضي، فقضى أن يخرج العرب إلى معسكرهم، وينابذوهم على سواء، فيكون صلحا جديدا، أو ظفرا عن عنوة، فقال أهل الصغد من سمرقند: بل نرضى بما كان ولا نحدث.
فأي مثل للعدالة أروع من هذه المثل، وأي محارب يعامل محاربه هذه المعاملة؟ هل رأى التاريخ الإنساني أن منتصرا يتخلى عن الأرض من غير قوة تخرجه؟! بل يخرج استجابة لداعي العدالة التي حكم بها قاضيه، فيتخلى عن الأرض التي فتحها، وقتل فيها من قتل، ثم يعرض عليهم من جديد، إما الصلح، وإما الإسلام، وإما الحرب، ولقد اختار أهل سمرقند لأنفسهم، فآثروا العافية، بل آثروا الحق والعدل، ودخلوا في الإسلام أفواجا.
ومن وصايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمجاهدين:
وصيته - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب، ونصها: "إذا نزلت بساحتهم، فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، فإن قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم حتى ترهم أناة. ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا: لا إله إلا الله؟ فإن قالوا: نعم، فقل: هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا: نعم، فقل: هل لكم أن تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم؟ فإن قالوا: نعم. فلا تبغ منهم غير ذلك، والله لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت"[13].
ونقف وقفة قصيرة عند هاتين الوصيتين فإنهما تكشفان عن مقصد القتال، وهو دفع الاعتداء، وإن نية السلم ثابتة حتى عندما يتلاقى الجيشان، ويقف كل واحد منهما لصاحبه ينتهز فرصة الانقضاض، أو ينتظر ساعة الالتحام، وما كانت الدعوة إلى الإسلام أو المعاهدة إلا من قبيل إيثار جانب السلم على جانب القتال، وإبعاد فكرة الانتقام من الاعتداء الماضي، وإيثار السلم في المستقبل على توريث العداوة وإشعال نيران الحرب، فهل بعد ذلك يقال أن الإسلام دين قتال، وليس دين سلام؟!
بل إنه يحرض جنده على ألا يبدءوا بالقتال؛ لأن دم المخالف حرام حتى يبيحه باعتدائه، ودم الحربي حرام حتى يبادر بالقتل، فإن قتل فقد أصبح غير معصوم الدم.
ومع ذلك إذا ابتدءوا وقتلوا بالفعل لا يقاتلهم حتى يريهم المقتول، ويقول - في روح المسالم القوي الذي يبغي حقن الدماء -: أما كان خير من هذا؟! وهو السلام والأمن باعتناق الإسلام، أو عقد المعاهدة على الأمن، فإن لم تجد رؤية المقتول، ولم تثر عطفهم، وتحملهم على إيثار المودة والسلم أو الدخول في أمان المسلمين، لم يكن بد من القتال، وعندئذ يتقدم المؤمنون طالبين إحدى الحسنيين؛ النصر أو الشهادة، ويكون النصر من عند الله العزيز الحكيم.
هذه صورة عن ابتداء حرب النبوة، وهي تؤكد بلا ريب أن الحرب كانت ضرورة لا بد منها، فإما أن يسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ويترك الفضيلة تنتهك حرماتها، والرذيلة تلقي حممها، وإما أن يكفها ويدفع أذاها، ويخلص الحق وأهله، وهو ابتداء يكشف عن الغاية ويوضح الباعث.
ضوابط القتال في المعركة:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسير على سياسة التأليف بين الناس ما أمكن التأليف، وكان يأمرجنوده وهم في القتال أن يحرصوا على التأني بدل التقتيل والفتك، وجاء في ذلك أنه قال لجنده: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى الإسلام».[14] هي إذن حرب رفيقة تتسم بالتأني، وتتسم بالمحافظة حتى على الأعداء، وأحب إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يأتوه بهم سالمين قد عمر الإيمان بالحق قلوبهم من أن يأتوا إليه بالنساء والذرية سبايا، فليست حربا وحشية، بل هي حرب نبوية.
وإن بين أيدينا وصيتين إحداهما للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأخرى لخليفته، ومنهما يتبين قانون الحرب الإسلامية في ميدان القتال:
أما الوصية الأولى: فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم:«سيروا باسم الله في سبيل الله، وقاتلوا أعداء الله، ولا تغلوا[15]، ولا تغدروا، ولا تنفروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا».[16] ويقول لخالد بن الوليد: «لا تقتل ذرية ولا عسيفا»[17] [18].
أما الوصية الثانية: فقد جاء «عن أبي بكر الصديق أنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: "إما أن تركب وإما أن أنزل"، فقال أبو بكر: "ما أنت بنازل، وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله". ثم قال له: "إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن - أي حلقوا - أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن» [19].
ما يحل وما لا يحل في القتال:
هذه الوصايا التي نطق بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ونطق بها خليفته وصديقه من بعده تصرح لنا بقانون الميدان، وبالقيود التي يقيد بها المقاتل في الميدان، حتى لا يكون في سيفه رهق، وحتى لا يصاب غير مقاتل.
وإن الأساس في هذه الوصايا أنه لا يقتل في الميدان إلا من يقاتل بالفعل، أو يكون له رأي وتدبير في القتال، وأن الأساس في القتال هو رد الاعتداء، وكسر شوكة الأعداء، وليس القتل انتقاما، بل هو منع للظلم؛ ولذلك لا تخريب، ولا هدم، ولا إتلاف، ولا تمثيل بالقتلى، ولنذكر بعض هذه الأمور التي نهى عنها خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتباعا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - واقتداء به - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر ونهي.
منع قتل رجال الدين:
أول ما نهى عنه أبو بكر هو قتل رجال الدين؛ ذلك أنه أرسل جنده إلى الشام التي كانت بها الأرض المقدسة، والتي بها المعابد التي عكف عليها العباد، فكان لا بد من أن يمنعه من أن يمتد سيفه إلى أولئك الذين انصرفوا للعبادة، فليس لهؤلاء شأن بالقتال، وقد قسم الصديق الرجال الذين يتسربلون بسربال الدين .
منقول