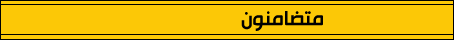إصدارات بلا هوية واضحة وكتب يصعب تصنيفها
إعداد: دارين شبير
تسير في المكتبات ومعارض الكتب، يلفت نظرك كم الكتب المتهادي على الأرفف، بعناوين جاذبة وألوان لافتة، يدفعك الفضول لالتقاط أحدها، تُقلِّب صفحاته بشغف، بنهم يجبرك على معرفة تفاصيل الكتاب، تتفحص الأسطر وتدقق فيها، لتجد نفسك حائراً في تصنيفها، فلا هي خواطر ولا حِكَم، ولا هي قصص قصيرة، ولا روايات.
تغمض عينيك في محاولة للخروج من مأزق وضعت نفسك فيه عنوة، فلا تسعفك تلك العتمة، لتعود للكتاب ثانيةً فتجد نفسك بين أشعار بطعم الخواطر، وقصص بنكهة دروس الحياة، وروايات بملامح الشعر، وبين شعر يتحول فجأة إلى نثر، تُفاجأ بعبارات «تويترية» أو «فيسبوكية» أو صور «انستغرامية» مع شرح مقتضب، تتربع بين غلافي كتاب أنيق، تم تجميعها معاً لتأخذ طريقها إلى النشر، متربعة على أرفف المكتبات جنباً إلى جنب أبرز الروايات وأشهر الدواوين الشعرية. وفي تلك الدوامة، تنهال على رأسك تساؤلات كثيرة، أبرزها ما يتعلق بفوضى النشر، ومدى أهمية مثل هذه الإصدارات، والقيمة التي تقدمها للقراء.
«البيان» تواصلت مع أدباء وكُتَّاب ونقاد وأصحاب دور النشر، لتستطلع آراءهم في هذا الجانب، فكان التباين في الآراء واضحاً، بين من يعتبر ذلك فوضى نشر، وتمرداً على القوالب الأدبية، ومُطالباً بقيود وقوانين تنظم المسألة، وبين من ينظر للأمر على أنه إبداع يجب ألا تحده الحدود، ومطالباً بمنح الفرصة للجميع، للتعبير عما بداخله من مواهب وإمكانات، فربما أثمر ذلك عن أعمال مهمة مستقبلاً.
تحديات
حسن الزعابي صاحب دار مداد للنشر، أكد أن من حق أي كاتب نشر أعماله الأدبية، والجمهور القارئ هو صاحب الكلمة تجاه تلك الأعمال، وقال: من المهم أن يشهد سوق النشر ظهور العديد من الأقلام سواء كانت شابة أم مخضرمة، ولكن على دور النشر أن تحدد الصنف الأدبي للكتب التي ستنشرها.
وعن رأيه في فوضى النشر السائدة حالياً، أجاب: لا أعتقد بوجود فوضى نشر، ولكن قد تنتج بعض الأخطاء والزلات، وأرى أن هناك صراعاً من أجل بقاء صناعة النشر في ظل التحديات الكثيرة، من انتشار الوسائل الإلكترونية وسرقات الملكية الفكرية، ومن يخوض مجال النشر هو شخص محب للكتب، وعاشق لها وطامح في بقائها.
وعن ظاهرة فرض بعض الشخصيات الاجتماعية أو الإعلامية الشهيرة نفسها على الناشر، لينشر لها ما تشاء بغض النظر عن المضمون، قال: سأتحدث عن دارنا، فنحن نعتمد على لجنة القراءة، التي تهتم بمضمون النص قبل اسم الكاتب، لأن المضمون سيعيش في ذاكرة القُراء لأطول فترة ممكنة، بعكس الكتب التي تعتمد على اسم كاتبها فقط، وهذا لا يمنع منح الفرصة للشباب، ليدخلوا عالم التأليف، وليحصلوا على فرصتهم.
وعن اقتراحاته لحل أزمة فوضى النشر، قال: يجب على دور النشر أن تحدد أهدافها من النشر، حيث من المهم أن تتواجد في الساحة دور صنف محدد كدور متخصصة في الشعر، وأخرى في الروايات، وأيضاً على الدور تطوير آلية عمل لجنة القراءة، التي تستحق أن تُسمى بالقلب النابض للدار، لأن عليها مهمتين رئيستين هما، تحديد النص وتحريره، ليكون لائقاً باسم الدار ومناسباً للقُراء.
إعادة حسابات
أكدت الدكتورة مريم الشناصي، رئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين والمدير العام لدار الياسمين للنشر، أن القارئ يجب ألا يهتم لتصنيف الكتاب بقدر ما يهتم بمحتواه، وقالت: الكتاب متعة ورحلة شائقة، وعلى القارئ أن يركز على الاستفادة من مضمونه وغناه، بغض النظر عن تصنيفه، والبقاء دائماً للأصلح، فالكتاب الجيد سيبقى بغض النظر عن تصنيفه أو جنسه الأدبي، ومن حق كل صاحب رؤية وفكر وتجربة أن يكتب، وعلينا أن نفكر بأن اللغة العربية تعاني اليوم في وجه نظيرتها الإنجليزية، التي أصبحت لغة الحديث والدراسة، وهو ما يجعلنا نعيد حساباتنا في ضرورة الاهتمام بالمواد المكتوبة بالعربية.
وأشارت إلى ضرورة إعطاء الفرصة للمحاولات الجديدة، وقالت: قد تؤدي إلى شيء جميل، وهذا دور النقاد، وهناك بعض الناشرين يحاول مواكبة التطور الحالي بتغذية محتوى كتبه، ليأخذ من كل بستان زهرة، ويقدم بالتالي مزيجاً مختلفاً قد يتقبله المجتمع، وقد يرضي بعض الأذواق، ويلبي حاجة البعض الآخر، ولكن هي الآن محاولات، ولا بد أن نمنح الفرصة لجميع الناشرين والكتاب والأذواق لعرض تجاربهم، وعلى المجتمع انتقاء ما يناسبه، مع الأخذ في الاعتبار أن التركيز يجب أن يكون على كتاب يحتوي على معلومة أو تجربة يمكن الاستفادة منها. وذكرت الشناصي أن هناك ما يسمى اليوم تجارة الكتب، ولا بد أن ندرك أن الناشرين يضخون أموالاً ،ومن حقهم استعادة رأس المال.
وتحدثت عن التغييرات التي تواجه الأدب، وقالت: حين صدر الشعر الحر في بداياته قوبل بالرفض، وواجهته انتقادات كثيرة، وبعدها رأى المجتمع أن الأدب لا بد أن يتطور، وألا يكون جامداً، وهذا يجعل الأدب يواكب التطورات الحاصلة في المجتمع.
وعن فوضى النشر، قالت: من وجهة نظري كوني رئيسة جمعية الناشرين، أرى محاولات مختلفة من الناشرين المحليين- بالدرجة الأولى- في النشر بكل الحقول، ورأيتُ توجه بعضهم للنشر لشخصيات معروفة في المجتمع، وذلك لإقبال الجمهور على هذه الفئة، فعندما يصدر شخص مشهور كتاباً، يحظى كتابه بإقبال جماهيري، وللأسف، ينجرف قراء كثيرون وراء الشخصية نفسها بغض النظر عن المحتوى.
وأضافت الشناصي: بعض الكتب التي رأيتها كانت عبارة عن صورة مع تعليق، وحين نرى قيمة الكتاب من حيث الشكل والطباعة نجده قيماً، إلا أنه يبقى فقيراً في محتواه، والسؤال هنا، إلى أي مدى سيبقى هذا الكتاب خالداً؟ وإجابتي أنه سيكون فقاعة ستنفجر بسرعة، وقد يحقق الناشر بعض الأرباح والشهرة من ورائه، إلا أن بريق الكتاب لن يستمر.
متطلبات العصر
أمام عصر اقتحمته التكنولوجيا من كل جانب، أكد الشاعر محمد نور الدين، صاحب دار نبطي للنشر، أن الأجناس الأدبية في تجدد دائم، وفقاً لمتطلبات العصر، وقال: تطل علينا أجناس أدبية مختلفة، سواء كانت عبارة عن امتزاج الأجناس القديمة بعضها ببعض، أو ظهور أجناس أدبية جديدة، أفرزتها التقنيات الحديثة والأوعية المعلوماتية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لنرى قوالب مختلفة، وذلك ينعكس على الإصدارات الجديدة، من حيث الشكل وعدد الكلمات، وطريقة الإخراج وغيرها.
وأشار نور الدين إلى أن كل الإمكانات موجودة لظهور أجناس أدبية جديدة، وقال: نحن في مرحلة انتقالية، ومن الصعب أن نحكم إن كان ذلك جيداً أم لا.
توضيح
وما إذا كان- ناشراً- على استعداد لنشر كتب يصعب تحديد هويتها، قال: «كوني ناشراً، سأحاول التغلب على ذلك وتوضيح الأمر قدر الإمكان، فمثلاً، كان هناك مجموعة شعرية نشرتها، وصنفتها تحت مسمى «رواية شعرية»، وهناك مجموعة أخرى نشرتها تحت تصنيف «خواطر نثرية في تنمية الذات»، والكتاب عبارة عن تنمية الذات مكتوب بأسلوب خاطرة، وهكذا. وأكد أنه لا يتعامل مع الأمر كونه فوضى، مُطالباً بفتح الأفق للإبداع.
وقال: «من الضروري أن نحتوي الكُتاب الجدد، وأي عمل إبداعي يعتبر إضافة، ومقارنة بعض الإصدارات بأخرى قديمة ربما يظلمها، ولكن المقارنة بين وجودها وعدم وجودها سينحاز لوجودها من باب دعم الإبداع، كما أنه لا يمكن أن نقارن جنساً أدبياً مر عليه أكثر من 100 عام بآخر لم تكتمل ولادته بعد».
خلط وتشتت
أكد الشاعر والكاتب خالد الظنحاني، أنه لطالما عانى من تلك المسألة، لافتاً إلى أنه كثيراً ما يزور معرض كتاب أو مكتبة، ليرى كتباً كثيرة خالية من أي مضمون، مشيراً إلى أن نشر مواد لا تندرج تحت أي تصنيف أدبي، يؤدي إلى الخلط والتشتت بين الأجناس الأدبية، وقال: في مجال الشعر، أصبح الخلط كبيراً، فنحن لسنا ضد قصيدة النثر، ولكن ليس بالشكل الذي نراه اليوم، فالقراء أصبحوا حائرين في معنى قصيدة النثر، معتقدين أنها الخواطر، غير مدركين أن شعر النثر لا يُحسن كتابته إلا شخص متعمق باللغة والثقافة.
وتحدث الظنحاني عن ظاهرة انتشرت بين دور النشر، تتمثل في فرض الشخصيات الاجتماعية أو الإعلامية نفسها عليها، لتصدر لهم كتباً لا تمتاز بمحتوى غني، ومتسائلاً عن قيمة مثل تلك الكتب التي كانت شهرة أصحابها السبب وراء نشرها رغم عدم أحقيتها.
الظنحاني أكد أن مسؤولية فوضى النشر تقع على عاتق وزارة الثقافة، كونها الجهة المسؤولة عن منح تصاريح الطباعة، وفي المقابل يتجه البعض لطباعة كتبهم خارج الدولة، كما تحدث أيضاً عن مشكلة تحوُّل النشر إلى تجارة، قائلاً: بعض دور النشر المحلية تسعى جاهدة لإصدار بأي طريقة، حتى تحول الأمر إلى «بزنس»، وللأسف، بعض أصحاب دور النشر يُصرِّحون بذلك مبررين حقهم في الحصول على أرباح من وراء تجارتهم في مجال الكتب، وهذا شيء مؤسف، فمن الحق أن تربح من وراء جهودها، ولكن ليس عن طريق تشويه الصورة بهذا الشكل.
وعن اقتراحاته للحلول، قال الظنحاني: يُفترض على وزارة الثقافة أن تشدد على الأمر بأن تُكوِّن لجنة من كبار الكتاب والمبدعين الشباب دورها التدقيق في المواد المقدمة للنشر، كما أقترح أن توجِد دور النشر كاتباً محرراً لكل ما يصدر ويطبع، لأن دوره ضروري جداً ووجوده ليس عبثياً، ففي دور النشر الأجنبية لا بد من وجود هذا الشخص، الذي تتمثل مهمته في تحرير الرواية، وتقديمها بشكل جميل، حتى إن كبار الكتاب العالميين أقروا بأهمية هذا المحرر كونه يساعدهم في إظهار رواياتهم بالشكل المطلوب. وأنهى الظنحانى حديثه بيقينه التام بأن الإمارات ستتغلب على كل معوقات النشر، للحراك الثقافي الكبير، الذي تشهده الدولة.
كتابة مطلقة
كان للكاتب والناقد عزت عمر، رأي مخالف لغيره، فهو مع الكتابة المطلقة قلباً وقالباً، ومع نشر أي مادة، سواء كانت ذات ملامح واضحة أم لا، ومع نشر كل ما يكتب متسائلاً عن جدوى منع نشر تلك التجارب التي قد تكشف عن مبدعين حقيقيين، وقال: لماذا نسعى لإيقاف الكتابة؟ وأكمل: نحن قراء وهذا دورنا فقط، أن نقرأ أو لا نقرأ، ولكن لا داعي لأن نقف ضد نشر الأعمال الجديدة، وهذا الدور، الذي يتبوأ له البعض، أرفضه تماماً، فأنا مع الكتابة المطلقة سواء كانت على هيئة نصوص أو شذرات أو حكمة أو تجربة حياتية أو أي شيء آخر، لو وجد الكاتب وسيلة لنشر كتابه، فعليه المضي نحوها، طالما أنه لا يضر بأحد، ولا يمس بأخلاق الناس وقيم المجتمع.
وذكر عمر أن دور النشر تسعى لتشجيع المواهب، ولكسب رزقها والحصول على أرباح في الوقت نفسه، وهي في الأغلب تسعى نحو الأسماء الشهيرة وتلهث وراءها، أما الأسماء غير المعروفة، فتدفع تكلفة النشر بنفسها، وبالتالي لا تخسر دار النشر شيئاً، وهنا تقع المسؤولية على عاتق الكاتب.
واستحضر عمر بعض المواقف، من خلال خبرته في هذا المجال، فقال: أرسل لي أحد الكتاب الجدد مجموعة قصصية، ووجدت أنها لا ترقى للنشر، فاقترحت عليه تحويلها لنصوص من واقع الحياة، كما أرسل لي كاتب نصاً روائياً، وجدت أنه يعاني بعض المشكلات وأخبرته عنها، فقام بتصحيحها، وأخذ كتابه حيزه للنشر. وأضاف: الروعة تكمن في الكيفية التي يجذبك بها الكاتب إلى عالمه، ويزودك بخبرة جديدة، بغض النظر عن التصنيف أو الانتماء لأي جنس أدبي، وهنا أتساءل: لماذا ينبغي أن تصنف الكتابة ضمن الأطر الكلاسيكية؟. ولفت إلى أن هناك أنماطاً جديدة شاعت، عبر وسائل التواصل المختلفة، عبارة عن شذرات ونصوص قصيرة، ولها قراؤها، مؤكداً أنه ينبغي علينا مواكبة التطور الحاصل، فالكتابة ليست خسارة أبداً، طالما امتلك الشخص القدرة عليها.
وتابع: «لا يجوز أن نقف حراساً على الإبداع، ولا أن نضع المبدعين تحت أي وصاية، ولنفتح المجال للجميع بأن يقدم ما لديه، ولنا أن نحاسبهم في حال تجاوزوا أو تطاولوا على الأخلاق أو قيم المجتمع».
نشاط إضافي
بمجرد التطرق لهذا الموضوع، ظهرت نبرة الهم واضحة في صوت الكاتبة والشاعرة صالحة غابش، مدير دار صديقات للنشر، التي ما إن بدأت الحديث فيه، حتى قالت: «هناك فوضى في النشر، وهناك كاتب لا يعرف لماذا يكتب، ويتعامل مع الكتابة كونها نشاطاً إضافياً بعدما لمس تأثير الكاتب في المجتمع، ولكن ليست كل كتابة تصل بالشكل الراقي، الذي تصل به كتابة المبدع صاحب الخبرة.
وعن المتهم في ذلك. قالت: اللوم يقع على دور النشر التي تمنح الفرصة لنشر أي شيء، وأيضاً على الجهات المعنية بالرقابة، والتي لا تمنع نشر الرديء منها، وتتوقف فقط عند الثلاثة موانع المعروفة لإجازة رخصة الكتاب، ولكن يجب أن يكون هناك مانع رابع يتعلق بجدية الطرح، ومستوى اللغة والفكر وجدية الكتابة. وذكرت غابش أن كل ما يُكتَب أصبح يُنشر اليوم، ويحقق نسبة مبيعات عالية حسبما يتردد، وقالت: لا أعرف إن كان ذلك حقيقة أم خدعة، ولكني أتمنى فعلاً أن تكون هناك جدية في التعامل مع الأمر.
غربلة
وعن اقتراحاتها للحلول، قالت: نحن بحاجة للجان عاملة وإدارات تغربل الكتب، بحيث لا يكون الكتاب الذي يحتوي موانع هو الممنوع فقط، بل يجب أن توضع جميع الكتب تحت المجهر، ليتم تفنيد الجيد من الغث، ومنع الكتب التي لا يرقى محتواها لفكر وثقافة المجتمع وتطلعاته للمستقبل. وتحدثت عن تحويل العبارات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى كتب، قائلة: هذا لا يضيف شيئاً لا للقارئ ولا للحراك الثقافي الجاد، ومن يقوم بذلك أشخاص يستسهلون كتابة الأدب، وأنا لست ضد أن يصدر الشخص كتاباً، ولكن يجب ألا يتعجل في ذلك، فالكاتب بحاجة لمستند ومرجعية ثقافية وفكرية وتراكم خبرات يؤهله لتقديم فكر متميز، كما أننا كوننا كتاباً، لا يمكن أن نصدر كتبنا أو دواويننا قبل عرضها على نقاد وكُتاب كبار، لنتناقش حول المحتوى، فتلك مسؤولية. وذكرت غابش أن هذه الفوضى مسؤولية دور النشر والجهات المعنية بالرقابة قبل أن تكون مسؤولية الكاتب نفسه.
قارئ فوضاويّ
«فوضى النشر لا بد أن ينتج عنها فوضى القراءة»، هكذا بدأت الروائية باسمة يونس حديثها، لافتة إلى أن النشر «الفوضاوي» ينتهي بشخص فوضاويّ التفكير، وقالت: وجدتُ كتباً لا أعرف تصنيفها، ولا لأي جنس أدبي تنتمي، وبالنسبة لي كوني كاتبة أشعر بالقهر، لأن ذلك يضعنا كوننا كُتاباً في موضع الاتهام، فلا نستطيع مواجهة مثل هذه الكتابات وأصحابها، ولا نجد أي نقد أدبي يستعرضهم كونه نوعاً من النماذج السيئة، ووجود مثل هذه الكتب لن يضيف شيئاً، لأن الهدف من ثقافة اختيار وتحديد الكتاب يعزز ثقافة الشخص، وهو ما نفتقده بوجود كتب خالية من أي هوية تُعرف عنها.
وأرجعت باسمة السبب في ذلك إلى المؤسسات الثقافية، وقالت: السبب الرئيس لهذه الفوضى يعود لعدم مرجعية النشر إلى مكان واحد، فنحن بحاجة إلى جهة تمنح إذناً للنشر، وفق معايير صارمة ودقيقة موضوعة من قبل لجنة خبيرة، واقتراحاتي للحلول تتمثل في أن يكون للنشر مرجعية واحدة، بحيث يكون هناك قانون للنشر يحدد نوع الكتاب، ويوجه بضرورة وجود تصنيف له، ولو كان الكتاب لا ينتمي لأي تصنيف يجب رفضه وتوضيح سبب الرفض، ولو رغب الكاتب بإعادة الطباعة، فعليه إعادة تصنيف كتابه من جديد، وتوضيح وجهة نظره في إعادة الطباعة، على أن يتولى مسؤولية التدقيق على كل ذلك فريق مدرب على تنفيذ هذه المعايير، وبرأيي أنه لو تم التعامل بجدية مع هذا الأمر سيكون تطبيقه سهلاً بعد ذلك، وستخجل أي مؤسسة في نشر أي محتوى خال من القيمة، يظهرها بأنها رديئة أمام هذه المعايير والعمل الدؤوب.
ولفتت إلى أن الكتب التي تدخل الساحة لن تخرج بسهولة منها، وقالت: أي كتاب ينشر يدخل التاريخ، وستتأسس على هذه الأصناف والنوعيات من الكتب أجيال وأجيال، وهو ما يجعل من الضروري أخذ الموضوع بعين الاعتبار، والتعامل معه بجدية.
بدايات
أشارت مريم الشناصي إلى أن معظم الناشرين في الإمارات بدأوا بدايات متواضعة، وقالت: لا نزال في الخطوات الأولى من النشر، وسبقتنا دول كثيرة في هذا المجال، وبشكل عام هناك تدهور في نشر بعض الأجناس كالشعر، كما أثرت التكنولوجيا وسهولة تحميل الكتب إلكترونياً سلباً على النشر.
جدلية قائمة وثورة على القيود
سؤال الأجناس الأدبية قديم قدم الأدب نفسه، فقد نشأ في حضن الأدب، ليجيب عن أسئلته، وجدلية الجنس الأدبي قديمة ومعاصرة، فقد ثار الفيلسوف الفرنسي موريس بلانشو على نظرية الأجناس الأدبية، ليكتب في أواخر منتصف القرن العشرين «لم يعد هناك كتاب ينتمي إلى جنس، كل كتاب يرجع إلى الأدب الواحد، ومن ثم فهو بعيد عن الأجناس وخارج خانات النثر والشعر والرواية والشهادة، يأبى أن ينتظم تحت كل هذا أو يثبت له مكانه ويحدد شكله».
في حين طالب الناقد الفرنسي رولان بارت بإلغاء الحدود الموجودة بين الأجناس الأدبية، وكتب «إن النص لا ينحصر في الأدب الجيد، إنه لا يدخل ضمن تراتب، ولا حتى ضمن مجرد تقسيم للأجناس، ما يحدده على العكس من ذلك هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة».
ولا يزال الجدل قائماً حتى اليوم، فالكتابات الإبداعية المعاصرة، سواء في الثقافة الغربية أو العربية، بدأت في خلخلة الجنس الأدبي وتحطيم معاييره النوعية ومقوماته النمطية باسم الحداثة والتجريب. فأصبحنا نرى القصيدة النثرية التي يتقاطع فيها الشعر والنثر، والقصيدة الدرامية التي ينصهر فيها الشعر والحوار المسرحي معاً، كما أصبحت الرواية عالماً تتمازج فيه النصوص وتتداخل فيه الخطابات والأجناس المختلفة.
كما اهتم النقاد والدارسون المحدثون والمعاصرون بنظرية الأجناس الأدبية تأريخاً وتعريفاً وتنظيراً وتطبيقاً، ومنهم طه حسين الذي أعاد النظر في تقسيم القدماء للكلام العربي إلى شعر ونثر، وذلك في كتابه: «من حديث الشعر والنثر»، إذ ميز بين الشعر كجنس أدبي مستقل، وقسم الأجناس النثرية إلى قسمين رئيسيين، وهما: الخطابة والنثر الفني. كما خصص الباحث المغربي عبد الفتاح كليطو نظرية الأجناس الأدبية بفصول متميزة ومركزة في كتابه: «الأدب والغرابة».
الأجناس الأدبية ضابط إيقاع النص
يعد الجنس الأدبي معياراً تصنيفياً للنصوص، يعمل على ضبط إيقاع النص، وتحديد مقوماته ومرتكزاته وبنياته الدلالية والفنية والوظيفية، وتكمن قوة الجنس الأدبي في قدرته على تأطير شكل النص، والحفاظ على النوع الأدبي، ورصد تغيراته الجمالية، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام أهل الأدب، فكان من أبرز القضايا التي انشغلت بها الساحة، ذلك لأن معرفة قواعد الجنس الأدبي تساعد على إدراك التطور الجمالي والفني والنصي، وتطور التاريخ الأدبي باختلاف تطور الأذواق وجماليات التقبل والتلقي.
وفي الحقل العربي، تم الاهتمام بتأريخ الأجناس والفنون والأنواع والأنماط الأدبية عبر تعريفها، وتحديد مرتكزاتها ومكوناتها وسماتها، ومن أبرز الدراسات في هذا الجانب كتاب «مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية لرشيد يحياوي، وكتاب«الأدب وفنونه» لمحمد مندور.
أحمد العامري: محاولة حصر الإبداع حُكمٌ عليه بالموت
أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب لـ "البيان"، أن قضية تجنيس الأعمال الإبداعية، وتصنيفها وفق الأجناس المعروفة؛ قصة كانت أو رواية أو قصيدة أو غيرها، قضية لاحقة للإبداع وليست سابقة له، بمعنى أن بدايات القصة القصيرة - مثلاً- كانت شكلاً ابداعياً بلا هوية، ثم تطورت، وظهر لها مُنظرون ونقّاد ورواد، وبالتالي صار لها شروطها ومعاييرها، التي يتم الالتزام بها اليوم لتُطلَق على الأعمال السردية القصيرة اسم قصة.
وأضاف: الأمر ذاته ينطبق على الرواية، والقصيدة والعمل المسرحي واللوحة، وغيرها من الأعمال الإبداعية، إذ تمر هذه الأجناس أو الأصناف بمراحل عدة، لتنضج وتأخذ شكلها، وترسو معالمها، الأمر الذي يعيدنا إلى الأسئلة المركزية في الإبداع، والمتمثلة في: ما الذي يجعلنا نتفق على جمال نص أو لوحة ولحن؟ وما الذي يدفع المبدع للتعبير عن شواغله، وأسئلته، بهذه الأشكال الجمالية؟، لذلك لا يمكن لنا حصر الإبداع في قوالب جاهزة، واعتبار ما ينتج خارجها عملاً منزوع الهوية، أو عملاً تخريبياً في الأدب أو الفن أو الموسيقى، لأن أي محاولة لحصر الإبداع وتحديد مساراته، يعني الحكم على الفنون والآداب بالموت، وبالتالي غياب أي فرصة لإمكانية استحداث فن أو جنس إبداعي جديد.
وأكد العامري أن هذا الواقع يفرض علينا واجبات مثلما يقدم لنا حقوقاً، فكما يحق لنا نقد الأعمال ورفضها وعدم تقبلها، يجب علينا تحمل حجم التجريب الحاصل في الأعمال الإبداعية إلى أن تنضج وتأخذ شكلها، وتتفق عليها ذائقة الجمهور، ومن ثم يصبح لها معايير وشروط تضبط شكلها وبناءها.
وأضاف: ربما تكون قصيدة النثر في الحراك الثقافي العربي المعاصر، واحدة من أكثر النماذج وضوحاً فيما يتعلق بالتصنيف الحاصل، فحين ظهرت عربياً في خمسينيات القرن الماضي لاقت الكثير من الرفض والهجوم، للحد الذي اعتبرها البعض تخريباً للثقافة والشعر العربي، ولكن المعاين اليوم لتجربة قصيدة النثر يجد أنها قدمت أسماءً كبيرة للشعر العربي المعاصر، وكشفت عن أجيال مبشرة من الشعراء الجدد.
وأنهى حديثه بالقول: يؤكد هذا أن العلاقة بين تصنيف الأعمال الإبداعية والنشر وذائقة الجمهور، تحتاج إلى مرونة وتقبل جميع الأطراف، وليس هناك أهم وأكثر فاعلية من التاريخ ليرسخ الأصيل والجميل ويمحو العابر والرديء.
انطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين عام 2009، عقب مؤتمر عن حقوق الطبع الذي أقامه اتحاد الناشرين الدوليين في أبوظبي، حيث برزت الحاجة الماسّة خلاله لوجود جهة جامعة تستطيع تمثيل صناعة النشر في الإمارات، واجتمع بعض الناشرين كخطوة أولى لوضع الأسس التمهيدية لإنشاء هذه الجمعية، التي انطلقت وأصبح لها اليوم حضور كبير وفاعل مع عضوية أكثر من 100 دار نشر إماراتية.
وقد تأسست الجمعية بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للجمعية، بهدف خدمة وتطوير قطاع النشر في الدولة، والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته.
وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بالدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني للإعلام والجهات المعنية بالنشر في الدولة، إضافة إلى العديد من الجهات الشريكة في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والعالم.
650
تشير الإحصاءات التي طرحت أخيراً خلال مؤتمر دبي الدولي للنشر، الذي أقامة المجلس التنفيذي في دبي، بالتعاون مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، إلى أن إجمالي ما يتم تداوله في قطاع صناعة النشر بالدولة، مرشح للوصول إلى نحو 650 مليون درهم في العام 2030، ارتفاعاً من 233 مليوناً، هو واقع ما تستحوذ عليه تلك الصناعة في الوقت الحالي.
وكانت دراسات سابقة قد أوضحت أن الإمارات تُصَدِّر ما نسبته 83% من إجمالي الكتب العربية إلى أميركا اللاتينية سنوياً، وهذا ما يُحفز على تطوير صناعة النشر في الدولة، وجميع الدول العربية.
وتقدر قيمة صادرات الكتب من أميركا اللاتينية إلى الدول العربية بـ59,314 دولاراً أميركياً فقط، حيث إن 80% من إجمالي هذه الصادرات يتوجه إلى كل من الإمارات، والسعودية، والكويت، والجزائر، ولبنان، والأردن.
على الرغم من جملة التحديات التي تواجهها صناعة النشر في الإمارات، فإن الإحصاءات التي نشرت أخيراً بينت أن عوائد صادرات الكتب بالدولة ارتفعت حالياً لتصل إلى 4 ملايين درهم، في حين تضاعفت آلية النشر الحالية، مقارنة بفترة ما قبل إعلان الاتحاد، وتحديداً، حسب الإحصاء المشار إليه في العام 1970، من خمسة كتب إلى 500 كتاب، بما يوازي تضاعفاً بنسبة 100 مرة، ما يعكس تطور صناعة النشر في الدولة بشكل ملحوظ.
90 %
النشر العربي مظلوم مقارنة بالنشر الغربي، فالناشر الغربي تُختزل جهوده في عملية النشر فقط، بينما العربي يقوم بكل أدوار وأطوار عملية النشر.
والمقارنة بين الناشرين العربي والأجنبي، جائرة كون الناشر الغربي يجد دعماً من حكومته والمؤسسات في دولته، بينما نظيره العربي يعتمد بنسبة 90% من مردود التوزيع على القارئ، و10% على المؤسسات.
كما تمثل القيود الرقابية التي تفرضها بعض الحكومات على العديد من الكتب، فضلاً عن ارتفاع أجور الشحن والتوزيع، بما في ذلك أسعار حجز مساحات ضئيلة في معارض الكتب المختلفة، عائقاً إضافياً.
يضم اتحاد الناشرين الدوليين 65 عضواً في الوقت الحالي، يغطون أغلب مناطق العالم، بينهم الإمارات التي شكل حضورها في الاتحاد موطئ قدم للوجود العربي القوي، والاطلاع على طبيعة النشر في المنطقة وطبيعة القارئ أيضاً.
ويضع الاتحاد في أولوياته نقاطاً عدة، أهمها ما يتعلق بمسائل حقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة بكل أشكالها ومهما كان مصدرها، إضافة إلى التزام أعضاء الاتحاد بمبدأ الدفاع عن حرية التعبير والنشر. ويتخذ الاتحاد الذي تأسس في 1896 في العاصمة الفرنسية باريس، من مدينة جنيف السويسرية مقراً له.
شارك في الدورة الأخيرة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب التي عقدت في نوفمبر الماضي، 1420 دار نشر من 60 دولة، عرضت 1.5 مليون عنوان، منها 88 ألف عنوان جديد على مساحة بلغت 25000 متر مربع، وسجلت الإمارات فيه أعلى نسبة مشاركة، إذ بلغت 205 مشاركات، تلتها مصر بـ163 مشاركة، ولبنان بـ110 مشاركات، ثم الهند 110، وبريطانيا 79، وسوريا 66، والسعودية 61، وأميركا 63
albayan.ae