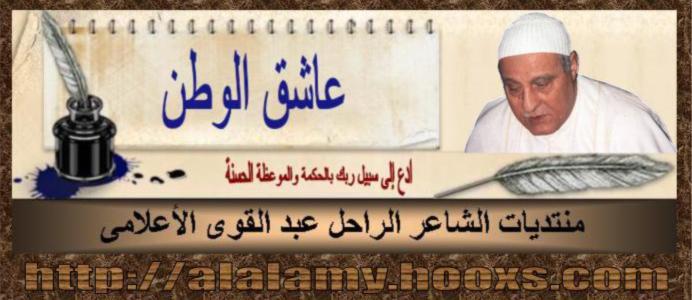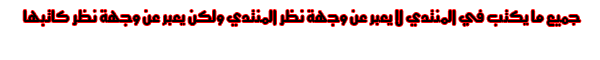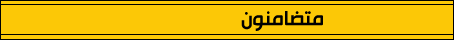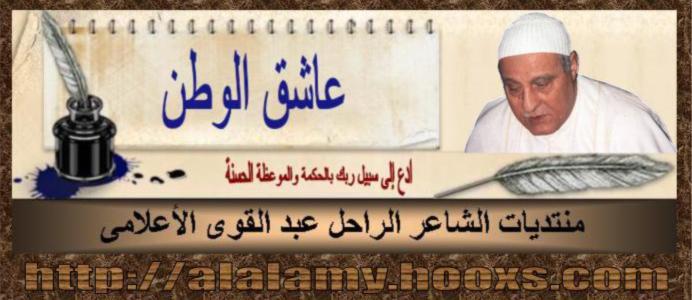
|
|
| |
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
سامح الغندور
عضو فعال

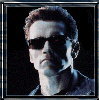

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:25 23/11/2010, 01:25 | |
| القدس : تاريخ و وثائق  تاريخ القدس منذ الفتح العربي تاريخ القدس منذ الفتح العربي(1) بيت المقدس عين القلب من العالم الإسلامي جغرافياً ودينياً الدعاية الصهيونية في العالم تزعم علاقة خاصة لليهود بالمدينة دخلها العرب في الألف الرابعة قبل الميلاد وفتحها الخليفة عمر سلما فأسلمت وتعربت قدس برس (الدكتور/ أحمد صدقي الدجاني)هذا حديث عن الفتح العربي لمدينة القدس , وهو يأتي في وقت تشتد فيه الحملة الصهيونية الاستعمارية على القدس , لاستكمال اغتصابها وتهويدها ، وفي وقت تستكمل انتفاضة الأقصى فيه عاماً كاملاً , دفاعاً عن القدس , وسعياً لتحريرها وتحرير فلسطين . وقد تضمنت تلك الحملة الشريرة محاولة الصهيونية تزييف تاريخ القدس , بتقديم قراءة صهيونية له , تتحدث عن ارتباط القدس باليهود دون غيرهم ، وتطرح عدداً من المقولات الصهيونية بشأنه . وقد فصلنا الحديث عن هذه الحملة في بحوثنا وفندناها . وصادفنا ونحن نكتب هذا الحديث كتاب "لمن القدس Whose Jerusalem" لتيرنس بريتي "Terrence Prittie", وبتقديم تيدي كوليك ، مثلاً آخر على الدعاية الصهيونية , التي تتحدث عن "العاصمة الأبدية", وتحاول أن تنفي عروبة القدس . وكان الغرب قد شهد منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي حركة تأليف تاريخي صهيونية استعمارية , موّلها صندوق استكشاف فلسطين ، قدمت صورة مشوهة لتاريخ فلسطين . كما تضمنت الحملة الصهيونية الاستعمارية على القدس محاولة اغتصاب الحرم القدسي خاصة , التي تولى كبرها في مفاوضات الوضع النهائي (رئيس الوزراء الصهيوني السابق) إيهود باراك و(الرئيس الأمريكي السابق) بيل كلينتون صيف 2000 ، ثم تابعها آرائيل شارون وجورج بوش في هذا العام . وهاهي الأحداث تتصاعد في القدس وفلسطين ، ثم في أمريكا والعالم بعد يوم الثلاثاء 11 أيلول (سبتمبر) 2001 , الذي شهد زلزلة الهجوم على نيويورك وواشنطن , التي استهدفت رمزي السلاح والمال فيهما "البنتاجون ومركز التجارة الدولي" . ما نود التأكيد عليه فيما يتصل ببعد المكان , الموقع المتميز من أرض فلسطين , الذي قامت عليه مدينة القدس , الذي جعل منها "صرة الوطن المقدس, وملتقى أقطاره" , على حد قول إسحاق موسى الحسيني في كتابه عروبة بيت المقدس . ولهذا الموقع أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لجميع "الحواضر" في منطقتنا عواصم الأقطار . وقد شاء الله أن يجعل أهل القدس وفلسطين , من خلال هذا الموقع , في رباط إلى يوم القيامة . وبيت المقدس في منظور الجغرافيا السياسية هو أيضاً "عين القلب من العالم الإسلامي جغرافياً ودينياً" , على حد تعبير عالم الجغرافيا السياسية جمال حمدان في كتابه "العالم الإسلامي اليوم" . فالصلة وثيقة بين القدس ودائرتها الحضارية . والخطر الذي يتهددها يتهدد هذه الدائرة بعالميها العربي والإسلامي . نشير أيضاً إلى أن هذا الموقع جعل فلسطين حلقة اتصال بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا ، ومركزاً لتفاعل الثقافات . وقد اتصف الوضع الجغرافي لفلسطين وبلاد الشام عامة , بتجاور السهل مع الجبل , والصحراء والغور , وتتالى الفصول الأربعة . واحتوت فلسطين على نمطي البداوة والحضارة ، مما جعلها مسرح تفاعل متواصل بين النمطين , فيه التعاون غالباً والتدافع أحياناً . كما جاورت فلسطين منذ فجر الحضارة أقدم مركزين حضاريين عرفهما الإنسان في بلاد الرافدين شرقاً , وفي وادي النيل إلى الجنوب الغربي ، وتعرضت في الوقت نفسه لتأثيرات من جهة البحر المتوسط , حيث كريت واليونان وإيطاليا ، ومن جهة البر حيث فارس والهند شرقاً . وكانت بفعل ذلك جزءاً من طريق دولي قديم . وقد كانت القدس قبلة ومحجاً للمؤمنين منذ تأسست على هضبة ممتدة مرتفعة عن سطح البحر , بحوالي 750 متراً , وعلى بعد 50 كم منه , في مرتفع الضهور , على مقربة من عين الماء جيحون . بقى أن نقول إننا في تناولنا لتاريخ القدس منذ الفتح العربي , وإلقاء أضواء عليه ، سوف نبدأ بتقديم حدث الفتح العظيم , ونوليه حقه من التفصيل ، ثم نعرض بإيجاز لتاريخ القدس في المراحل التالية من الحكم العربي الإسلامي فيها , ضمن دولة الخلافة , حتى وقوع الغزو الفرنجي ، ثم نقف أمام هذا الغزو وما حدث للقدس أثناءه ، لنتابع عرض المراحل التالية من تاريخها العربي الإسلامي، وصولاً إلى الوقوف أمام الصهيونية الاستعمارية لها منذ القرن التاسع الميلادي ، الثالث عشر الهجري . بانطلاقة العرب المسلمين بدعوة الإسلام في القرن السابع الميلادي , الأول الهجري في عصر الفتوحات الإسلامية ، دخلت القدس وما حولها مرحلة جديدة من تاريخها الممتد . كان ذلك في عهد دولة الخلافة الإسلامية , التي قامت في المدينة المنورة , إثر هجرة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها . وقد دخلت فلسطين ، كجزء من بلاد الشام ، هذه الدولة , بعد معركة اليرموك الفاصلة سنة 13 هـ ، 633م . وصولح على إيلياء (القدس) سنة 15 هـ ، 635 م في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبقيت فلسطين والقدس تحت ظل الخلافة الإسلامية حتى آخر عام 1917, بغض النظر عن مركز الخلافة , أو أن يكون الخليفة أموياً أو عباسياً أو عثمانياً . وتعرضت في عام 1099م للغزو الفرنجي لمنطقتنا , الذي تم القضاء عليه عام 1187م ، على مدى حوالي قرنين (493هـ - 583هـ) ، ثم في القرن العشرين الميلادي , حين تعرضت للغزو والاستعمار الصهيوني , في القرن الرابع عشر الهجري , ولا تزال ترزح تحت وطأته . كان ذلك الفتح عربياً إسلامياً . وقد سبقه بقرون الوجود العربي في فلسطين والقدس , منذ أن اعتُمرت فلسطين بالكنعانيين العرب , الذين قدموا من الجزيرة العربية في الألف الرابعة قبل الميلاد , وتلاهم العموريون والأراميون في هجرات متتابعة , ومنذ أن أسست قبيلة يبوس العربية الكنعانية مدينة القدس , حوالي سنة 3000 ق.م. كما يقول عارف العارف في كتابه "المفصل في تاريخ القدس" . وقد نهج عدد من المؤرخين الثقاة العرب والأجانب في الربط بين الهلال الخصيب وشبه جزيرة العرب , التي كانت مركز طرد سكاني . وهذا ما دعاهم إلى أن ينبهوا إلى "أن الفتح العربي الإسلامي سبقه فتح عربي من قديم العصور والأزمان" . كان عرب الجزيرة العربية , الذين قاموا بهذا الفتح يعرفون جيداً "أدنى الأرض" , أي أقربها إلى الحجاز ، وهي فلسطين في جنوب سوريا . وكانوا قد تابعوا الحرب , التي جرت هناك بين الفرس والروم , في مطلع البعثة المحمدية , وأشار إليها مطلع سورة "الروم" في القرآن الكريم . وتعوَّد تجَّارهم القيام برحلة الصيف إلى بلاد الشام شمالاً . وكانت محطتها الكبرى في البتراء عاصمة الأنباط . ومنها كانت القوافل تتجه إلى دمشق وإلى غزة , التي توفي فيها هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويذكر عبد اللطيف الطيباوي في كتابه "القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام" أن عمرو بن العاص ، أحد تجار مكة ، عرف جنوب فلسطين حتى بيت المقدس , قبل أن يعرفها قائداً للجيش الإسلامي الذي حاصر تلك المدينة . وقد فصّل نبيه عاقل الحديث عن الوجود القبلي العربي في بلاد الشام قبل الإسلام ، والصلات التي قامت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم ، وذلك في بحثه القيم في الموسوعة الفلسطينية "فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي" . وتذكر كتب تاريخ العرب اسم فلسطين , الذي اتخذه الرومان للقسم الجنوبي من سوريا , واسم "إيلياء" عند الكلام عن الروم , أو بيت المقدس عند الكلام عن المسلمين . قبيل هذا الفتح رفع الله شأن بيت المقدس حين أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . و أنزل عليه في ليلة الإسراء ، كما ورد في تفسير الطبري ، آية من سورة الزخرف هي الوحيدة , التي لم تنزل في مكة أو المدينة . وهي "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون" , وذلك بعد أن لقيهم وصلّى بهم إماماً قرب الصخرة المشرفة . وسمي محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى واحداً من المساجد الثلاثة , التي يشد إليها الرحال ، مع المسجد الحرام ومسجده . وقد روي عنه أنه بشَّر الصحابي معاذ بن جبل بفتح بلاد الشام وبيت المقدس ، ووصف الذين يقيمون فيها من الرجال والنساء بأنهم "مرابطون إلى يوم القيامة . فمن احتل ساحلاً من سواحل الشام وبيت المقدس ، فهو في جهاد إلى يوم القيامة" . كما بشَّر شداد بن أوس بهذا الفتح أيضا ، وقال له "وتكون أنت وولدك أئمة بها إن شاء الله" , كما يورد عارف العارف في كتابه , نقلاً عن "مثير الغرام بفضائل القدس والشام لابن سرور" . وتروي السيرة النبوية العطرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهَّد لفتح الشام والقدس بقيامه بثلاث من الغزوات على الروم , في معركة مؤتة 629م - 8هـ , ومعركة تبوك ، ثم جهَّز في السنة الحادية عشر للهجرة 632م جيشاً أمَّر عليه أسامة بن زيد ، ولكن المنية وافته قبل أن يتحرك الجيش . بات فتح بيت المقدس من أهم أهداف الدولة الإسلامية . وجاء في المرحلة الثالثة من مراحل فتحها بلاد الشام . فقد أكمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم , وأرسل الجيش بقيادة أسامة وزوده بالنصيحة "لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام فرّغوا أنفسهم في الصوامع , فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له" . ثم استنفر أبو بكر العرب ، وجهّز أربعة جيوش لفتح بلاد الشام , خصص واحداً منها لفلسطين بقيادة عمرو بن العاص . ونجح عمرو بن العاص في فتح معظم أرض فلسطين , غزة وسبسطية ونابلس ، ثم اللد ويُبنى وعمواس وبيت جبرين و يافا و رفح ، ثم حاصر القدس . وحين تولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد وفاة الصديق عام 13 هـ , أوعز إلى أبي عبيدة بن الجراح , بعد أن فتح قنسرين في شمال سورية ، أن يزحف إلى القدس ، وسيّر إلى الشام سبع فرق , بخمسة وثلاثين ألفاً من الجند , وسبعة قواد هم خالد بن الوليد و يزيد بن أبي سفيان و شرحبيل بن حسنة و المرقال بن هاشم و قيس بن المرادي و عروة بن مهلهل بن يزيد الخليل . تضمن كتاب الفتوحات تفاصيل كثيرة عن فتح القدس والشام ، لا يتسع مجال هذا الحديث لذكرها . ونكتفي هنا بالإشارة , بشأن فتح القدس , إلى أن أبا عبيدة حين وصل إلى الأردن , بعث الرسل إلى أهل إيلياء برسالة الفاتح المسلم المتضمنة الدعوة إلى الإسلام وأخوَّته , "فإن شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم ، وكنتم لنا أخواناً" ، أو الإقرار بأداء الجزية ، أو القتال . وقد وقع القتال من قبل جيش الروم المرابط في المدينة . ونشبت معركة دامية حتى اليوم العاشر . "وفي اليوم الحادي عشر أشرقت راية أبي عبيدة ، وفي رفقته عبد الرحمن بن أبي بكر ، ونفر من الأبطال المجاهدين , فاستقبله المسلمون بالتهليل والتكبير , فدب الرعب في قلوب الروم . ودام الحصار أربعة شهور .. فرأوا التسليم , وخرجوا إلى أبي عبيدة مستأمنين , يتقدمهم البطريرك صفرنيوس , حاملاً على صدره الصليب ، وعلى جانبيه القسس والرهبان , كل منهم يحمل إنجيلاً ، فطلبوا الصلح ... فتلقاهم أبو عبيدة بالترحيب . واشترطوا أن لا يسلموا المدينة إلا لشخص الخليفة فوافقهم .. فسارت هدنة استمرت إلى أن جاء عمر بن الخطاب ، كما أورد عارف العارف , وهو يشير إلى كتاب "تاريخ القدس الشريف" لركيس . ويورد العارف أيضاً كتاب ابن عبيدة إلى الخليفة ، ومشاورة عمر الصحابة ، وأخذه برأي علي بن أبي طالب بالسفر ، ونزوله بالجابية من قرى حوران بالجولان , واستقباله فيها وفداً من أهل إيلياء , على رأسهم "العوام" ، وتوجهه من ثم إلى بيت المقدس ليتسلمها "صلحاً" . يصف ميخائيل مكسي في كتابه "القدس عبر التاريخ" كيف وصل الخليفة "ممتطياً جملاً صغيراً ، ولم يكن معه سوى عبده وسلاحه ، واستقر على جبل الزيتون , ثم رحل إلى القدس ، ففتحت له المدينة أبوابها سنة 638 م ، دون أن يتم تدمير أي شيء فيها ، وتسلم مفاتيحها من البطريرك صفرنيوس في حفل كبير ، ثم زار كنيسة القيامة . وتجمع كل المصادر التاريخية الإسلامية والمسيحية على أنه لما حان موعد الصلاة طلب منه البطريرك أن يؤديها حيث كان , فاعتذر عمر حفاظاً على المقدسات المسيحية , كي لا تكون صلاته هناك سنة لمن يجيء بعده . ولهذا اختار مكاناً آخر إلى الجنوب , وصلى هناك , وذلك نقلاً عن مار ماردش . وقد فصّل العارف وصف دخول عمر إلى بيت المقدس , نقلاً عن المؤرخين العرب المسلمين . وأعطى عمر البطريرك صفرنيوس "العهدة العمرية" , التي جاء فيها بعد البسملة: "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان . أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم , أنه لا تُسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها .. ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم . ولا يسكن إيلياء أحد من اليهود". وتضمنت أيضاً أن على أهل إيلياء أن يخرجوا من المدينة الروم واللصوص، "فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم" , ومن كان فيها من أهل الأرض , فمن شاء منهم قعد ، وعليه ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء من الجزية حتى يحصدوا حصادهم" . ويفسر الطيباوي عبارة أهل الأرض بأنهم الفلاحون , الذين التجأوا إلى المدينة قبل حصارها . وهو يلاحظ أن الوثيقة تفرق بين طائفتين من الناس: الروم وأهل البلاد . فأما الروم فهم حكام غرباء , عليهم أن يخرجوا . وأما أهل البلاد , الذين كانوا نصارى , يحكمون الآرامية من الجنس العربي , فهم باقون في بلادهم , مع ضمان الحرية الدينية , وسلامة الأرواح والأموال والكنائس . وقد وضعت هذه الوثيقة نواة الاستقلال الطائفي "الملي" , الذي قدر له أن يكون أساس السماحة الإسلامية مع أهل الكتاب , الذين صالحوا المسلمين . قام عمر بزيارة مكان الصخرة المشرفة ، وكانت قد تجمعت عليها الأقذار ، مما طرحته الروم إغاظة لليهود . "فأخذ الخليفة ينظفها هو بنفسه ، فحذا حذوه من كان معه من الصحابة والقواد وغيرهم , حتى رفعت الأقذار" . ويتابع مصطفى مراد الدباغ في كتابه "بلادنا فلسطين" قائلاً : "ثم أمر عمر ببناء الحرم ، فبني من الخشب ما يتسع لحوالي ثلاثة آلاف من المصلين" . وهو ينقل عن ابن البطريق وصفه لما حدث ، ويذكر أن أمير المؤمنين أقام في بيت المقدس بضعة أيام , متفقداً معالمها , باحثاً شؤونها , قبل أن يغادرها راجعاً إلى المدينة المنورة . وقد خطب في الناس وصلى ، وعيَّن يزيد بن أبي سفيان عاملاً على إدارتها تحت إمرة أبي عبيدة . وعيِّن سلامة بن قيصر إماماً للصلاة ، وعلقمة بن مجزر مشرفاً على شؤونها العسكرية , كما جاء في "الأنس الجليل في تاريخ مصر والخليل" . ويذكر عارف العارف عن هذا المصدر أن عمراً , كما أعطى أهل إيلياء عهداً ، أخذ عليهم عهداً . كما يذكر أنه زار القدس مرة أخرى عام 17هـ ، 639م في عام الرماد الشهير وطاعون عمواس . ويختم ميخائيل مكسي عرضه لهذه الصفحة من تاريخ القدس بالحديث عن سماحة الحكم الإسلامي , ويورد شهادة أرنولد في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" , وما نقله توماس المرجا عن أحد البطاركة عن معاملة العرب الحسنة , وعن مودتهم للنصرانية . ويقول "و الخلاصة أن الحكم الإسلامي دخل إلى القدس مصحوباً بالتسامح والسلام والنظام .. وأكد كثير من الكتاب الغربيين أن فلسطين ازدهرت في بداية العصر العربي ، وصارت أهم طريق للقوافل , بسبب موقعها في وسط الدولة الإسلامية في الشام وشمال إفريقيا" . ولم يتغير وضع السكان إلا قليلاً . فقد هاجر عدد من الإغريق , وحل محلهم العرب المسيحيون والمسلمون , وخلت المدينة المقدسة من اليهود في تلك الفترة . وعنى المؤرخون العرب المسلمون بذكر أسماء جميع الصحابة , الذين اشتركوا في فتح بيت المقدس . إن لنا في ختام هذا الحديث عن فتح العرب المسلمين لبيت المقدس في 20ربيع الأول 15هـ الموافق 2 أيار (مايو) 632م ، أن نلاحظ أن المدينة المباركة و فلسطين و بلاد الشام والمنطقة دخلت بهذا الفتح مرحلة جديدة من تاريخها الطويل ، تأكدت فيها عروبتها ، وانتشرت وعمت فيها رسالة الإسلام ، وقامت فيها حضارته . وبقيت القدس في هذه المرحلة فلسطينية عربية كما كانت ، واستمرت مركزاً روحياً للمؤمنين ، ومطمعاً للغزاة الطغاة الباغين . نلاحظ أيضاً أن أهل القدس و فلسطين و بلاد الشام عامة تعاطفوا مع هذا الفتح . وقد علل فيليب حتّي ذلك بقوله "وغالب الظن أن السوريين من أبناء القرن السابع , اعتبروا العرب المسلمين أقرب إليهم عنصراً ولغة ، وربما ديناً من أسيادهم الروم البيزنطيين" , وذلك في كتابه "تاريخ سوريا و لبنان و فلسطين" . وتذكر كتب الفتوحات أن اليهود عبروا بقوة عن هذا التعاطف , ليتخلصوا من اضطهاد الروم لهم , بسبب وقوفهم قبل ذلك مع الفرس . وقد أورد البلاذري أن السامرة "كانوا عيوناً وأدلاء" للعرب المسلمين ، وأن يهود حمص قاموا بحراسة أبواب المدينة , حين خرج منها جيش المسلمين للالتحاق بمعركة اليرموك , "وكذلك فعل أهل المدن , التي صولحت من النصارى واليهود" . |
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

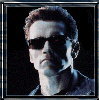

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:26 23/11/2010, 01:26 | |
| تاريخ القدس منذ الفتح العربي
(2)
تاريخ القدس منذ الفتح وحتى الغزو الفرنجي
عاش اليهود فيها بأمان وبرز منهم كتاب وعلماء كبار في الدولة الإسلامية
تلقى فيها الخلفاء المسلمون البيعة وألزموا عمالهم بزيارتها وجاور فيها علماؤهم
غدت فلسطين بعد الفتح العربي الإسلامي إقليماً تابعاً للدولة الإسلامية في المدينة , يحمل اسم جند فلسطين . وحين نشبت الفتنة الكبرى في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان , كان معاوية بن أبي سفيان والياً على الشام ، واعتزل عمرو بن العاص الفتنة في ضيعة له بالسبع , هي عجلان , قرب قرية بربرة شمال شرق غزة . وبقيت فلسطين مع بقية بلاد الشام تحت حكم معاوية زمن خلافة علي بن أبي طالب .
حين آل أمر الخلافة إلى معاوية بعد معركة صفين ، استهل عهده بالذهاب إلى بيت المقدس, حيث أعلن خلافته منها عام 40هـ - 661 م , ومن ثم بايعه الناس . وروي أنه بعد مبايعته زار جبل الجلجلة , وصلى هناك , ثم قصد إلى الجثمانية , وهبط إلى قبر السيدة مريم وصلى هناك . وقد زار القدس في عهده الأسقف الفرنسي أركولفوس حاجاً عام 760 م , وقضى فيها تسعة شهور , وكتب وصفاً مسهباً لكنيسة القيامة والكنائس الأخرى ، وذكر أن المسلمين بنوا مسجداً مربع الأضلاع , يتسع لثلاثة آلاف من المصلين .
كان من أهم ما قام به الأمويون بناء الحرم القدسي الشريف ، في بقعة مقدسة منذ القديم , تعود إلى نشأة المدينة . ويتألف هذا الحرم من المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وما بينهما وما حولهما من منشآت , على مساحة 140900 متراً مربعاً . وقد بناها عبد الملك بن مروان عام 66هـ - 685م ، وأوقف على نفقاتهما خراج مصر لمدة سبع سنين . واكتمل بناء بقية الصخرة سنة 70هـ - 691م . ويسهب المؤرخون القدماء والحديثون عرباً وأجانب في وصف تكوينه الرائع , الذي جاء آية في فن الهندسة على مر العصور . وقد سجل الدباغ والعارف في كتابيهما العديد من الشهادات على ذلك .
حفظ التاريخ لعبد الملك بن مروان أنه حوّل الدواوين إلى العربية ، ونقش الدراهم والدنانير بالعربية ، "الله أحد" على وجه و"الله الصمد" على الوجه الآخر . ويذكر أنه اعتنى بفتح الطرق وتعبيدها .
وهنا ازدهرت القدس في عهده وعهد ابنه الوليد . وغدت - على قول الدباغ - "واحدة من المراكز العظيمة في الدولة الأموية . ففضلاً عن إقامتهما مباني الحرم الشريف , فإنهما أعادا بناء الأسوار المحيطة بالمدينة , وبنوا القصور والأبنية الفخمة بجوار الزاوية الجنوبية لسور الحرم , التي استمرت مسكونة من قبل أمراء القدس في العهود الأموية والعباسية والفاطمية .
وحين ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة بعد أخيه الوليد سنة 96هـ - 715م ، أتى بيت المقدس , كما يقول صاحب "الأنس الجليل" ، "و أتته الوفود بالبيعة , فلم يروا وفادة كانت أهنى من الوفادة إليه .. وقد همَّ بالإقامة في بيت المقدس , واتخاذها منزلاً , وجمع الأموال والناس بها . وحين تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز بعد وفاة سليمان , طلب من جميع ولاته أن يزوروا القدس , ويقسموا يمين الطاعة والعدل في المعاملة بين الناس في مسجدها ، كما يذكر الدباغ نقلاً عن محمود العابدي في كتابه "قدسنا" .
في تتبعنا لأخبار القدس في عهد الدولة العباسية ، نذكر أن الخليفة المنصور زارها عام 154هـ ، وقد طلب منه أهل بيت المقدس ترميم ما أصاب الحرم الشريف من خراب , بسبب زلزال حدث عام 130هـ فقام بذلك . ووضع تقليداً أن يزور كل خليفة عباسي القدس . وقد زارها الخليفة المهدي . وزارها الخليفة المأمون سنة 216هـ وهو في طريقه إلى مصر ، وفق ما ذكره الدباغ عن صاحب "الأنس الجليل" , وهو يعدد ما جاء في الكتب من أخبارها.
وخرج عارف العارف من تتبعه للقدس في العصر العباسي بأن "تأثير العباسيين في فلسطين , ولا سيما في عهدهم الأخير كان ضئيلاً" , وعلل ذلك بسبب بعد المسافة . وعني الطيباوي بتقديم مقتبسات مختصرة من مؤلفات أربعة من الكتاب المسلمين , الذي عرفوا القدس والخليل في ذلك العصر . وهم ابن واضح اليعقوبي , الذي ألف كتاب "البلدان" ، وشمس الدين المقدسي الجغرافي الرحالة ، صاحب كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" ، وناصر خسرو الرحالة الفارسي , الذي وصل القدس في رمضان 438هـ - 1047م ، وأبو حامد الغزالي الذي زار القدس والخليل , وكتب "المنقذ من الضلال", الذي تحدث فيه عن اعتكافه في مسجد قبة الصخرة . وقد التفوا جميعهم على الإشادة بفضائل بيت المقدس . واستنتج الطيباوي مما كتبوه عنها "وجود أوقاف فيها وفي الخليل , كان يصرف ريعها على الحجاج وطلاب العلم والضيوف . وكذلك وجود بيوت وزوايا لإيواء القادمين للمجاورة , أو المارين في طريقهم إلى مكة , أو العائدين منها . وأيضاً وجود مستشفى واحد على الأقل في القدس , لمنفعة المقيمين والقادمين" .
أعلام مرموقون ولدوا في القدس أو زاروها أو جاوروها . وقد قام مصطفى الدباغ بذكر أربعين علماً في موسوعة "بلادنا فلسطين" . وعني أيضاً مع مؤرخين آخرين بذكر من زار القدس من الرحالة الأجانب . فبعد المطران فرنك أركولف , الذي سبق ذكره ، زارها عام 870م السائح برنارد الحكيم , وكتب عن زيارته , مشيداً بما بين المسلمين والمسيحيين من تفاهم تام ، وباستتباب الأمن ، ومتحدثاً عمن لقي من الحجاج المسيحيين , الذين كانوا ينزلون معه في نزل أسسه الملك شارلمان , الذي قامت بينه وبين هارون الرشيد صلات ودية . وقد فصل الحديث عن هذا الرحالة نقولا زيادة في كتابه "رواد الشرق العربي في العصور الوسطى" .
كانت السماحة الدينية أبرز سمات العيش في القدس وفي الدولة الإسلامية عامة ، كما سبق أن ذكرنا . وقد عني ميخائيل مكسي بالوقوف أمام ذلك في كتابه "القدس في التاريخ" ، وقال في ذلك "امتاز العباسيون بحسن معاملة المسيحيين , خصوصاً في عهد هارون الرشيد 786م , الذي سمح للإمبراطور شارلمان بترميم الكنائس , وبناء كنيسة باسم العذراء ، وعمل على حماية الحجاج المسيحيين" .
هذا بشأن المسيحيين من أهل الكتاب , الذين حكم التعامل الإسلامي معهم مبدأ "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" . فماذا بشأن اليهود؟ .
لقد عني كاتب هذا الحديث بتناول هذا الموضوع في بحثه "الوجود اليهودي في القدس منذ أقدم العصور" ، فعرض لوجودهم قبل الغزو الفرنجي منذ الفتح ، في ظل انتمائهم لحضارة الإسلام ، قائلاً :
نستدل من العهدة العمرية على عدم وجود أحد من اليهود في إيلياء في يوم الفتح , حيث طلب أهلها الذين كانوا يدينون بالنصرانية "ألا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود" , وقد استجاب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الطلب , الذي تقدم به باسم أهل إيلياء البطريرك صفرنيوس , وكان هذا البطريرك قد اشترط حين اشتد حصار المسلمين للمدينة أن يسلمها للخليفة نفسه , فلبى عمر وجاء بنفسه , وأعطى عهده الشهير إلى أهل إيلياء من الأمان "لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم , ولا يكرهوا على دينهم , ولا يضار أحد منهم" , ولبّى طلبهم ألا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود , الذين كانوا كما مر بنا قد حالفوا الفرس ضد الروم وآذوا النصارى .
وبقيت القدس خالية من اليهود تنفيذاً لما جاء في هذا العهد فترة من الزمن , لم تطل , لأن الحكم الإسلامي الذي كفل حرية الاعتقاد فلا إكراه في الدين , واحترم أهل الكتاب من اليهود والنصارى , وترك لكل ملة أن تنظم شؤونها الدينية , ورحب بمشاركة جميع الأقوام والملل في الحياة العامة ، سمح لليهود بزيارة القدس , ثم بالعمل فيها وسكناها .
ويذكر إسحاق موسى الحسيني في كتابه "عروبة بيت المقدس" نقلاً عن مجير الدين الحنبلي أن عبد الله بن مروان الأموي أتاح لعشرة من اليهود أن يخدموا صناعاً في المسجد الأقصى , يعملون القناديل والأقداح والثريات وغير ذلك , "لا يؤخذ منهم جزية جارياً عليهم وعلى أولادهم" , وقد انتهت خدمتهم في عهد عمر بن عبد العزيز . ويقول عبد اللطيف الطيباوي في معرض وقوفه أمام هذا الأمر "وكذلك لا يوجد سند تاريخي يثبت نقص ما جاء في العهد العمري لنصارى إيلياء بمنع إقامة اليهود فيها . كلا ، ولا بينة تفسر سبب إهمال العمل بهذا النص , والغالب أن الشرط لم يلغ , بل قلّ الالتفات إليه تدريجياً في جو التسامح العام , وكان هناك عدد من اليهود في مدن فلسطين الأخرى ، عسقلان وقيسارية وغزة وطبرية ، وقد رأوا سماحة الحكم العربي بالإسلام , فرحبوا به , وهللوا له , وكتب عراف يهودي عن هذا الحكم فجعل ملاكاً يقول لكاهن "لا تخف يا بن يهوه فالخالق تبارك اسمه لم يضع مملكة إسماعيل إلا ليخلصكم من هذا الشر" , يقصد حكم الروم البيزنطيين , كما نقل برنارد لويس في كتابه العرب في التاريخ , وكان اليهود يطلقون على دولة العرب المسلمين اسم مملكة إسماعيل .
في ظل هذا الحكم عاش في القدس نفر من اليهود إلى جانب أهلها من النصارى والمسلمين , وقد تزايد عدد العرب المسلمين فيها , لما اتصفت به من جاذبية لهم , بحكم قدسيتها , فجذبت مهاجرين منهم إليها ، ولأن الدين الإسلامي كان ينشر تدريجياً في أوساط المسيحيين واليهود .
وتشير مصادر يهودية اعتمد عليها بن زيون دينور في بحثه المنشور في كتاب "اليهود في أرضهم" , إلى أن سبعين أسرة سكنت القدس في العصر الأموي , وذلك بعد أن عبرت سماحة العرب تجاه الجماعات الدينية عن نفسها في العهد الأموي , على حد قوله , وبوضوح أشد في العهد العباسي . وقد سجل دينور هذه الحقيقة , وحاول إلقاء ظلال من الشك عليها , بإيراد تعليلات غير موضوعية لها , جعلت حديثه حافلاً بالمتناقضات . ويستدل من حديث الرحالة المسلم ناصر خسرو , الذي زار القدس سنة 438هـ الموافق لـ 1047م أن عدد سكان المدينة كان عشرين ألفاً , وأن مثل هذا العدد من الحجاج كان يزورها سنوياً .
استمر الوجود اليهودي في القدس منذ الفتح العربي الإسلامي لها إلى أن احتلها الفرنجة عام 1099م , وفي فلسطين و المنطقة , التي أصبحت تعرف بدار الإسلام عامة ، وساهم في هذا الاستمرار هجرات أفراد من اليهود إلى فلسطين , طلباً للأمن أو العلم , أو بغرض التعبد , سواء من دار الإسلام أو من خارجها . وقد لاحظ باركس في كتابه "تاريخ فلسطين من 135 إلى الزمن الحديث" أن الحكام المسلمين لم يرفضوا في أية فترة السماح ليهود من بلاد أجنبية أن يدخلوا فلسطين , ويقيموا فيها , وبدون هذه الهجرة ما كان لوجودهم أن يستمر , وذلك لأن أعداداً منهم كانت تعتنق الإسلام بكامل رغبتها , وألحق هذا السماح , الذي يشير إليه باركس , لليهود المستأمنين , الذين يأتون مسالمين , وهو نابع من تعاليم الدين الحنيف .
عاش أهل فلسطين والقدس في ظل الحكم الإسلامي التحول العظيم , الذي حدث في القرن الأول الهجري , بفعل نشوء العمران الحضاري العربي الإسلامي , وشاركوا بمختلف مللهم في ازدهار هذا العمران الحضاري , من موقع الانتماء الحضاري إليه . وهذه ظاهرة يوقف أمامها , وقد كانت لها تجلياتها في طابع حياتهم في القدس ودار الإسلام . ومن الذين وقفوا أمام هذه الظاهرة أحد يهود الإسلام , كما يصف نفسه , إلى جانب كونه أحد يهود العرب , هو جدع جلادي , الذي كتب "إسرائيل نحو الانفجار الداخلي" , وخصص الفصل الأول من كتابه هذا لتأمل هذه الظاهرة ، واختار عنواناً للفصل "الوئام بين يهود العالم الإسلامي والأمة الإسلامية" . وقد أحسن جلادي الإحاطة بالظاهرة فيما كتب , وتتبع جذورها , فعرض بداية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود , وحلل مضمون الصحيفة , ثم تحدث عن اليهود والفتوحات الإسلامية , وترحيبهم بها , ثم شرح نظام الملل الإسلامية , وأطلق عليه مصطلحاً حديثاً هو "الحكم الذاتي اليهودي" , ثم فصل الحديث عن اليهود في الحكم الإسلامي , وإسهامهم في ازدهار الاقتصاد , ثم وقف أمام تعرب اليهود في الإسلام لساناً وثقافة وحضارة ، وعرض أسماء من برزوا منهم في مختلف العلوم والآداب , وفصل الحديث عن التسامح الإسلامي , وختم بحديث عن يهود الغرب ويهود العراق .
وكان كاتب هذا الحديث قد وقف أمام هذه الظاهرة في بحثه "تطور حياة اليهود في فلسطين" , وفي بحثه عن "التعددية الدينية في الإسلام" , المنشور في كتابه "وحدة التنوع" . كما تناولت كتابات عربية وأجنبية الظاهرة بالدراسة . ولافت للنظر أن الكتابات الصهيونية حين وقفت أمامها حارت في كيفية التعامل معها , فحفلت بالتناقض مع نفسها ، ومثّل عليها الفصل الذي كتبه بن زيون دينور في كتاب "اليهود في أرضهم" .
إن هذه الظاهرة تفسر خلو تاريخ يهود الحضارة الإسلامية من أية ثورات على الحكم , على ما رأيناه في تاريخ اليهود , في ظل حضارتي اليونان والرومان , كما تفسر الإسهام الإيجابي لليهود في هذه الحضارة , وانعكاسها الإيجابي على حياتهم . وقد عرض فؤاد حسنين في كتابه "المجتمع (الإسرائيلي) منذ تشريده حتى اليوم" مثلاً على ذلك ظهور مذهب القرائين , الذي هو و لا شك وليد الإسلام والمجتمع الإسلامي ، وكان اليهود قبله يخضعون دينياً لنظام تلمودي شديد , يقيد حريتهم ، فإذا بالحضارة العربية الإسلامية تهزهم وتزعزع ثقتهم في التلمود , فكان أن ظهر هذا المذهب الجديد , وطور "الربانيون" منهم مذهبهم .. وهكذا برز عنان الذي أسس القرائين في العصر العباسي , وتأثر بتيارات الفكر الإسلامي . وبرز أيضاً سعيد الفيومي , الذي دافع عن اليهودية "السنية" ضد القرائين , وألف عدداً من الكتب .
والحديث عن انتماء يهود الإسلام إلى الحضارة العربية الإسلامية , وإسهامهم فيها , يغري بالاستطراد , ولكن مجال هذا الحديث يضيق عنه , ونكتفي بالإشارة إلى أعلام يهود برزوا , من أمثال موسى بن ميمون , وابن كمونة , والسمؤل بن حنفي , وغيرهم
|
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

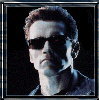

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:28 23/11/2010, 01:28 | |
| تاريخ القدس منذ الفتح العربي
(3)
"القدس إبان الغزو الفرنجي"
الفرنجة قتلوا آلاف المسلمين وأحرقوا اليهود في الكنس وصلاح الدين أعادهم إليها
تحالف الاستعمار الغربي والحركة الصهيونية لتهويد فلسطين والانتفاضة بداية مشوار التحرير الثاني
نصل في بحثنا هذا عن تاريخ القدس منذ الفتح العربي ، إلى صفحة سوداء من تاريخها , تتصل بأطماع الغزاة الطغاة فيها .
منذ غزا الفرنجة دار الإسلام والقدس عام 1099م - 492هـ رافعين شعار "الصليبية" , وتمكنوا من احتلال المدينة المقدسة ، عاشت القدس وما حولها محنة وصفها مجير الدين الحنبلي في كتابه "الأنس الجليل في تاريخ القدس و الخليل" بقوله "لم يُر في الإسلام مصيبة أعظم من ذلك" , ونقل عن ابن الأثير قوله "لبث الإفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون المسلمين ، وقتلوا في المسجد ما يزيد على السبعين ألفاً , منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم و زهادهم , ممن فارقوا الأوطان , وجاوروا ذلك الموقع الشريف" . وأضاف الحنبلي : "حصروا المسلمين في الحرم الشريف , وأعطوهم ثلاثة أيام للخروج من المدينة , والمتأخرون يقتلون ، وأما من كان في المدينة من اليهود "فقد جمعهم الفرنجة في الكنيسة وأحرقوها عليهم" , كما جاء في ذيل "تاريخ دمشق" للقلانسي , وفي "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردى . و أما أهل القدس من العرب النصارى فقد أبقاهم الفرنجة , لكن جردوهم من السيادة الدينية , بإلغاء البطريركية الأرثوذكسية , وإقامة أخرى لاتينية مكانها .
واستمرت محنة حروب الفرنجة 192 عاماً . ويدعو ما قام به الفرنجة الغزاة من فظائع خلالها , إلى الخاطر كيف تم الفتح العربي الإسلامي لبيت المقدس , من باب تداعي الأضداد ، ويصل بنا إلى المقارنة بين سلوك العرب المسلمين الفاتحين , حين انطلقوا بالإسلام , وفي ظل الحضارة العربية الإسلامية , وسلوك الفرنجة الأوروبيين الغزاة , حين انطلقوا طامعين بمغانم الشرق , رافعين شعار التعصب الأعمى , في ظل حضارتهم الغربية , كما يدعو قتل الفرنجة اليهود في القدس , وقبل ذلك في طريقهم إلى القدس , إلى الخاطر قيام أحفادهم بعد سبعة قرون بتنظيم اضطهادات لليهود في أوروبا , ثم باستغلال اليهود الأوروبيين في إقامة قاعدة استعمارية استيطانية لهم في فلسطين , واستخدامهم للتسلط على دائرة الحضارة العربية الإسلامية .
انتهت محنة القدس بعد تسعين عاماً من احتلال الفرنجة لها , حين حررها صلاح الدين الأيوبي بعد انتصاره في موقعة حطين الفاصلة , ودخل المدينة في ذكرى الإسراء والمعراج يوم 27 رجب سنة 583هـ الموافق 20 تشرين أول (أكتوبر) 1187م , وأعطى هذا الفاتح المسلم نموذجاً رائعاً في الرحمة والتسامح , "حيث عفا و رحم و أعطى الأمان لأنفس الفرنجة وأموالهم , حتى بلغوا مأمنهم في الساحل" .
وقد سجل ستانلي لين بول في تاريخه لصلاح الدين أنه إذا كان أخذ القدس هو الحقيقة الوحيدة التي نعرفها عن صلاح الدين , فإن ذلك كاف لإثبات أن صلاح الدين هو أكثر المنتصرين فروسية , وأعظمهم قلباً في زمانه , ولعله في كل زمان , و الحديث عما قام به صلاح الدين لتعمير بيت المقدس من جديد , بعد تطهيرها من رجس الاحتلال , ذو شجون .
لقد سمح صلاح الدين لليهود بالإقامة في المدينة فأقام فيها نفر منهم , تماماً كما أعاد للبطريركية الأرثوذكسية , التي ألغاها الفرنجة اعتبارها . ويفيض المؤرخون في الحديث عن سماحة صلاح الدين مع اليهود في فلسطين , وقد نقل بن زيون دينور عنهم ما كتبه يهودي من القدس إلى يهود الحريزي : "لقد رفع الله روح ملك الإسماعيليين (أي العرب المسلمين) في سنة أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة من الخلق, لتنزل فيه روح الحكمة والشجاعة، وهكذا جاء هو وجيشه من مصر, وحاصروا أورشليم (القدس), فسلمهم الله المدينة بين أيديهم , وأمر الملك (أي صلاح الدين) أن ينادي بصوت عال في المدينة للكبار والصغار , معلماً أهل القدس أن أي واحد يرغب من أبناء أفرايم , من الذين بقوا بعد المنفى الأشوري , والذين توزعوا في أنحاء الأرض , يمكنهم العودة إلى المدينة".
وينقل علي السيد علي في كتابه "القدس في العصر المملوكي" عن بعض المراجع أن عدداً من اليهود وفد إلى بيت المقدس من البلاد العربية وأوروبا , فزادوا بضعة مئات ، وأن صموئيل بن سيمون - وهو يهودي زار فلسطين سنة 1215- ذكر أن أكثر من 300 من الربابنة من جنود إنجلترا وفرنسا ذهبوا إلى الأرض المقدسة . ويقول دينور إن الملك العادل أخا صلاح الدين أحسن استقبالهم , وسمح لهم ببناء الكنيسة والكلية . وقد برز في عهد صلاح الدين من اليهود موسى بن ميمون (1135 - 1204) , الذي أصبح طبيباً من أطبائه ، وهو عند اليهود موسى الثاني , لعلمه وفقهه , وأشهر كتبه الفقهية "دلالة الحائرين" باللغة العربية .
عاشت فلسطين في العهد المملوكي مرحلة أخرى من مراحل العمران الحضاري الإسلامي ، وقد نهج المماليك نهج الأيوبيين في العناية بمدارس العلم , وبناء المساجد والمنافع العامة ، وتركوا آثاراً كثيرة في بيت المقدس , نجد ثبتاً كاملاً بها في كتاب "الأبنية الأثرية في القدس" , لإسحاق موسى الحسيني , الذي اعتمد فيه على ما قام به الأثريون البريطانيون .
كما نهج المماليك نهج الأيوبيين في سماحتهم مع أهل الكتاب نصارى ويهوداً . وقد ذكر مسلم الفولتيري الذي زار القدس عام 1481 أنه وجد فيها 250 يهودياً ، وحين زارها الرحالة اليهودي عبودية عام 1488 ذكر أن سبعين عائلة يهودية تسكنها , وأن فيها معبداً لهم ملاصق لمسجد للمسلمين . وتؤكد رسالة بعث بها رهبان الفرنسيسكان إلى البابا مارتن الخامس أن أعداداً من المسيحيين و اليهود الأوروبيين كانوا يأتون لزيارة القدس والإقامة فيها ، وقد ذكر هؤلاء الرهبان أن خلافاً نشب بينهم وبين اليهود في القدس على تملك القبو , الذي يوجد فيه قبر النبي داود سنة 1429، وطلبوا إليه أن يحرم على المسيحيين نقل اليهود الأوروبيين على سفنهم , ففعل و أصدر منشوراً بذلك .
عاش اليهود في بيت المقدس في العصر المملوكي في حارة لهم , شأنهم في المدن العربية الأخرى . وقد نقل علي حسن الخربوطلي في كتابه "العرب واليهود" عن ابن حوقة , أنه كان على رأس يهود الدولة الإسلامية رئيس يحمل اسم رأس الجالوت ، و أن اليهود من أهل الذمة اشتهروا بأعمال التجارة وصناعة الدباغة والخياطة والأحذية وصك النقود والصيرفة , وعملوا مرشدين سياحيين أيضاً ، وذلك في ظل رعويتهم للدولة الإسلامية .
وفي عام 1516م ، ضمت الدولة العثمانية بلاد الشام , بعد انتصار السلطان سليم على قونصوه الغوري في معركة مرج دابق قرب حلب . و أصبحت القدس سنجقاً من ولاية دمشق ، وقد عرج عليها السلطان سليم , فاستقبله علماؤها ووجهاؤها , وأولموا له في ساحة الحرم الشريف . وحين تولى ابنه السلطان سليمان (1520 - 1560م) عني بالقدس , فرمم قبة الصخرة , وأعاد تبليط المسجد , وعمّر جدران الحرم الشريف وأبوابه , وأنشأ عدداً من السبل , وأصبح يعرف بخادم الحرمين في القدس والخليل , إضافة إلى لقب خادم الحرمين في مكة والمدينة ، وزارت زوجته السلطانة القدس , وأوقفت أوقافاً عليها ، وأمّن السلطان سليمان الطريق بين يافا والقدس حماية للحجيج .
واستمر الوجود اليهودي في القدس في العهد العثماني شأنه في عهود الحكم الإسلامي السابقة ، ويذكر إسحاق بن زفي في بحثه في كتاب "اليهود في أرضهم" أن عدد اليهود عام 1526 كان مائتين , حسب إحصاء رسمي ، وأنه أصبح تبعاً لأحد المصادر 324 رب أسرة و 19 عازباً سنة 1555. وترجع هذه الزيادة إلى هجرة أعداد من يهود الأندلس السفارديم إلى الدولة العثمانية , بعد نكبة المسلمين في الأندلس منذ سنة 1492م .
وينوه المؤرخون اليهود بسماح العثمانيين للاجئين اليهود بالإقامة في دار الإسلام , في الوقت الذي رفضت فيه بعض الأقطار الأوروبية استقبالهم . ويقول إسحاق بن زفي إن حارة اليهود ضمت سفارديم و أشكناز ويهود مغاربة ويهود مستعربين , وهو يعني بالمستعربين اليهود العرب , الذين عاشوا في فلسطين والأقطار العربية , وقد تحسنت أحوالهم في عهد السلطان سليمان , الذي بنى السور العظيم , وفي عام 1551 أصدر السلطان فرماناً ولّى فيه الشيخ أحمد الدجاني أمر خدمة ضريح النبي داوود , الذي كان الخلاف احتدم بشأنه بين الفرنسيسكان الرهبان واليهود في عهد سلاطين المماليك , فتولت العائلة الدجانية هذا الأمر حتى نكبة فلسطين عام 1948.
نصل في تناولنا لتاريخ القدس منذ الفتح العربي إلى ما أصاب بيت المقدس بفعل الغزوة الصهيونية الاستعمارية في القرنين الأخيرين . ونستذكر مرة أخرى أن القدس التي كانت وطناً لشعبها , ومركزاً روحياً للمؤمنين بقيت مطمعاً للغزاة المعتدين ، وأن جميع الغزوات العدائية انتهت بالاندحار .
لقد عاد الغزو الفرنجي في صورة جديدة يستهدف فلسطين والقدس والمنطقة في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي , حين قام نابليون بونابرت بقيادة الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ومع أن هذه الحملة كان مصيرها الاندحار والهزيمة ، و اضطر بونابرت أن يرتد عند أسوار عكا , ثم يقفل راجعاً إلى مصر , ويخرج منها مهزوماً , بعد أن واجه مقاومة قادها الأزهر ، الذي منه خرج سليمان الحلبي , ليقتل كليبر المعتدي , الذي خلف بونابرت .. مع ذلك بقي الاستعمار الأوروبي في فصائله المختلفة مستهدفا القدس وفلسطين والمنطقة ، من ذلك الحين ، و باشر مرحلة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين والقدس , التي لا نزال نعيشها ونخوض الصراع لإنهائها .
حين نقف أمام تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في القدس , نستذكر بداية أن الاستيطان هو اغتصاب لأرض شعب آخر، يتخذ مفاهيم عدة .. اقتصادي و عقيدي وسياسي وديني وأمني . ونستحضر ما وصل إليه جمال حمدان في كتابه "استراتيجية الاستعمار والتحرير" , بشأن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني , الذي يمثله الكيان الصهيوني ، ونلخصه بسمتين رئيسيتين:
- أولاهما : عنصريته الحادة , التي هي من نوع عنصرية البيض الأوروبيين , الذين أبادوا شعوباً في أمريكا و إفريقيا , وفرضوا العبودية على ملايين الأفارقة .
- والأخرى : تسلط فكرة الأمن المطلق عليه ، وقد أحسن شرحها شيوخنا الاستراتيجيون , وليس خافياً لماذا تتسلط هذه الفكرة , فنحن أمام مغتصب يسرق الأرض والماء , ويخشى من صاحب الحق .
نستذكر أيضاً أن التحالف الاستعماري الصهيوني كان وراء الاستعمار الاستيطاني في فلسطين ، ومنذ أوائل القرن التاسع عشر برزت بريطانيا قطباً رئيسياً في هذا التحالف , الذي يسعى لاستعمار فلسطين , وبرزت أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية , التي ركزت أنظارها على القدس , وبكّرت في إقامة قنصلية فيها , كتب الكثيرون عن تحركاتها , وهناك إلى اليوم في القدس مبنى يحمل اسم "أمريكان كولوني" ، وكانت قوى يهودية وأخرى بروتستانتية في بريطانيا وأمريكا قد أثارت الأطماع في فلسطين ، ونذكر كيف كتب دزرائيلي عن القدس وأهميتها لبريطانيا , قبل أن يصبح رئيس وزراء .
لقد مرّ الغزو الاستعماري الصهيوني في فلسطين بأربعة مراحل , بعد أن تبلورت الحركة الصهيونية , بتشجيع من القوى الاستعمارية الأوروبية ، ونجحت في إرسال أول دفعة من المهاجرين إلى فلسطين من يهود شرق أوروبا عام 1882, في العام الذي احتلت فيه بريطانيا مصر ، فمن مرحلة التسلل , التي استمرت حتى عام 1917, إلى مرحلة التغلغل إبان الاستعمار البريطاني لفلسطين , حتى عام 1948, إلى مرحلة الغزو بعد إقامة "دولة إسرائيل" وحتى عام 1967, إلى مرحلة التوسع بعد حرب حزيران (يونيو) في ذلك العام . وقد وفق المرحوم جمال حمدان في اختيار أسماء هذه المراحل .
نجح الغزو الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في احتلال جزء كبير من القدس إبان حرب عام 1948، وأكمل احتلال الجزء الشرقي منها في حرب العام 1967، وقد سمعنا إسحاق رابين رئيس الوزراء الصهيوني السابق , يصرح لإذاعة العدو الصهيوني , رداً على إشارة عربية فلسطينية لأملاك عرب فلسطينيين في القدس الغربية , بالقول "لقد أخذنا القدس في حربين" .
وكما هو الشأن في كل استعمار استيطاني عمد الكيان الصهيوني , بعد أن نجح في احتلال القدس , إلى ضمها فوراً , ثم شرع في اغتصاب أراضيها تدريجياً , بسبل مختلفة , ليصل إلى تهويدها ، و إنا مدعوون إلى أن نتأمل طويلاً في خطوات هذه العملية , التي تبدأ بالتسلل , فالتغلغل , فالاحتلال , فالضم , فالاغتصاب , فالتهويد ، ونستحضرها في أذهاننا دوماً ؛ لأن أراض عربية مجاورة لفلسطين مستهدفة اليوم صهيونياً بمخططات التسلل , أولى خطوات هذه العملية .
وقد شهدت مرحلة التوسع في الغزو الصهيوني لفلسطين منذ عام 1967 تركيزاً خاصاً على القدس , فصلت شرح مخططاته , وما تم تنفيذه منها , كتب كثيرة ، فبعد إعلان ضمها , جرت إقامة خمس عشرة مستعمرة , وبناء ثلاثين ألف وحدة سكنية ، وتم الاستيلاء على ثلاثة و ثلاثين في المائة من أراضي القدس بالمصادرة و الاستملاك ، وتفننت الحكومة الصهيونية في اتخاذ الإجراءات , التي تسلب أهل القدس العرب من حقوقهم .
وما أشد الخطر الذي يهدد القدس بفعل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني , بعد إبرام اتفاق أوسلو- واشنطن ، فالجهود الصهيونية مركزة الآن لتهويدها ، وقد فصلنا الحديث عن أخطار هذا الاتفاق على القدس , وكيفية مواجهة هذه الأخطار , في كتاب "لا للحل العنصري في فلسطين" ، وأوضحنا كيف تعامل اتفاق إعلان المبادئ مع قضية القدس , مؤجلاً النظر فيها , ليفسح للعدو الصهيوني فرض الأمر الواقع , خلال الفترة الانتقالية . كما أوضحنا كيف عمد "مصمم" عملية التسوية الأمريكي إلى استبعاد البحث في قضية القدس , والالتفاف حول القضية ، وحصرها في نزاع حول الإشراف على مقدسات ، وعرضنا الإجراءات الصهيونية في القدس والموقف الصهيوني الحالي من القدس والموقف الأمريكي الناقض لقرارات الشرعية الدولية في حقيقته ، كما بيّنا أصول هذين الموقفين , وشرحنا المخطط الصهيوني للقدس الكبرى , وخطوات تنفيذه , وتعديه على الوقف الديني الإسلامي والمسيحي , وما نجم عنه من مشكلات لا حل لها , و ما ينبغي عمله .
يتضح مما سبق أن أخطر ما حكم مسيرة التسوية , التي حملت اسم "عملية سلام الشرق الأوسط" , هو منطق الإملاء الذي فرضه الفكر الصهيوني وفكر الهيمنة الطاغوتي ، وهو منطق يدعو القوي إلى الاغترار بقوته , فيصبح محكوماً بغطرسة القوة ، ويحثه على أن يفرض شروطه مسبقاً , بحيث يضطر الآخر إلى التخلي عن أوراقه التفاوضية .
لقد تجلى هذا المنطق في اتفاقات أوسلو واحداً بعد الآخر، أوسلو 1 (9/1993) و غزة - أريحا (5/1994) و أوسلو 2 (9/1995) في عهد حكومة حزب العمل الصهيوني برئاسة رابين , و عهد إدارة الرئيس كلينتون الأول ، ثم في اتفاق الخليل (1/1997) , و أخيراً في اتفاق "واي" في (10/1998) في عهد حكومة ليكود برئاسة بنيامين نتنياهو و عهد إدارة الرئيس كلينتون الثاني ، وهو اتفاق حول إجراءات لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه . ويتضمن بنوداً خمسة هي : "إعادات انتشار إضافية"، و"الأمن"، و"اللجنة الانتقالية والموضوعات الاقتصادية" ، و"مفاوضات الوضع النهائي" ، و"الأعمال أحادية الجانب" ، كما يتضمن جدولاً زمنياً . ثم تجلى هذا المنطق بشكل صارخ في المحاولة الأمريكية الصهيونية لاغتصاب الحرم القدسي , التي تولى كِبرها بيل كلينتون في صيف 2000 , وتابعها جورج دبليو بوش بعده .
واضح أن هذا الغزو الاستعماري الصهيوني لفلسطين والقدس , هو أخطر ما تعرضت له ديار العرب والإسلام منذ الغزو الفرنجي . و واضح أيضاً أن المقاومة العربية الإسلامية لهذا الغزو مستمرة , تتتالى حلقاتها . وقد دخلت مرحلة جديدة بانتفاضة الأقصى , التي أكملت شهرها الثالث عشر . وقد وضعت نصب العين مواجهة الكيان الصهيوني والدعم الأمريكي له , وصولاً بالولايات المتحدة إلى مراجعة استراتيجيتها في المنطقة , وإدراكها أن الكيان الصهيوني لن يكون ركيزة استراتيجية لها , وإنما عبئا استراتيجيا عليها , ووصولاً باليهود في هذا الكيان وخارجه إلى نبذ الصهيونية العنصرية , إذا أرادوا الأمن والسلام .
وقد وقعت زلزلة الهجوم على نيويورك وواشنطن يوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001، فنبهت قوة الطغيان في الغرب إلى حقائق هذا الصراع ، ويبقى أن نتابع الآن المقاومة لإنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين والقدس وتحريرهما |
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

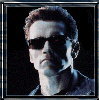

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:29 23/11/2010, 01:29 | |
| الحدود الجغرافية للمدينة عبر التاريخ
النشأة الأولى
ترسيم الحدود عام 1921
حدود عام 1946 -1948
حدود عام 1967
النشأة الأولى
نشأة النواة الأولى لمدينة القدس كانت على (تل أوفيل ) المطل على قرية سلوان التي كانت تمتلك عين ماء ساعدتها في توفير المياه للسكان ، إلا أنها هجرت وانتقلت إلى مكان آخر هو (جبل بزيتا ) ومرتفع موريا الذي تقع عليه قبة الصخرة . وأحيطت هذه المنطقة بالأسوار التي ظلت على حالها حتى بنى السلطــان العثماني ( سليمان القانوني ) سنة1542 م السور الذي لا يزال قائما ، محددا لحدود القدس القديمة جغرافيا، بعد أن كان سورها يمتد شمالا حتى وصل في مرحلة من المراحل إلى منطقة المسجد المعروف (مسجد سعد وسعيد )
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لم تعد مساحتها تستوعب الزيادة السكانية ،فبدأ الامتداد العمراني خارج السور، وفي جميع الجهات ظهرت الأحياء الجديدة التي عرفت فيما بعد بالقدس الجديدة، إضافة إلى الضواحي المرتبطة بالمدينة التي كانت ،وما زالت قرى تابعة لها ، وقد اتخذ الامتداد العمراني اتجاهين :أحدهما شمالي غربي والآخر جنوبي
ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، فقد جرى العمل على رسم الحدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي ، إذ امتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات ، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار، فتوقف خط الحدود أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة خارج حدود البلدية (الطور ، شعفاط ، دير ياسين ، لفتا ، سلوان، العيسوية ، عين كارم المالحة ، بيت صفافا ) مع أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد تكون ضواحي من ضواحيها ثم جرى ترسيم الحدود البلدية في عام 1921
ترسيم الحدود عام 1921 حيث ضمت حدود البلدية القديمة قطاعا عرضيا بعرض 400م على طول الجانب الشرقي لسور المدينة ، بالإضافة إلى أحياء (باب الساهرة ، ووادي الجوز والشيخ جراح) من الناحية الشمالية، ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط ،أما الناحية الغربية والتي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمـعات العربيـــة ( القطمون ، البقعة الفوقا والتحتا ، الطالبية ، الوعرية ، الشيخ بدر ، مأمن الله )
حدود عام 1946 -1948 أما المخطط الثاني لحدود البلدية فقد وضع عام 1946 ،وجرى بموجبه توسيع القسم الغربي عام 1931، وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية ووادي الجوز ، وبلغت مساحة المخطط 20.199 دونما ، كان توزيعها على النحو التالي :
-أملاك عربية 40%
-أملاك يهودية 26.12%
-أملاك مسيحية 13.86%
-أملاك حكومية وبلدية 2.9%
-طرق سكك حديدية 17.12% المجموع 100%
وتوسعت المساحة المبنية من 4130 دونما عام 1918 إلى 7230 دونما عام 1948، وبين عامي (1947 ، 1949 ) جاءت فكرة التقسيم والتدويل، لأن فكرة تقسيم فلسطين وتدويل القدس لم تكن جديدة فقد طرحتها اللجنة الملكية بخصوص فلسطين (لجنة بيل )، حيث اقترحت اللجنة إبقاء القدس وبيت لحم إضافة إلى اللد والرملة ويافا خارج حدود الدولتين (العربية واليهودية ) مع وجود معابر حرة وآمنة، وجاء قرار التقسيم ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن تكون القدس (منطقة منفصلة ) تقع بين الدولتين ( العربية واليهودية ) وتخضع لنظام دولي خاص ، وتدار من قبل الأمم المتحدة بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الخصوص وحدد القرار حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت (عين كارم وموتا في الغرب وشعفاط في الشمال ،وأبو ديس في الشرق، وبيت لحم في الجنوب )، لكن حرب عام 1948 وتصاعد المعارك الحربية التي أعقبت التقسيم أدت إلى تقسيم المدينة إلى قسمين
وبتاريخ 30/11/1948 وقعت السلطات الإسرائيلية والأردنية على اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 22/7/1948 وهكذا ومع نهاية عام 1948 كانت القدس قد تقسمت إلى قسمين وتوزعت حدودها نتيجة لخط وقف إطلاق النار إلى :
-مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية 2.220 دونما 11.48%
-مناطق فلسطينية محتلة ( الغربية ) 16.261 دونما 84.13 %
-مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة 850 دونما 4.40 %
المجموع 19.331 دونما 100%
وهكذا ، وبعد اتفاق الهدنة تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما انسجاما مع موقفها السياسي المعارض لتدويل المدينة
وبتاريخ 13/7/1951 جرت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية اهتماماً خاصا بتعيين وتوسيع حدودها البلدية ،وذلك لاسيتعاب الزيادة السكانية واستفحال الضائقة السكانية وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القدس ( الشرقية )بتاريخ1/4/1952 ، وقد ضمت المناطق التالية إلى مناطق نفوذ البلدية (قرية سلوان ، ورأس العامود ، والصوانة وأرض السمار والجزء الجنوبي من قرية شعفاط ) وأصبحت المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية 4.5كم2 في حين لم تزد مساحة الجزء المبني منها عن 3كم. وفي 12/2/1957 قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية، نتيجة للقيود التي وضعها (كاندل ) في منع البناء في سفوح جبل الزيتون ، والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (ماونت سكويس ) بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تعود للأديرة والكنائس ، ووجود مشاكل أخرى مثل كون أغلبية الأرض مشاعا ولم تجر عليها التسوية (الشيخ جراح وشعفاط )، وهكذا وفي جلسة لبلدية القدس بتاريخ 22/6/1958 ناقش المجلس مشروع توسيع حدود البلدية شمالا حيث تشمل منطقة بعرض 500 م من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى رام الله ويمتد شمالا حتى مطار قلنديا
واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية بما في ذلك وضع مخطط هيكل رئيسي للبلدية حتى عام 1959 دون نتيجة
حدود عام 1967 وفي عام 1964 ،وبعد انتخابات عام 1963 ،كانت هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح مساحتها 75كم ولكن نشوب حرب عام 1967 أوقف المشروع ، وبقيت حدودها كما كانت عليه في الخمسينات .أما القدس الغربية فقد توسعت باتجاه الغرب والجنوب الغربي وضمت إليها أحياء جديدة منها (كريات يوفيل، وكريات مناحيم ، وعير نحانيم ، وقرى عين كارم ، وبيت صفافا ، ودير ياسين ، ولفتا ، والمالحة ) لتبلغ مساحتها 38 كم2
أثر حرب حزيران على الحدود
بعد اندلاع حرب 1967 قامت إسرائيل باحتلال شرقي القدس، وبتاريخ 28/6/1967 تم الإعلان عن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها، وطبقا للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب .
لقد تم رسم حدود البلدية لتضم أراضى 28 قرية ومدينة عربية، و إخراج جميع التجمعات السكانية العربية، لتأخذ هذه الحدود وضعا غريـبا ، فمرة مــع خطوط التسوية ( الطبوغرافية ) ومرة أخرى مع الشوارع، وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتتسع مساحة بلدية القدس من 6.5كم2 إلى 70.5 كم2 وتصبح مساحتها مجتمعة ( الشرقية والغربية 108.5 كم2 ) وفي عام 1995 توسعت مساحة القدس مرة أخرى باتجاه الغرب لتصبح مساحتها الآن 123كم2 |
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

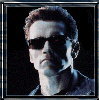

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:30 23/11/2010, 01:30 | |
| الإسراء والمعراج.. وعروبة القدس
بقلم: د. أحمد يوسف القرعي
صحيفة الأهرام 24/8/2006
معجزة الإسراء والمعراج هي المرجعية الأولى لقدسية القدس العربية الإسلامية، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومن ثم، فإن الخطاب الديني لذكرى الإسراء والمعراج يعد في المقام الأول سنداً قوياً للحق العربي الإسلامي في القدس، هذا الحق الذي تعزز بالمنشأ والتكوين العربي للمدينة منذ خمسة آلاف عام، كما تعزز أيضاً بالسيادة العربية الإسلامية على المدينة المقدسة أطول فترات عصور التاريخ القديم والوسيط والحديث.
أكتب عن هذا بعد أن لاحظت أن الخطاب الديني طوال هذا الأسبوع لم يتطرق إلى هذا التواصل المقدسي عبر العصور، حيث توقف الدعاة والمتحدثون والإعلاميون عند معجزة الإسراء والمعراج، دون محاولة ربط دروس ذكرى تلك المعجزة بمكانة القدس منذ ذلك الوقت في الفكر والتاريخ العربي والإسلامي، وأيضاً ربط الذكري بمسئوليات الأمة تجاه تحرير المدينة المقدسة، وتأكيد عروبتها منذ الفتح الإسلامي للمدينة.
وفي العهدة العمرية، أعطى الخليفة عمر أماناً لأهل إيلياء، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها.. ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.
ومضى عمر بن الخطاب بعد أن دخل القدس يبحث عن موقع الصخرة المشرفة، ولكن صفرونيوس بطريرك القدس قاده أولاً إلى كنيسة القيامة فتفقد عمر الكنيسة، وعندما حان موعد الصلاة رفض الخليفة أن يصلي فيها، لئلا يكون في ذلك سابقة لصلاة المسلمين في الكنيسة، وصلى في مكان قريب إزاءها.
وعندما بلغ الخليفة الصخرة، قام بتنظيفها ثم أمر بإقامة مسجد في ساحة الحرم الشريف، وعين علقمة بن مجزر حاكماً على القدس، والصحابي عبادة بن الصامت، أول قاض على القدس، وأقام الحسبة في المدينة ورتب البريد به ثم غادر أمير المؤمنين المدينة بعد عشرة أيام، وفي رواية أخرى بعد أربعة أيام، كانت فاتحة التاريخ الإسلامي العربي لبيت المقدس.
* * *
يعني هذا كله أن القدس هي مدينة الإسراء والمعراج، وكانت القبلة الأولى لأكثر من ثلاث عشرة سنة، وحتى السنة الثانية من الهجرة (610 ـ623 م) وظلت القدس منذ ذلك الوقت تحتل مكانتها المقدسة في قلوب وعقول الأمة العربية والإسلامية، حتى وقعت تحت الاحتلال الصليبي (1099 ـ1187) ونجح صلاح الدين الأيوبي في تحريرها، ثم وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، حيث دخلت القدس دائرة الخطر بمحاولات تهويدها.
ومن هنا، فإن ذكرى معجزة الإسراء والمعراج ترتبط بالمدينة المقدسة أرضاً وفضاءًً.. مادة وروحاً ومن الأهمية أن يتواصل الخطاب الديني مع هذا السياق، فنحن كأمة عربية إسلامية أصحاب قضية مقدسة، وللخطاب الديني مكانته ومسئوليته في تعبئة شعور الأمة.. لذا وجب التواصل.
|
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

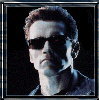

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:31 23/11/2010, 01:31 | |
| الوجود القبطي في القدس حتى القرن العشرين د. محمد عفيفي لا تهدف هذه الدراسة إلى مجرد استعراض الوجود القبطي في القدس عبر العديد من القرون أو حتى الاهتمام فقط بالمظاهر الدينية وأماكن العبادة القبطية في القدس، وإنما يتركز اهتمامنا نحو رصد ما ترتب على كل هذا من فعاليات وأنشطة ومظاهر اجتماعية واقتصادية. على أية حال ترجع معظم الدراسات نشأة الوجود القبطي في القدس إلى الزيارة للأماكن المقدسة في المدينة، منذ اكتشاف الأمبراطورة هيلانة للصليب المجيد في عام 325م وتأسيسها لكنيسة القيامة. ولا أدل على ذلك من اشتراك البطريرك القبطي أثناسيوس في تدشين هذ الكنيسة مع بطريركي انطاكية القسطنطينية. وكذلك قصة القديسة مريم المصرية التي حضرت إلى القدس في عام 382م، حيث استقرت هناك، وشاع صيتها، حتى أنه بعد وفاتها تم تشييد كنيسة على أسمها مجاورة لكنيسة القيامة. واستمر الوجود القبطي في القدس مع الفتح العربي له، فقد نص كتاب الأمان للقدس المعروف «بالعهدة العمرية» على ذكر الوجود القبطي في القدس ضمن عهد الأمان لكافة الطوائف المسيحية في المدينة المقدسة واستمر بناء الكنائس والأديرة القبطية في القدس بعد ذلك، ففي القرن التاسع الميلادي تم إنشاء كنيسة قبطية في القدس عرفت بكنيسة المجدلانية، ولعل أشهر الأمثلة جميعاً هو دير السلطان الذي رغم التضارب في نسبته إلى أحد السلاطين يعتبر من أشهر مظاهر الوجود القبطي في القدس نظراً للظروف الدرامية اللاحقة. ويعتبر أول حصر دقيق للكنائس القبطية في القدس، هو الحصر الذي سجله أبو المكارم في تاريخه عن الكنائس في عام 1281م ، إذ يذكر أبو المكارم وجود هيكل قبطي داخل كنيسة القيامة، وكنيسة باسم المجدلانية، وكنيسة ثالثة هي التي دخلت في دير السلطان (1). من ناحية أخرى تتحدد الممتلكات الدينية للأقباط في القدس في الوضع الحالي حسب الحصر التالي: 1 - دير السلطان وبه كنيستا الملاك والأربعة حيوانات. 2 - دير مارانطونيوس شمال شرقي القيامة. 3 - دير مارجرجس حارة الموارنة. 4 - كنيسة السيدة العذراء بجبل الزيتون. 5 - هيكل على جبل الزيتون. 6 - كنيسة باسم ماريوحنا - خارج كنيسة القيامة 7 - كنيسة صغيرة باسم الملاك ميخائيل ملاصقة للقبر المقدس من الغرب (2). ولعل أهم مشكلة حالية ساخنة بالنسبة للوجود القبطي في القدس هي مشكلة دير السلطان والنزاع القبطي الحبشي حول هذا الدير، وهذا الدير هو الوحيد من بين الأديرة القبطية الذي يحمل أسماً غير قبطي وهناك مشكلة تاريخية في نسبة هذا الدير إلى أي من السلاطين المسلمين، إذ يرجعه البعض إلى عصر صلاح الدين الأيوبي، الذي أعطاه مكافأة لبعض موظفيه، من الأقباط، ويرى البعض الآخر أن سر هذه التسمية تعود إلى استضافة الدير لموظفي السلاطين الذين يعودون إلى القدس، بل ويرجع البعض تسميته دير السلطان إلى أحد السلاطين العثمانيين، وإن كان هذا الرأي هو أضعف الآراء من حيث الدقة التاريخية (3). ويأتي الخلاف حول ملكية الدير من جراء سماح الكنيسة القبطية للرهبان الأحباش بالإقامة في الدير بعد أن فقدوا العديد من أديرتهم. ومنذ ذلك الوقت دب النزاع بين الأقباط والأحباش حول ملكية الدير. وفي الحقيقة كانت الكنيسة الحبشية منذ نشأتها تابعة للكنيسة القبطية. فالبابا القبطي هو «بابا الأسكندرية والمدن الغربية الخمس وأفريقيا». ومن هنا لم يكن غريباً استضافة الكنيسة القبطية للأحباش في دير السلطان لكن الأحباش استندوا إلى نظرية الوضع الراهن المعمول بها في القدس، وأصروا على تنازل الكنيسة القبطية له عن الدير (4). واختلطت مشكلة دير السلطان بمشكلة تاريخية أخرى هي سعي الأحباش الدائم من التخلص من تبعيتهم للكنيسة القبطة وتصاعد النعرة الحبشية لا سيما مع نمو المد الأوروبي في الحبشة. من هنا دخلت مسألة دير السلطان إلى منعطف خطير حيث ارتبطت بها مسألة الهوية الحبشية من ناحية و مسألة الحفاظ على الطابع القبطي للكنيسة القبطية، كنيسة الشهداء. ومن هنا فشلت كل المحاولات التي دارت في النصف الأول من القرن العشرين للتوفيق بين الأقباط والأحباش وهي المحاولات التي تدخل فيها أمبراطور الحبشة السابق هيلاسلاسي، وبعض كبار الأقباط من خلال اقتراح اقتسام الأقباط والأحباش للدير (5). وتعقدت مشكلة دير السلطان تحت الاحتلال الإسرائيلي للقدس. إذ خطف الرهبان الأحباش مفتاح الدير من الأقباط، وثارت مشكلة كبرى، وتدخل الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب الأحباش، مما أدى بالمطران القبطي باسيليوس إلى رفع قضية أمام المحكمة العليا في إسرائيل التي حكمت بأحقية الأقباط للدير. لكن سلطات الاحتلال رفضت تنفيذ الأمر متعللة ببعض الأسباب السياسية حول أهمية العلاقات الأثيوبية - الإسرائيلية. ودفع هذا الأمر الكنيسة القبطية إلى إصدارها لقرارها الشهير بمنع الحج إلى القدس والحرمان الديني لأي قبطي يخالف هذا القرار، وقطعه من الكنيسة القبطية، وحتى يعود دير السلطان للأقباط (6)، وما تزال مشكلة دير السلطان من المشاكل المعلقة بين الإدارة الإسرائيلية والمصرية. ولقد أثارت هذه الظاهرة انتباه البعض، ومن حيث مسألة الأصل والهوية والانتماء. حيث أجرت مجلة متخصصة في الدارسات القبطية (مجلة أجنبية) حواراً مع بعض أقباط القدس بشأن الانتماء، هل هناك مشكلة حول ذلك الأمر، وكانت إجابة معظم هؤلاء «نحن فلسطينيين من حيث الجنسية والهوية ولكننا فقط ننتمي إلى الكنيسة القبطية من الناحية الدينية» (7). وتترتب على الوجود القبطي في القدس بعض المؤسسات ذات الطابع المدني، ولعل أشهر هذه الأمثلة جميعاً المدرسة القبطية في القدس. إذ أنشأت بطريركية الأقباط في القدس الكلية الأنطونية للبنين، ثم أنشأت بعد ذلك كلية الشهيدة دميانة للبنات، بتقديم الخدمات التعليمية بها حتى الحصول على شهادة الدراسة الثانوية (  . والالتحاق بهذه المدارس ليس قاصراً على أبناء الأقباط فحسب، بل مفتوح حتى للمسلمين، وترسل وزارة التربية والتعليم ف يمصر بعثة تعليمية من المدرسين المصريين للخدمة في هذه المدارس في القدس، على الرغم أن المنهج الدراسي والنظام التعليمي بها لايسير على نمط التعليم المصري. ومن المؤسسات القبطية ذات الطابع المدني وإن ارتبطت بشكل أو بآخر بالناحية الدينية، إنشاء جمعية خيرية اجتماعية لرعاية الوجود القبطي في القدس. ففي عام 1944 تم في القاهرة إنشاء رابطة القدس للأقباط الأرثوذكس. وحرصت الرابطة منذ ذلك التاريخ على أن تعمل من أجل حفظ تراث الأقباط في القدس، مساعدة للاجئين الأقباط بعد ذلك. إلى جانب تيسير إجراءات الزيارة المقدسة إلى القدس، هذا فضلاً عن المساهمة المادية في تدعيم الكنائس والأديرة والمدارس القبطية في القدس. كما حرصت الرابطة منذ نشأتها وحتى توقف الحج القبطي إلى القدس، على إجراء قرعة سنوية بين الأعضاء ومن يفوز بالقرعة يذهب مجاناً إلى القدس ومن الطريف أن هذه القرعة السنوية ما تزال تجرى حتى في سنوات منع الكنيسة القبطية للأقباط عن الذهاب إلى القدس. إذ تعلن الرابطة نتيجة القرعة على أن يذهب هؤلاء إلى القدس بعد رفع الحظر المفروض على ذهاب الأقباط للقدس (9). ولعل أهم تحول في تاريخ الوجود القبطي في القدس هو ما تم في عصر البابا كيرلس الثالث في النصف الأول من القرن الثالث عشر. فحتى ذلك الوقت كان الوجود القبطي، ليس في القدس فحسب، بل في الشام بأكمله، تحت رعاية بطريرك أنطاكية. لكن البابا كيرلس الثالث خطا خطوة هامة في هذا الشأن حيث أنشأ لأول مرة مطرانية قبطية للقدس والشام، ورسم لها أحد الأساقفة الأقباط. وربما دفعه إلى ذلك التنافس بين كرسي أنطاكية والأسكندرية، فضلاً عن هجرة بعض الأقباط من مصر، واستقرارهم في القدس وبعض المدن الشامية، وحاجة هؤلاء إلى راع قبطي لهم. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن أصبح لمطرانية لقدس مركز هام في الأكليروس القبطي (10). ويرتبط بالوجود القبطي في القدس، الحج القبطي إلى القدس الذي يعتبر من أهم أمنيات وأحلام الشخص القبطي. ويسمى من يقوم بالحج إلى القدس «المقدس». وكان الأقباط يخرجون عادة إلى القدس في شكل قافلة ذات مكب محملة بالمؤونة والزاد. وتخرج هذه القافلة من المطرية في ضواحي القاهرة وتتجه شرقاً إلى الخانقاه السرياقوسية، لتأخذ الدرب السلطاني عبر سيناء إلى العريش، غزة ثم الرملة وأخيراً إلى القدس. وبالإضافة إلى المؤونة والزاد التي يتم إرسالها بصحبة قافلة الحج القبطي، كان يرسل أيضاً مؤونة أخرى إضافية عن طريق البحر. وتنقل هذه المؤونة من القاهرة إلى ميناء دمياط، حيث تنقل بالبحر إلى يافا، ومن هناك إلى القدس. وفي بعض الأحيان وعند انقطاع الدرب السلطاني نتيجة تمرد العربان وقطعهم للطريق، كان الأقباط يأخذون الطريق البحري إلى يافا ثم من هناك إلى القدس. وفي القرن العشرين كان خط السكك الحديدية إلى القدس هو الطريق المفضل لمعظم الأقباط (11). وتذكر المصادر التاريخية بعض الإشارات القليلية حول وجود نشاط تجاري بصحبة قافلة الحج القبطي إلى القدس، لكننا لا نملك التفاصيل حول هذه النقطة الهامة. وهذا الأمر ليس بالغريب، فحتى قافلة الحج المسلم المصري إلى الحرمين الشريفين، ارتبط به العديد من مظاهر النشاط الاقتصادي سواء على الطريق أو في المدن المقدسة ذاتها (12). ومع وجود العديد من الكنائس القبطية فضلاً عن الأديرة القبطية في المدينة المقدسة، ونتيجة للوازع الديني، فضلاً عن الطبيعة الدينية والاجتماعية لنظام الوقف، حفلت الوثائق القبطية بالعديد من حجج الأوقاف المرصودة على القدس. ولم يكن الوقف حكراً على الأماكن المقدسة في القدس من جانب أثرياء الأقباط، بل كانت معظم الأوقاف القبطية على القدس مرصدة من جانب الطبقة الوسطى القبطية، ومن هنا وجدنا العديد من حجج الوقف القبطي التي تشتمل على وقف عمارات صغيرة، أو حتى جزء من عقار، وهي ظاهرة واضحة في الأوقاف القبطية، واختلفت أوضاع الأوقاف القبطية المرصدة، فبعضها كان مرصداً على الواقف ثم على النسل والذرية، على أن تؤول في حالة انقطاع الذرية إلى الأماكن المقدسة في القدس (13)، وبعضها الآخر يتم رصده على بعض الأديرة القبطية في مصر، وفي حالة تعذر صرف العائد على هذه الأديرة أو زوالها تؤول هذه الأوقاف إلى القدس (14)، كما كان هناك بعض الأوقاف المرصدة مباشرة على القدس (15)، وبصفة عامة كان معظم الأوقاف القبطية المرصدة على القدس توضع تحت إشراف البابا القبطي في القاهرة، وينوب عنه المطران القبطي في القدس. ولكن في حالات نادرة وقف بعض الأقباط أوقافاً على الحرم القدسي بصفة عامة دون تخصيص لدير أو كنيسة معينة، وفي هذه الحالة توضع هذه الأوقاف تحت إشراف «ناظر أوقاف الحرم القدسي» وهو من المسلمين (16). كما حرصت الرابطة على إصدار العديد من النداءات والمطبوعات الإرشادية إلى جانب مجلة دورية تصدر باسم الرابطة، واهتمت الرابطة بإنشاء بعض الملاجئ القبطية في القدس لخدمة الأطفال الأيتام، وجمع المساهمات المادية والعينية لهم وإرسالها إلى القدس. واتخذت الرابطة موقفاً حاسماً من مسألة القدس إذ رفعت الرابطة شعاراً وهو «إن نسيتك يا أورشليم تنسني يميني» (17). ويبقى علينا في النهاية استعراض الوضع الحالي للأقباط وللوجود القبطي بصفة عامة في القدس، في الحقيقة أضعفت فترة الاحتلال الإسرائيلي من شأن الوجود القبطي في القدس، إذ انقطعت إلى حد كبير العلاقات بين الأقباط والقدس والقاهرة، وانخفض بشدة عدد الرهبان الأقباط في الأديرة والكنائس القبطية في القدس. إلى الحد الذي أدى بمطران القدس إلى إرسال استغاثة إلى البابا شنوده - بعد معاهدة السلام - بضرورة رسامة بعض الرهبان والشمامسة في هذه الكنائس والأديرة من أجل إعادة الحياة إليها من جديد (18). وينطبق نفس الشيء على المدارس القبطية في القدس، لا سيما مع عدم وصول التبرعات المالية اللازمة، وتوقف وصول البعثة التعليمية المصرية إليها، من هنا تم تسوية هذا الأمر بالاتفاق بين الكنيسة القبطية ووزارة الخارجية المصرية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، وتوقف أيضاً نشاط الملاجئ القبطية في القدس، بل وتم إغلاقها في فترة لاحقة نتيجة الأزمة المالية التي أحاطت ببطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس (19). وفي بعض الأوقاف استعان الأقباط ببعض كبار الموظفين السريان في القدس لرعاية الأوقاف القبطية والشؤون المدنية لطائفة الأقباط، ففي عام 1703 على سبيل المثال كان «المعلم إسحق القدسي السرياني ابن المعلم سالم، الوكيل عن طائفة الأقباط بالقدس الشريف، المباشر بخدمة الديوان بالقدس الشريف». وعند عزله متولي القدس، أرسل المطران القبطي في القدس إلى البابا في القاهرة ليخبره بذلك، وبضورة اختيار وكيلاً جديداً (20). ولكن هذا الوضع سيتغير إلى حد كبير منذ القرن التاسع عشر، إذ سيتولى الأقباط بأنفسهم رعاية الأوقاف والممتلكات القبطية في القدس، والوكالة عنها أما ولاة الأمور، لا سيما مع تولي بعض الأقباط لوظائف إدارية في القدس (21). ويحدد التقليد الصادر من البابا القبطي برسامة مطران القدس مهام هذا المطران وواجباته فهو «رئيساً بالقيامة المعظمة والأماكن المقدسة والآثارات السيدية والبيع والديورة داخل القيامة المعظمة وخارجها، المختصة بجماعة النصارى طائفة القبط بمدينة القدس الشريف» أما عن مهامه فهي «التكلم والتحدث في إصلاح ما يتعلق بالقيامة وخدامها من الكهنة والشمامسة والحبش والزوار» وأيضاً «التحدث والنظر على موجود القيامة المقدسة والأماكن المقدسة وعلى وقوفاتها (الأوقاف) وتعلقاتها الداخلة فيها والخارجة عنها. وعليه حفظ ذلك وصونه وجمعه كما يجب. ويسعى عليه وينميه ويثمره، ولا يمكّن أحداً من التفريط ولا من إضاعة شيء منه إلا في وجهه الذي ينبغي صرفه فيه، وليس لأحد أن يعمر منازل أو مساكن إلا بمعرفته، وإن كان ضرورياً بحيث لا يخالفوه فيها ولا يردّون له أمراً.. ويجب على الرئيس المذكور ألا ينال من رزق الأماكن المقدسة إلا ما هو كفاف ولحياته قوام» (22). |
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

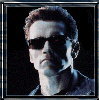

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:33 23/11/2010, 01:33 | |
| ومن النقاط الهامة المتعلقة بالوجود القبطي في القدس مسألة الحجم العددي لهذا الوجود، أو بمعنى آخر تعداد الأقباط في القدس، حتى نستطيع تقييم هذا الشأن وتطويره عبر العصور، أو إذا لا يتوافر لدينا سوى بعض التقديرات من جانب بعض الرحالة أو بعض رجال الدين.
وهي في مجملها لا تعدو أن تكون سوى تقديرات لا تعطي لنا صورة حقيقية عن حجم الوجود القبطي في القدس وتطوره عبر القرون.
ففي عام 1817 يقدر أحد الرحالة الغربيين عدد الأقباط في القدس حوالي 50 قبطياً، وفي عام 1837 يحدثنا مصدر آخر عن وباء الكولرا الذي عصف بالقدس آنذاك، ويذكر أعداد من مات من الطوائف المسيحية بالقدس، مقدراً عدد من راح من الأقباط في هذا الوباء بسبعة أفراد، وفي عام 1853 يقدر أحد الرحالة عدد الأقباط في القدس من الناحية العددية لم يكن كبيراً إذ قارنّاه بأعداد بعض الطوائف المسيحية الأخرى إذ يقدر هذا المصدر عدد المسيحيين الروم بحوالي ألفين، وعدد الكاثوليك بحوالي تسعمائة والأرمن 350 فرداً، مع ذلك تتفوق الجالية القبطية في القدس من حيث العدد على بعض الجاليات المسيحية الأخرى، إذ يقدر عدد السريان في القدس آنذاك بحوالي عشرين، ونفس الرقم بالنسبة للأحباش (23).
ويقدر الأنباباسيليوس المطران القبطي للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى عدد الأقباط في كل فلسطين في عام 1948 حوالي عشرة آلاف نسمة (24).
ويقدر مصدر آخر عدد الأقباط في القدس في خمسينيات القرن العشرين بحوالي خمسمائة نسمة، وبرى هذا المصدر أن هذ الرقم قد ارتفع ليصل إلى حوالي ألف نسمة عند عام 1970 (25).
وحتى الآن ما تزال تعيش عشرات الأسر الفلسطينية في القدس التي تنحدر من أصول قبطية ولعل أهم هذه الأسر عائلات خوري، حبش، رزوق، جدعون، قبطة، مناريوس، حلبي، مينا، مرقص، ترجمان (26).
|
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

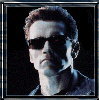

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:34 23/11/2010, 01:34 | |
| نقض أوهام الليكوديين في المدينة المقدسة:
القدس كنعانية الجغرافيا والتاريخ وهذه الهوية
ضمانة للحق الفلسطيني التاريخي فيهاعبد المجيد العوني القدس لفظة عربية لله القدوس، فهو القدس ذاته وصفاته، لكن دعوة هذه المدينة بأنها "مدينة الله" وصف كامل لأنه السلام، فدعيت مدينة السلام، ولأنه قدوس دعيت القدس، وهذه اللفظة مولدة عن تاريخ الأنبياء، وأمكنتهم ودعوتهم التي أتى الإسلام ناسخاً لها مؤمناً بها، بمعنى أنه تركيب روحي لما سبق، ليكون خاتم التنزيل، ومفتوحاً على التأويل لمسايرة كونه فوق الشروط حفاظاً على أبديته ومطلقيته، ولا يهمنا في هذا الباب إلا التطرق إلى الدعاوى الليكودية الآن لجعل مدينة القدس مدينة عبرانية الأصل والروح والعمل، على الرغم من أن اللفظة العبرية ذاتها "يرشلم" آرامية من القرن 12 قبل الميلاد، دعيت في عهد العائلة الثانية عشر المصرية باوشوم، وتطورت في الصيغة الكنعانية الأولى من أوروساليم إلى أن أصبحت أوروسليمو، ليكون المعنى في حدود أن كلمة "أورة المدينة" و"السليمو" السلام، وكنعانية اللفظة (فونتيكيا وسيمونتيكا) هي مدينة السلام، لكن تعلق الليكوديين بجعل كلمة "زورد" أكادية، وهي من نفس الاشتقاق السومري يحول اللفظة إلى عبرانيتها، ومن ثم موسويتها، لكن ذلك غير وارد لثلاثة أسباب: أولها، ذكر في الأصل الكنعاني للكلمة، وثانيهما، في أن اعتبار أورو ذات أصل عبراني من لفظه (يره) – كما يكتب الليكوديون الآن في أبحاثهم – له معنى واحد هو "شتت" باللغة العبرية الأولى، وهذا التأويل الذي جنح له أكثر من لغوي (1)، ينبئ على محاولة اليهود استيطان اللفظة، وجعلها اشتقاقاً ممكناً، لكن ذلك غير واضح لأن بيرو تعنى المدينة ذات النصف الأعلى والأدنى، واستخدامها يوغري (سوري)، لأن تشتيت التركيز اللغوي الليكودي هو على اسم المدينة، ومحاولة إيجاد أصل عبراني لها، أما سليم أورشليم فإنه تواتري الذيوع، ولا أشكال في توطينه عبرانياً، لكن مع ذلك تقع في المقاربة اللغوية أخطاء من ضمنها، أن السين ليس صوتاً عبرانياً، فهو كنعاني دخيل على هذه اللغة، ففي "سليمو" البنية الفونتيكية والتركيبة كنعانية، ليجرنا السبب الثالث إلى كون الشين ذاتها آرامية، فتصبح أوشليم لفظة آرامية، وأورسليم كنعانية، وأورشليم عبرية، وشليم استعمال المفهوم السلام في أربعة أصول: آرامية/ كنعانية/ أورغية/ عبرانية. وأور وحدها استخدام كنعاني/ آرامي مما يجعل اللفظة تركيباً من أصل واحد (كنعاني/آرامي) . المحاولة الليكودية في إعادة توطين مصطلح "أورو" شكل أكبر محنة للغويين والدينيين في إسرائيل، خصوصاً وأن توجيه التفكير إلى أن "أورو" من ييري أو يري بمعنى بني أو هيكل حتى تعتبر اللفظة علامته لسنية على التوطين يواه ثلاثة متاعب: أن اللفظ ليس بمعنى "بنى" إنما "أسس" وإن كان ذلك فلماذا سميت "مدينة داود" بعد أن كانت مدينة السلام أو الله، فاللفظة العربية مثلاً (القدس) أتت من الترجمة الروحية للكلمة، من مدينة السلام إلى مدينة القدوس، أهم ما خاطبت به المسيحية "الله" في التسبيح والتهليل، ونعت اللفظة بتأويلها في لحظة انتشارها يؤكد عدم وجودها، أم عدم تأصيلها، خصوصاً وأن ييري إن بحثنا على أصلها وجدناه (يره) وييرى إعادة إيجاد الشيء بعد شتات، أي بمعنى "حضر" مرة أخرى . أورشليم هي الله هنا أو السلام في مكانكم، والأورو يعني المكان، وقد رفعته المسيحية ليكون عاماً فوق أرض وحدود هذه المدينة، ومن ثم عقيدة شاملة (2) لها، فأصبحت مدينة اللاهي الملكوت، وأورشليم لم تعد مكاناً بل روح للصلاة والعبادة، ورمز خاص لها للحج إليها، والأهم هنا أن اللفظة أصبحت آرامية التداول تعني "السلام معكم أو عليكم"، وهي نفس الصيغة بالعربية فيما بعد، فهل معنى ذلك أن أورشليم عبرانية إن كانت أصلاً أو استعمالاً أو تطوراً تيمولوجياً غير عبرية؟ خصوصاً وأننا ندرك عدم أصالة لفظة "أورو" واشتراك أكثر لغات الشرق في تركيبة "شليم" (بمعنى السلام)، وتفرد كل منها عن العبرية في "سلم" التي كانت تقديراً واستعمالاً آرامياً/عربياً خصوصاً وأنها عرفت انعراجاً بعد أن تم توجيه الكلمة إلى الملكوت، ودعيت هي إلياء أو علياء: المدينة ذات الميزة العليا . إن روحية هذه المدينة غير ذات معنى في التراث العبري، ذلك أنها تعد تاريخياً، مدينة داود ليس إلا، فلم يكن لها أي دور جوهري في الرسالة الموسوية سوى إنشاء الدولة وحكمها، أما الأساس العقدي للمسيحيين فيها فهو أقوى لأنهم جعلوها الصفة المكانية للملكوت، وعند المسلمين كانت مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لتكون عند أتباعهما حلقة بين السماء والأرض، فالقدسي هو ما ترفع أو كان من المباشرة أو الاتصال بالله، وكان ذلك عند المسلمين والمسيحيين سواء بسواء، والاثنان يجمعان على عودة المسيح إلى الأرض، ليكون الاتصال من ثان بالسماء، ومن نفس المكان . إذن المكان ذو أهمية أوكيولوجية/ تاريخية عند اليهود، ولم يكن ذلك اختياراً بل أتى حسب الظرف، لأن موسى عليه السلام دخلها، لكن في التراثين المسيحي والإسلامي كان اختياراً قدرياً من نفس المكان بالنسبة للمسيح لأنه نبي السلام من هذه المدينة، واختياراً قضائياً عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماء، فهي المدينة التي يخاطب الله من خلالها حسب كل الأنبياء، وهي موطنهم في الأصل والأغلب . قدسية المدينة إذن محدودة في الماضي (التاريخ) عند الطرف اليهودي، ومحدودة مستقبلاً في عودة المسيح بنص العقيدتين المسيحية والإسلامية، فأي أفضلية تتقوى بها الشرعية؟ التاريخ المشترك لهذه المدينة في كل الأديان، أم المستقبل المشترك لها كما تراه عقيدتا الإسلام والمسيحية . المهم، أن ذلك في العد اليهودي غير مهم، لأن القدس مدينة كاملة، يهودية الروح والاعتقاد والتاريخ والوجود، وإن ذهبنا بنفس الوتيرة لوجدنا أن روح اليهودية في شعبها كما تصورته مختاراً، واعتقاداً فإن موطن موسى في اعتقاد مساره الرسولي كان في مصر، ولم تكن القدس إلا محطة له، وعليه فقد كانت القدس كما كانت بفراعنتها قبل اليهود وهجرتهم إليها كان واضحاً في كل الكتب السماوية، إذ قطع البحر الأحمر كان معجزة تعترف بها كل الأديان، وعليه فهم وصلوها عبر "الهجرة الدينية" وليس عبر امتلاك أصولها أو بنائها، ودليلنا في ذلك : أن فترتها قبل /الملكية، والمعروفة بما قبل حكم داوود لم تكن إلا مدينة فوق الهضبة الجنوبية الشرقية، بإقرار توراتي وإقرار أركيولوجي، لأن سقي المدينة كان من عين جيهون، والهضبة تسمح الدفاع عن المدينة وتحصين هذا الماء (30)، وبالتالي فهي مدينة سليمة في الوقاية مع العدو، وفي العيش، لأنها أكثر قدرة في الدفاع عن نفسها (4)، وهذا يبطل جوهرياً دعوة أن القدس الشرقية بأي منحى "تاريخي" عبرية الأصل أو التكوين، بل دخلوا إليها وهي على موقعها المحدود بما بين 640 و 700 متر فوق سطح البحر، من الشمال يحدها رأس المشارف monut scopus (5) ومن الشرق جبل الزيتون . أنها محدودة بالأنهار طبيعياً وعلى كل الجوانب والضواحي (6) مما يفصلها عن غيرها كهضبة ويشق ما بين ويحدد موقعها ما قبل التوراة، فالقدس الكنعانية هي القدس الشرقية حالياً، بدليل الجغرافيا التاريخية للمنطقة . القدس الشرقية كنعانية الجغرافيا والتاريخ، على أن القدس المسيحية تتجه غرباً ولديها ما يثبت ذلك (7)، بل الأكثر من ذلك أن نواة القدس الجديدة (Veincent. F.M.Asel) ليس إلا ناتجاً عن توسيع النواة، فالقدس الغربية – كما يدعى في التسوية السياسية- ليست إلا امتداداً للقدس الشرقية، وعليه يريد الليكود أن يوسع نسيج الجانب الشرقي لتذويب التمركز التاريخي لهذا القطب، وعند تذويب التاريخ في الطرف الشرقي يسهل ابتلاع مركزية هذه البقعة على الأقل في رمزيتها . الأركيولوجيا القديمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القدس قبل أن تغزى من اليهود في هجرتهم من مصر، كان لها حكم محلي شبه مستقبل، كنعاني ولم يكن ملكياً، فقد عرف ملكان لهذه المنطقة: سطي عانو/ وايقاعاهو، ونطقهما كنعاني ومن أصول كنعانية في العهد البرونزي القديم، فتصارعوا مع المصريين ورفضوا أي هيمنة عليهم، ورغم خسارة عدة مدن كنعانية في الخارطة الشامية الساحلية، إلا أن القدس وحدها كانت ذات سيادة وحكم خاص، لأنها حافظت على استقلالها، إن في استقلالها المائي فترعها كانت دافقة، وإن في استقلالها السياسي فهي لا تهاجم ولكنها تدافع، لأن حكمها لم يكن ملكياً بأي شكل أو وراثياً على أي حال، وأهلها اتخذوا من استقلالهم وحكمهم شيئاً خاصاً بهم . اليهود إذن هم الذين أتوا بالحكم الملكي والحكم الرسولي في آن واحد، ولكن قبل ذلك كان حكماً خاصاً، دعي عند المؤرخين بالفترة ما قبل الملكية، وكأهم نموذج له "النموذج الكنعاني في القدس" مما يعني تاريخياً أن القدس كانت مستقلة عن أي سيادة، بما فيها السيادة المصرية التي تبيح لليهود أن يهاجروا من المركز إلى الهامش في نفس الدولة الفرعونية، بل إن استقلال هذا النموذج كان واضحاً ومتفرداً . القدس الشرقية كنعانية مع كل الجوانب حتى الجانب السياسي والسيادي، إذ استخدمت حكماً غير ملكي بهذه المدينة عكس الحاضرة المصرية، فأعطى ذلك لها خصوصية في عهدها (البرونزي القديم) . في التطورات السياسية للقدس عرفت السيطرة الفرعونية في القرن 15 قبل الميلاد، وهذا منحها شرف المقاومة من جهة وشرف قيادتها لحملة خاصة، بل إنها لحقت بالشريط الكنعاني لعدة مدن منها عسقلان (  ، فلا أحد ينكر غزوين، فرعوني/ ويهودي، على الرغم من أن الأخير أتى من المفهوم الديني / الإنساني الذي لم يكن له الشحنة السياسية، وهو نفسه ما جرى في إعادة التوطين اليهودي لفلسطين ما قبل 1948، تحت ما عرف بالوجود الطبيعي ليهود في المنطقة خصوصاً عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فالتأكيد على وجود سياسي، ديموغرافي، ومدني للقدس قبل اليهود خاصة في الزاوية الشرقية منها يجزم الحق الكنعاني فيها، ويعطي للوجود اليهودي أحقية "لا تاريخية" في القدس إلا من باب كونها أحد معالمهم الروحية . |
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

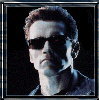

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:35 23/11/2010, 01:35 | |
| القدس كانت مدينة/ دولة، على شكل غزة … وغيرها، ورغم السيادة المصرية فإن استقلالاً ذاتياً كان سائداً وعملياً في هذه المدينة، ملكها أدوني صديق كما ورد في سفر التكوين 14/ 18 لم يكن إلا رمزاً سياسياً وإدارياً لها، ومن المحتمل أن يكون هذا الشخص سليل عائلة "ملش سديش" هذا الملك دافع بقوة عن حدودها حتى تكون في عهده ضد الأجانب، وذات استقلال نوعي على حدودها القبلية (الحكمة 1/21). فالقدس كانت مدينة/دولة (9) عند جميع المؤرخين المنصفين، وقد ازدادت قوتها عندما حكمها النظام الملكي لداود، والذي لم يبدأ منها بل من الخليل التي حكم بها سبع سنين وست أشهر، آنذاك قرر أن يفتح القدس، وقد قاومته بقوة، وحين دخلها وجدها على الساحة الشرقية (القدس الشرقية الآن) باتجاه الجنوب، والوصف دقيق في سفر صموئيل الثاني (إصحاح 3 من 4 إلى 9)، إذ اعتبرت مدينة رهيبة أو ذات أسرار، وقد وجد بها نفق كان الكنعانيون يدافعون به عن مدينتهم، ولم يستطع داوود أن ينتصر على أهلها إلا بعد انكشفت قناتهم المائية من عين "جيهون" فقطعها عليهم، وقد كانت وحرب العطش ((هي الوسيلة التي انتصر بها الإسرائيليون قديماً على الكنعانيين، وقد حذف من النصف العبراني أي وصف دقيق لهذه الحركة وأي تدقيق لمدتها، ولم يذكر إلا أنهم وصلوا إلى قطع الماء عن أهلها)).
ولا خير في ذلك إن أدركنا أن "النص الديني" لم يفتح على نفسه منطق التسلسل التاريخي وتجاوز ذلك إلى اعتبار الصورة التاريخية هدفاً دينياً بذاته، وهنا لا يستوفي المنطق الخاص المنطق الشامل، وعلى كل فإن ما يؤكده النص التاريخي/ الديني لدليل كبير على الاستماتة العظمى لهذه المدينة، ودليل كنعانيتها توراتي قبل أي شيء .
القدس الغربية هي المدينة الجديدة التي بناها داوود لنفسه، واعتبرت مدينة داوود، وخرجت المدينة من طابعها السلمي للكنعانيين إلى طابعها الديني/ السياسي للعهد الداوودي، بل أكثر من ذلك، لقد بنى بها مدينة جمة وقصراً كبيراً مستعيناً بخبرة من كانوا عند الملك حيرام في مقابل التحالف معه، لتكون القدس بداية الحكم الملكي في إسرائيل، والذي أعطى فيما بعد "الحق الوراثي" في الحكم، والحق الوراثي في الدين، فيتحول الأول إلى النظام الملكي في التاريخ السياسي للإنسانية، ويتحول الثاني إلى "شعب الله المختار" في حق شعب الله يسود ذلك التاريخ الديني بكامله .
في عهد سليمان استطاع الأخير أن يكرس حكمه بالهيكل الذي بناه بمساعدة السكان الأصليين، وكان ذلك لتوطين وجوده، ففي صموئيل الأول يتأكد من أن اسم الهيكل ومكوناته لم تكن إلا لتفعيل العبادة الطقوسية والنسكية لهذا الشعب، فتأسس على ذلك شارع جديد ومساكن جديدة "ملكية" بتعبير سفر الملوك الأول (9/16)، وهنا سليمان سعى إلى توحيد المدينة في قطب واحد وتحت إمرة واحدة، فجمع الهيكل إلى مدينة داوود، واستولى على محيط المدينة من حدود جبل الزيتون، فأصبحت عاصمة يهودا .
الحكم الداوودي للمدينة (تاريخياً وفي التاريخ الديني) لم يستطع أن يكرس حكمه فيها، وبنى على جانبها الغربي مدينة يحكم منها، وسليمان من بعده هو من وحدها وأخضعها كلياً وأعلنها عاصمة لشعبه ودولته، فهل ذلك يعني أن العهد السليماني هو الحد الفاصل في التاريخ الديني للوجود اليهودي والسيطرة العبرية على المدينة؟ إن ذلك ما هو محقق، وعتاة الليكوديين يطلبون وحدتها كما وحدها سليمان وحكم منها واتخذها عاصمة لهذا الشعب، لكن أمام الحقيقة التاريخية، فإن إرجاع الحق إلى أهله ضرورة، إذ الأصل الكنعاني والحكم الداوودي المتوازن الذي آمن بمدينة له، حكم منها، ومدينة عتيقة شرقية حافظت على شعبها وهويتها الحضارية هي الحدود الحقيقية للتسوية السياسية/الدينية التي يمكن أن يقبل بها أحفاد الكنعانيين "العرب وأحفاد سليمان "اليهود" .
هوية القدس الكنعانية الأصلية ضمانة حقيقية للحق الفلسطيني التاريخي في القدس، خصوصاً وأن التاريخ يثبت وجود مدينتين طول تاريخ هذه المدينة/ اللغز:
مدينة شرقية/ عتيقة يقطنها السكان الأصليون، المدافعون عن هويتها، وينتفضون دائماً باتجاه عدم إخضاعها لأي مسيطر .
مدينة غربية يدخلها الغريب أو المحتل، ومن هناك يحاول أن يلتهم الأحياء القديمة والحضارة والسابقة، ويخضع الأصليين من أهلها .
القدس بكل المعاني لم تكن موحدة منذ البداية ولم يكن وجودها أو تأسيسها عبرانياً أبداً، بل إعادة هيكلة الجانب الغربي منها هو الوحيد الذي كان إسرائيلياً بحتاً، والجانب الشرقي منها كان دائماً محطة لأهلها في تفاعلهم مع أديان جديدة، المسيحية كانت ذات قوة في الجانب الأصلي/ الشرقي من المدينة، وحين أتى الإسلام اعتنق أهلها هذا الدين. الجانب الشرقي كان موطناً لشعب أصيل اتخذ أي بديل ديني/ سياسي من أجل مواجهة الانخراط في التذويب طول فترات انتقالية تحت حكم متعدد لكل قوى العالم التي مرت حاكمة لأجزاء كبيرة من البسيطة، فالليكوديين لا يجب أن يتخذوا القطيعة مع التاريخ الإنساني، أو الكوني، وليقتنعوا أن الوقوف عند وحدة سليمان للمدينة خطأ تاريخي .
الهوامش
K.M. Kenyon: Jerusalem: Excauating 3000 years of history. London 1967 .
Ezechiel : 48: 35 .
Y.Yadin: Jerusalem revealred: Archaeology in the holy city 1967 – 1974 .
L.E.Stager: the Archaeology of the east slope of jerusalem and the Terraces of the kigron, jounal of near eastern shelies, 41, 1982 p: 112 .
E.Otto: Jerusalem Die Geschichte der Heliligen stadt von den anfangen 1 is zur kreuf fahrer – zeit, shittgart, and 1980.
A L ‘Est wadi en nar, au sud a l’ouest, valee d’hinom avee wadi er rabalesh, a L’ouest wadi el wad, mieuxvoin, G, Sechmitt, Die dritte fauer Jeu salems, Zeit schrift der Dent schen palastina, vereins, zeit wende, no 97, 1981, p 123-170.
L’Eglise du sanit sepulers a nord et la sion chretienne an sulom voir jerusalem nowelle par L.H. VIN cent, Paris 1912.
J.R Batlett, Edum and the Fall of jerusalem, palestine Exploration Quar terley, 114, 1982 .
Voir, j.w. crowfoot fitz gerald, Excarations in the turopeon valley Jerusalem, 1976, et.L.H. Vincent/ A.stexe. Jerusalem de L’anccien Testament, Paris 1956 .
* القدس العربي 27/12/1997م
|
|   | | سامح الغندور
عضو فعال

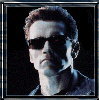

عدد الرسائل : 167

بلد الإقامة : الأسكندرية
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 6384
ترشيحات : 1
 |  موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق موضوع: رد: القدس : تاريخ و وثائق  23/11/2010, 01:36 23/11/2010, 01:36 | |
| القدس في ضوء قرارات اللجان البريطانية والدولية
1917 – 1947 إعداد الدكتور محمد ماجد الجزماوي
أستاذ مساعد – قسم التاريخ – جامعة الخليل – فلسطين بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، وإعلان الدولة العثمانية وقوفها إلى جانب ألمانيا، أخذت دول الحلفاء تتفق فيما بينها لتقاسم ممتلكات الدولة العثمانية، كما بدأت بريطانيا بالتفكير في السيطرة على فلسطين، مستغلة في ذلك الضعف العسكري للجيش العثماني، وحتى تتمكن أيضاً من تشتيت القوة العسكرية لألمانيا وإشغالها في عدة جبهات. وقد تمكن الجيش البريطاني بقيادة الجنرال أدموند اللنبي E. Alley من احتلال كافة الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 1917 حتى أيلول 1918، فقد احتل بئر السبع في 31 تشرين الأول 1917 وغزة في 9 تشرين الثاني 1917، ويافا في 16 تشرين الثاني 1917، والقدس في 9 كانون الأول 1917، أما القسم الشمالي من فلسطين فقد بقي تحت السيادة العثمانية حتى احتلت القوات العسكرية البريطانية نابلس في 20 تشرين الأول 1918، وحيفا وعكا في 23 تشرين الأول 1918 (1) وهكذا انتهى الحكم العثماني لفلسطين بعد حكم امتد أربعمائة سنة. وبنهاية عام 1918 وبانتهاء الحكم العثماني لفلسطين أصبحت البلاد تدار بإدارة عسكرية بريطانية أطلق عليها اسم "الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة" واتخذت من مدينة القدس مقراً لها وعملت تحت سلطة حاكم إداري عام كان يتلقى أوامره من القائد العام الجنرال اللنبي، باعتباره المرجع الأعلى في المسائل الرئيسة، إذ أنه كان يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية التي كانت تنفذ التعليمات وأوامر ووزارة الخارجية (2) . وكانت الحكومة البريطانية قد تنكرت للوعود التي قطعتها للشريف حسين خلال مراسلات الحسين مكماهون (1915-1916) بشأن الاستقلال إذ قامت بإجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الفرنسية حول مصير البلدان العربية التي كانت تحت الحكم العثماني، وتمخضت هذه المفاوضات عن التوقيع على اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين الحكومتين وبموجبها كانت العراق وشرق الأردن وسواحل الجزيرة العربية الشرقية الجنوبية من نصيب بريطانيا. بينما اختصت فرنسا بسورية ولبنان، أما فلسطين فقد نصت الاتفاقية على وضعها تحت إدارة خاصة وفقاً لاتفاقية تعقد بين روسيا وفرنسا وبريطانيا كما منحت الاتفاقية بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون ميناء حيفا حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها (3) . أخذت الإدارة العسكرية تعمل على تهيئة فلسطين بشكل تدريجي حتى تصبح وطناً قومياً لليهود، فاتبعت سياسة علنية موالية للحركة الصهيونية إذ قامت بتضييق الخناق الاقتصادي على عرب فلسطين وخاصة الفلاحين منهم وتهويد الوظائف الحكومية، وفتح الأبواب أمام تدفق المهاجرين اليهود (4)، وغير ذلك من الأساليب لإرساء الدعائم الأولى للوطن القومي اليهودي وتنفيذ وعد بلفور . ولم يكن عرب فلسطين بمنأى عن هذه السياسة، فقد أدركوا مدى تحيز ومحاباة الحكومة البريطانية تجاه اليهود مساندتها لمطالبهم في الاستيطان والهجرة ونزع الأراضي من أصحابها العرب، فكان لا بد من أن يكون ردة فعل من عرب فلسطين إزاء هذه السياسة، وقد تمل ذلك في الاضطرابات التي وقعت في مدينة القدس خلال الفترة ما بين 4 – 8 نيسان 1920 أثناء احتفال المسلمين بموسم النبي موسى (5)، الذي تصادف مع الاحتفالات الدينية للمسيحيين واليهود، وخلال هذا الاحتفال وقعت الاشتباكات بين العرب واليهود أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من كلا الجانبين، وقد أظهرت هذه الأحداث مدى تحيز بريطانيا تجاه اليهود إذ قامت الشرطة البريطانية باستخدام كافة أساليب القمع والتنكيل بحق العرب، وقد اتهمت الحكومة كلاً من موسى كاظم الحسيني والحاج أمين الحسيني وعارف العارف بإثارة تلك الاضطرابات، فحكمت على الأخيرين بالسجن غيابياً لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة غير أنهما تمكنا من الفرار إلى شرق الأردن، وعزلت موسى كاظم الحسيني عن منصبه في رئاسة بلدية القدس وعينت راغب النشاشيبي بدلاً منه (6) . قامت الحكومة البريطانية على أثر هذه الاضطرابات بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية لدراسة الأسباب التي أدت إليها، وكانت هذه اللجنة برئاسة الجنرال بالين palin وقد أصبحت تعرف باسمه، وقد جال في التقرير النهائي للجنة أن أسباب الاضطرابات تعود إلى الأمور التالية : خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ وتحقيق وعود الاستقلال التي منحت لهم خلال الحرب العالمية الأولى . اعتقاد العرب بأن وعد بلفور يتضمن إنكاراً لحقهم في تقرير مصيرهم وخوفهم من أن إنشاء الوطن القومي يعني الزيادة الهائلة في الهجرة اليهودية التي ستؤدي إلى إخضاعهم للسيطرة اليهودية من الناحية الاقتصادية والسياسية . ازدياد حدة الشعور بالقومية العربية نظراً لوجود الدولة العربية في دمشق والتي كانت موئلاً للآمال العربية (7) . في مؤتمر سان ريمو 1920 قرر المجلس الأعلى للحلفاء منح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، وبناء على ذلك عينت الحكومة البريطانية السير هربرت صموئيل Herbert Samuel الصهيوني البريطاني مندوباً سامياً على فلسطين وحولت الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية، وكانت في بداية الأمر تحت رقابة وزارة الخارجية البريطانية ثم أصبحت تتبع مباشرة وزارة المستعمرات وأطلق عليها اسم "حكومة فلسطين" واتخذت من مدينة القدس مقراً لها (  . استمرت ولاية صموئيل في فلسطين لمدة خمس سنوات قام خلالها بإصدار العديد من الأنظمة والتشريعات لصالح اليهود، وكان أكثر الأنظمة خطورة في تغيير الوضع القائم في فلسطين هي تلك المتعلقة بالأراضي والهجرة (9)، وذلك لتسهيل الهجرة اليهودية وتمليك اليهود مساحات واسعة من الأراضي، كما منح المؤسسات اليهودية العديد من الامتيازات والمشاريع الاقتصادية حتى يتمكنوا من السيطرة على الموارد الاقتصادية في فلسطين، منها امتياز العوجا الذي منح لبنحاس روتنبرغ Pin Rutinbury hass لاستخدام مياه العوجا لتوليد الطاقة الكهربائية عام 1921، وامتياز شركة الكهرباء الفلسطينية عام 1923 لاستخدام مياه نهر الأردن واليرموك لتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها، وامتياز استخراج الأملاح والمعادن من البحر الميت عام 1925(10) . وفي 22 حزيران عام 1922 أصدر وزير المستعمرات ونستون تشرشل Winston Churchill بياناً بشأن السياسة البريطانية تجاه فلسطين عرف باسم "الكتاب الأبيض" حيث أكد بأن وعد بلفور لا يعني "تحويل فلسطين بجملتها وجعلها وطناً قومياً لليهود بل إنما يعني بأن وطناً كهذا يؤسس في فلسطين"، غير أنه أكد أن هذا التصريح الذي حظي بتأييد دول الحلفاء في مؤتمر سان ريمو ومعاهدة سيفر (11)، غير قابل للتغيير، وأشار إلى أن ترقية الوطن القومي اليهودي في فلسطين لا يعني فرض الجنسية اليهودية على أهالي فلسطين بل زيادة رقي الطائفة اليهودية بمساعدة من جمع اليهود في مختلف أنحاء العالم. إلا أنه بين أن وجود الشعب اليهودي في فلسطين هو حق وليس منة مما جعل ضمان إنشاء الوطن القومي اليهودي ضماناً دولياً، كما أنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة، كما تضمن الكتاب استمرار الهجرة اليهودية مع مراعاة القدرة الاقتصادية للبلاد على استيعاب المهاجرين. ونص على تشكيل مجلس تشريعي للبحث مع الإدارة في الأمور المتعلقة بتنظيم المهاجرة، وأخيراً بين الكتاب استثناء فلسطين من الوعود التي قطعتها الحكومة البريطانية للشريف حسين بشأن الاستقلال (12) . وهكذا فقد جاء الكتاب الأبيض ليؤكد تصميم الحكومة البريطانية تنفيذ وعد بلفور وإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين دون الاكتراث بمطالب عرب فلسطين فيما يتعلق بإلغاء وعد بلفور ووقف الهجرة وإقامة الحكومة الوطنية فإذا كان القصد منه تطمين العرب وتهدئة مخاوفهم فقد زادهم قلقاً وخيب آمالهم . وفي 24 تموز 1922 أقر صك الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم (13) وجاء الصك في مقدمة و 28 مادة كان معظمها لصالح اليهود والوطن القومي اليهودي، فقد تضمنت المقدمة نص تصريح وعد بلفور ومصادقة عصبة الأمم على الانتداب البريطاني على فلسطين وتخويل بريطانيا بتنفيذ الوعد، وتضمن الصك مواداً تتعلق بإنشاء الوطن القومي اليهودي والاعتراف بوكالة يهودية لتكون هيئة عامة لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي، ويعترف الصك بالجمعية الصهيونية كوكالة دائمة شريطة موافقة الدولة المنتدبة على دستورها (مادة 4) وحدد مسؤوليتين للانتداب البريطاني الأولى تتطلب أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي. والثانية ترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بغض النظر عن الجنس والدين (مادة 2)، وطلب من إدارة فلسطين أن تعمل على تسهيل الهجرة اليهودية في أحوال ملائمة وتشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية الاستيطان اليهودي في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية (مادة 6) . وتضمن الصك أربع مواد تتعلق بالأماكن المقدسة والحفاظ عليها، فقد أنيط بالدولة المنتدبة جميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن والمباني والمواقع المقدسة في فلسطين وضمان الوصول إليها (مادة 13)، وتشكيل الدولة المنتدبة بموافقة من مجلس عصبة الأمم المتحدة لجنة لدارسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والطوائف الدينية المختلفة في فلسطين (مادة 4)، ويترتب على الدولة ضمان الحرية الدينية لجميع الطوائف شريطة المحافظة على النظام العام والآداب العامة دون تمييز بين السكان على أساس الجنس أو الدين أو اللغة (مادة 15)، وتكون مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزائية التابعة لجميع الطوائف الدينية المذهبية في فلسطين، ولا يجوز اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تعمل على إعاقة أعمال هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التمييز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسه (مادة 16) . ويتضح من مواد الصك أنها صيغت بشكل يخدم السياسة الصهيونية ويكفل إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، فالانتداب جاء ليخدم مصالح الشعوب والدول التي تخضع له حتى تصل إلى مرحلة النضج السياسي والاستقلال التام وليس لتنفيذ وعود سياسية قطعتها على نفسها حكومة الدولة المنتدبة قبل إقرار مبدأ الانتداب من عصبة الأمم. وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة الثانية من صك الانتداب تضمنت تعهدين متناقضين لا يمكن التوفيق بينهما إذ ليس من المعقول أن توضع فلسطين في ظروف خاصة لصالح اليهود وهم أقلية دون المساس بحقوق العرب الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان (14) . كما تجاهلت مواد الصك مبادئ الرئيس الأمريكي ولسن Wilson بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي أوفدت من أجلها "لجنة كنج – كرين" king – crane عام 1919 حيث كان من ضمن توصياتها رفض إقامة الوطن القومي اليهودي والعدول عن الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة يهودية، واستنتجت بأنه من المستحيل أن يوافق المسلمون والمسيحيون على وضع الأماكن المقدسة تحت رعاية اليهود وذلك لأن "الأماكن الأكثر تقديساً عند المسيحيين هي ما له علاقة بالمسيح والأماكن المقدسة التي يقدسها المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل مكروهة" وبذلك اقترحت اللجنة وضع الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دولة دينية تكون بإشراف الدولة الوصية وعصبة الأمم (15) . وبعد أسبوعين من موافقة عصبة الأمم على صك الانتداب البريطاني لفلسطين أصدرت الحكومة البريطانية دستوراً لفلسطين في 10 آب 1922 وأصبح نافذ المفعول في 11 أيلول 1922 واشتملت مقدمته على نص تصريح وعد بلفور. وتضمن إنشاء مجلس تشريعي يكون برئاسة المندوب السامي لا تنفذ قوانينه إلا بموافقته، وأعطى المندوب السامي صلاحيات واسعة تتمثل في إصدار القوانين والإشراف على الأراضي العمومية وتعيين الموظفين وعزلهم ومنح العفو وإبعاد المجرمين السياسيين (16) . ومن الواضح أن السلطة العليا وفق الدستور كانت بيد المندوب السامي، بينما لم يكن للعرب الفلسطينيين أية سلطة تذكر حتى أن المجلس التشريعي كانت صلاحياته مقيدة بإدارة المندوب السامي، وبالتالي فلم يكن لهذا المجلس سلطة تنفيذية على الإطلاق وذلك كان من الطبيعي أن لا توافق اللجنة التنفيذية العربية على هذا الدستور . ومهما يكن من أمر فإن حكومة الانتداب البريطاني استمرت في نهج السياسة الرامية لبناء الوطن القومي اليهودي وتمثلت هذه السياسة في تشجيع الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، والعمل على تسخير القوانين لصالح اليهود وتضييق الخناق الاقتصادي على العرب بالإضافة إلى رفض مطالب عرب فلسطين بشأن التمثيل السياسي وإقامة حكومة وطنية، مما أدى إلى ازدياد حدة التوتر لدى العرب خاصة بعد محاولات اليهود الاعتداء على المقدسات الإسلامية وأراضي الأوقاف في مدينة القدس، الأمر الذي أدى إلى ازدياد نقمة الفلسطينيين على الحكومة . ثورة البراق 1929 كان السبب الرئيسي في الصدامات التي وقعت بين العرب واليهود. عام 1929 يعود للخلافات بين الطرفين حول حائط البراق الذي يعتبر مكاناً مقدساً لدى المسلمين واليهود والبراق مكان صغير ملاصق لجدار الشريف في القدس وقد جرت التقاليد الإسلامية على اعتباره المكان الذي ربط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البراق ليلة الإسراء فاصبح يعرف عند المسلمين بالبراق (17) كما أن الجهات الخارجية التي تحيط بالبراق هي أوقاف إسلامية منذ 700 سنة دون انقطاع ويعتبر أيضاً الحرم الشريف مكاناً مقدساً وملكاً للأمة الإسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف القرن (18) . أما بالنسبة لليهود فيشكل الحائط جزءاً من الحائط الخارجي الغربي لهيكل اليهود القديم ويقدسونه باعتباره البقية الباقية من ذلك المكان المقدس**، فقد اعتاد اليهود منذ العصور الوسطى على زيارة هذا المكان في المناسبات الدينية خاصة يوم الصيام المعروف بيوم "تسعة آب" والذي يحتفل به بذكرى خراب آخر هيكل لليهود من قبل هيرودس (19) . وقد جرت العادة أن يسمح لليهود بزيارة البراق والبكاء على خراب هيكل سليمان دون أية معارضة من قبل المسلمين وذلك من باب التسامح الديني ومن باب أنها مجرد شعائر يؤدونها دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في هذا المكان (20) . |
|   | | |
مواضيع مماثلة |  |
|
| | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|