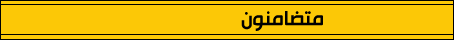الدرس الفولتيري في الزمن العربي؟

العالم لم يتغير كثيرا، فقد ظل الجوهر هو هو في أغلب مواصفاته العنيفة، منذ أصبحت الخليقة عاقلة وتسير على رجلين متخلية عن كل ما يسحبها نحو الحيوانية من الناحية الجسمانية، ولو أن العقل الإنساني لم يتبع دوما هذه التحولات. في كل حركة نقوم بها، نحتاج في حياتنا اليومية إلى كمّ كبير من التسامح لنستمر في الحياة، وأخذ الناس والبشر في حدود عقولهم، لتستمر الحياة بشكل أجمل، وتفادي السقوط في ردود الفعل التي ليست في النهاية إلا استجابة للعقل الباطني المثقل بذاكرة ليست دائما جميلة.
كثيرا مثلا ما يطأ حذاءك شخص لا فرق بينه وبين التيس، لا يكلف نفسه حتى كلمة عفوا. ويمر وكأن الأمر لا يخصه أبدا، وإذا نبهته قد يعطيك درسا شموليا في الحياة والأخلاق، وتتحول إلى أقل من بائس لا يعرف إتيكيت التعامل مع الحياة. وقد يتجاوزك سائق مجنون، ويكاد يرميك على حافة الطريق، فتفرمل سيارتك لكي لا تمس سيارته وترتكب حادثا، فينزل منها، ويتهمك بكل الأوصاف، أقلها الجنون والعمى.
ولا حلّ أمامك إلا التسامح واعتباره مجنونا في النهاية، وبلا أدنى مخ. فتعتذر أنت منه، ويعود إلى سيارته كمن حقق انتصارا عظيما في مشهد ظالم من بدايته إلى نهايته. تتنازل عن حقك في الاحتجاج لأنك تعرف سلفا أن الحوار في مثل هذه الحالة لا يصل إلى أية نتيجة. بل قد تكون نتائجه وخيمة وخطيرة أيضا. شخص تناقشه كما هي عادات النقاشات اليومية، تنطلق أنتَ من فرضيات هي في النهاية مجرد احتمالات، بينما يتحرك هو داخل يقينيات يريد فرضها بالصوت العالي، وهي خالية من أية صحة. وإذا أصررتَ على الاختلاف يصل الأمر إلى الشتم، وينتهي أحيانا إلى الكراهية وربما إلى ما هو أكثر. في كل هذه الحالات وغيرها، عليك أن تلبس قبعة الحكيم، أو الرجل المقتنع بذاته داخليا وغير المهتم بيقينيات الآخرين التي يعرف عميقا أنها لا تؤدي في النهاية إلى أي شيء، فتتنازل عن حقك وتمضي لأنك تعرف سلفا بأن اليقين الأعمى لا ينتهي إلا إلى عمى آخر أكثر سوءا.
المشكلة لا تكمن فقط هنا، لو توقفت عند هذا الحد لهانت، فهي تتعدى هذه الخيارات وتصل إلى ما هو أكبر عندما تمس قضايا إنسانية واسعة وأمما بكاملها. تفتك بالشعوب بسبب خلافات عرقية ودينية وإثنية وغيرها، تحصد الآلاف، بل الملايين. جوهرها نفس الإنسان الذي لا يستمع في النهاية إلا إلى يقينه. مع أن الناس، لو فكروا ثانية واحدة، وتعقلوا قليلا، لأنقذوا أممهم من خراب أكيد. إن التسامح يقرّب الخلافات مهما كانت الخسائر، ويخضعها للعقل وسعادة الإنسان، واللاتسامح هو سلاح الجاهل حينما يتم تغييب العقل. لنا في التاريخ البشري نماذج أعطتنا درسا في التسامح كم نحتاج له اليوم لنستفيد منه، لأن زمننا بكل مواصفاته الحالية يشبه الزمن الماضي في أوروبا التي انتقلت من اليقين القاتل إلى النسبية الفعالة ثقافيا وتاريخيا. يحضرني مثال فولتير الذي دافع عن التسامح لدرجة أنه وضع حياته في خطر القتل والانتقام، لكنه لم يتراجع قيد أنملة واحدة عن رؤيته، لأنه كان يدرك جيدا أن لا خيار إلا خيار الإنسان في النهاية، والوقوف ضد كل ما يبتذله ويسرق منه حقه في الحياة. وجعل من ذلك قضيته المركزية، بل جوهر حياته كلها. أليس هو صاحب مقولة: قد أختلف معك في الرأي، لكني مستعد لأدفع حياتي ثمنا من أجل أن تدلي برأيك. لا يزال، إلى يومنا هذا، بحثه الصغير والمكثف: مقالة في التسامح Traité sur la Tolérance ، إنجيل كل من يطرح هذه الموضوعة في أفق السجال، وميثاقا حيويا بين الإنسان وأخيه الإنسان. فقد رافع فولتير باستماتة، من أجل الإخاء ووقف ضد التزمت والتصلب في الرأي والتعصب الديني، في زمن أوروبي كان طعما للحروب الدينية الفتاكة بين الكاثوليك الذين يشكلون القوة المهيمنة، والبروتستانت الضعفاء، لكن الشرسين في الدفاع عن خياراتهم الدينية، في ظل كنيسة، وسلطة كهنوتية كان لا بد من القطع معها نهائيا لتجد أوروبا مسلكها الحقيقي، أي الديني الخاص والفردي. سيحدث ذلك لاحقا حينما نقل التنويريون من أمثال روسو وديدرو والموسوعيون، أوروبا نحو فضاءات الحرية والنور والتسامح والخير والعقل، وأخرجوها من مجتمع القنانة الدينية الذي فرضته الكنيسة لا بسلطانها الروحي ولكن بجهازها القمعي: محاكم التفتيش المقدس. ففي مرافعته دفاعا عن عائلة كالاس، بيّن فولتير إلى أي حد كان اللاتسامح والتعصب الأعمى جهازا للموت والإبادة. فجعل من كالاس الأب الذي قتل ظلما فقط لأنه بروتستانتي بتهمة قتل ابنه بحجة اعتناق هذا الأخير الكاثوليكية، جعل فولتير من الحادثة المؤلمة وسيلته للدفاع عن الحق والنور والتسامح الديني وسط ظلمة مستشرية، ليبين في النهاية أن كل ما حدث ضد هذه العائلة كان تركيبا وعدوانية بسبب قناعات الأب البروتستانتية. فالشاب لم يُقتل من طرف والده لأنه خان دينه واعتناقه الكاثوليكية، لكنه انتحر لأنه كان هشا من ناحية تركيبته النفسية.
وأن رب العائلة الذي نُفذ فيه حكم الإعدام كان مظلوما ويجب حماية بقية العائلة من عدوان ديني مؤسساتي. لهذا لم ينج فولتير من ملاحقات السلطات الملكية والكنسية الكاثوليكية المهيمنة على عقول الشعب الفقير والمتواطئة في ما بينها ضد الحق. راهن فولتير على فئات الشعب الواسعة التي كانت قد بدأت وقتها تتحول عميقا بسبب تراكمات القهر والظلم: إذا كنتم تعتبرون أن عدم الاعتقاد بالدين المهيمن أو دين الغالبية يمثل جريمة، فإنكم بهذا الفعل تدينون آباءكم من المسيحيين الأوائل، يوم كانوا أقلية في الإمبراطورية الرومانية، بل وتبررون اضطهادهم وتعذيبهم آنذاك. فأنتم ترون أن كل المذاهب من صنع البشر إلا الكاثوليكية البابوية الرومانية، فهي من صنع الله. على فرض أن كلامكم صحيح، فهل ينبغي أن يهيمن ديننا من منطلق الحقد والعنف والتعذيب والإرهاب، فقط لأنه الأقوى؟ فكلما كان الدين المسيحي إلهيا، أصبح ممنوعا على الإنسان أن يتحكم فيه كما يشاء. فالله قادر على حمايته وتدعيمه من دونكم. تعلمون أن التعصب لا يلد إلا المنافقين الدينيين والقتلة. لم تكن صرخة فولتير هباء، فقد وجدت من يأخذ بها وينقذ أوروبا من ظلام القرون الوسطى القاهر. كم لنا في الدرس الفولتيري اليوم من فائدة لو استطعنا الإصغاء له كما يجب. كان مؤمنا بما كان يقوله، فلم يتراجع عن قناعاته الإنسانية حتى في أحلك لحظات الخوف والمطاردة الكنسية البابوية. التسامح وتسيد العقل والإصغاء إلى الآخر المختلف التي نادى بها، كلها قيم غيرت في ميزان القوى الأعمى ومنحت أوروبا فرصة لأن تعيد ترميم نفسها بقوة والخروج من دائرة القتل والصراع المر الذي لا يفضي إلا إلى المزيد من الموت الحقيقي والرمزي والانتفاء والهلاك. ونحن نتأمل هذه الظواهر اليوم ونصغي بقوة إلى رهانات فولتير التسامحية، ينتابنا هذا اليقين الغريب، ما أشبه أوروبا البارحة بالعالم العربي اليوم الغارق في عصر التفككات والظلام المستشري وتغييب العقل. أليست داعش اليوم إلا الوجه الآخر لكنيسة قروسطية، امتلكت الحقيقة الإلهية وأصبحت تسيرها وفق جنونها وشهواتها؟ أليست جرائم داهش إلا الوجه الآخر لكنيسة زكت جريمة قتل رب عائلة كالاس الفقيرة والمعدمة، البريء من التهم التي نُسبت له؟
واسيني الأعرج
القدس العربي