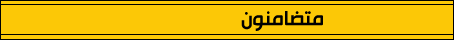تفسير قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمونولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما .
روى ابن جرير أن عكرمة قال : نزلت هذه الآية في غزوة أحد كما نزل فيها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ( 3 : 140 ) ، حين باتوا مثقلين بالجراح ، أقول : وقبل آية آل عمران هذه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ( 3 : 139 ) ، [ راجع ص 119 وما بعدها من ج 4 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ] ، فالظاهر أن عكرمة ذكر مسألة ( أحد ) رواية عن ابن عباس واستنبط من موافقة معنى الآية التي نحن بصدد تفسيرها لآية آل عمران أنها نزلت مثلها في غزوة أحد ثم جاء الجلال فنقل رأي عكرمة بالمعنى من غير عزو فأخطأ في تصويره إذ قال : إنها نزلت " لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات " وقد رد قوله الأستاذ الإمام في الدرس فقال : المعروف في القصة أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا بعد غزوة أحد يرغبون اقتفاء أثر أبي سفيان على إثقالهم بالجراح ، ولا حاجة في فهم الآية إلى ما ذكر بل هو مناف للأسلوب البليغ إذ القصة ذكرت في سورة آل عمران تامة ، وهذه جاءت في سياق أحكام أخرى .
ثم قال : كان الكلام فيما سبق في شأن الحرب وما يقع فيها وبيان كيفية الصلاة في أثنائها [ ص: 317 ] وما يراعى فيها إذا كان العدو متأهبا للحرب من اليقظة وأخذ الحذر وحمل السلاح في أثنائها ، وبين للمؤمنين في هذا السياق شدة عداوة الكفار لهم وتربصهم غفلتهم وإهمالهم ليوقعوا بهم ، بعد هذا نهى عن الضعف في لقائهم ، وأقام الحجة على كون المشركين أجدر بالخوف منهم ; لأن ما في القتال والاستعداد له من الألم والمشقة يستوي فيه المؤمن والكافر ، ويمتاز المؤمن بأن عنده من الرجاء بالله ما ليس عند الكافر ، فهو يرجو منه النصر الذي وعد به ، ويعتقد أنه قادر على إنجاز وعده ، ويرجو ثواب الآخرة على جهاده لأنه في سبيل الله ، وقوة الرجاء تخفف كل ألم وربما تذهل الإنسان عنه وتنسيه إياه اهـ .
أقول : فالآية تفسر هكذا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ، أي : عليكم بالعزيمة وعلو الهمة مع أخذ الحذر والاستعداد حتى لا يلم بكم الوهن - وهو الضعف مطلقا أو في الخلق أو الخلق كما قال الراغب في ابتغاء القوم الذين ناصبوكم العداوة أي طلبهم ، فهو أمر بالهجوم بعد الفراغ من الصلاة ، بعد الأمر بأخذ الحذر وحمل السلاح عند أدائها ، وذلك أن الذي يلتزم الدفاع في الحرب تضعف نفسه وتهن عزيمته ، والذي يوطن نفسه على المهاجمة تعلو همته ، وتشتد عزيمته ، فالنهي عن الوهن نهي عن سببه ، وأمر بالأعمال التي تضاده ، فتحول دون عروضه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ; لأنهم بشر مثلكم ، يعرض لهم من الوجع والألم مثل ما يعرض لكم ; لأن هذا من شأن الأجسام الحية المشترك بينكم وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون لأنكم تعلمون من الله ما لا يعلمون ، وتخصونه بالعبادة والاستعانة وهم به مشركون ، وقد وعدكم الله إحدى الحسنيين النصر أو الجنة بالشهادة إذا كنتم للحق تنصرون ، وعن الحقيقة تدافعون ، فهذا التوحيد في الإيمان ، والوعد من الرحمن هما مدعاة الأمل والرجاء ، ومنفاة اليأس والقنوط ، والرجاء يبعث القوة ، ويضاعف العزيمة ، فيدأب صاحبه على عمله بالصبر والثبات ، واليأس يميت الهمة ، ويضعف العزيمة ، فيغلب على صاحبه الجزع والفتور ، فإذا استويتم معهم في آلام الأبدان ، فقد فضلتموهم بقوة الوجدان ، وجرأة الجنان ، والثقة بحسن العاقبة ، فأنتم إذن أجدر بالمهاجمة ، فلا تهنوا بالتزام خطة المدافعة ، وكان الله عليما حكيما وقد ثبت في علمه المحيط ، واقتضت حكمته البالغة ، ومضت سنته الثابتة ، بأن يكون النصر للمؤمنين على الكافرين ، وما داموا بهديه عاملين ، وعلى سننه سائرين ; لأن أقل شأن المؤمنين حينئذ أن يكونوا مساوين للكفار في عدد القتال وأسبابه الظاهرة وهم يفضلونهم بالقوى والأسباب الباطنة ، وإذا أقاموا الإسلام كما أمر الله - تعالى - أن يقام ، فإنهم يكونون أشد للقتال استعدادا ، وأحسن نظاما وسلاحا .
فهذه الآية برهان علمي عقلي على صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر ، وقد بينا هذه المسألة من قبل في التفسير وغير التفسير من مباحث المنار ، ونقلنا في الكلام على حرب الإنكليز لأهل الترنسفال [ ص: 318 ] اعتراف الأوربيين بكون الإيمان من أسباب النصر في الحرب ، فما بال المسلمين في أكثر البلاد لا يحاسبون أنفسهم بعرضها على القرآن ، والنظر فيما بينه من مزايا الإيمان ! ؟