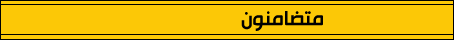عبير عبد القوى الأعلامى
نائب المدير الفني



عدد الرسائل : 9451

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 17867
ترشيحات : 33
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: تساؤلات حول جماليات العامية والفصحى في المسرح العربي الحديث موضوع: تساؤلات حول جماليات العامية والفصحى في المسرح العربي الحديث  1/3/2010, 03:51 1/3/2010, 03:51 | |
| تساؤلات حول جماليات العامية والفصحى في المسرح العربي الحديث .
د. عبدالله خلف العساف طبيعة المشكلة ومحيطها:
إن الحديث عن لغة المسرح العربي قديمٌ حديثٌ متجدّد، وقد كَتَبَ فيه وعنه عشرات الكتّاب، وأُلّفت فيه كتبٌ كثيرة، وشهدت الصحافة العربية منذ نشأتها، وبخاصّة صحافة الأربعينيات والخمسينيات، مئات المقالات التي تناقش بجدية كبيرة لغة المسرح العربي.
وقد كانت القضية الساخنة المطروحة للنقاش خلال الربع الأخير من القرن الماضي والنصف الأول من القرن العشرين ومازالت في موضوع المسرح هي العامية والفصحى. فإذا كانت الفصحى هي التي ينبغي أن تكون لغةً للمسرح، فأية فصحى ينبغي أن تكون؟ هل هي "الفصحى التقليدية" ذات المستوى الأحادي الذي لا يميّز بين الشخصيات المسرحية من حيث المستوى الثقافي وغيره؟ أم "الفصحى المعاصرة" التي تلتزم بقواعد اللغة العربية، وتراعي التمايز المذكور بين الشخصيات؟ ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً كان من قبل دعاة العامية في المسرح إلى المتمسكين بالفصحى: إذا كان لدينا مَثَلٌ شعبي موضوعٌ بالعامية، وورد هذا المَثَل على لسان إحدى شخصيات المسرحية، فهل ننقله إلى الفصحى أم نبقيه كما هو؟ وإذا نُقل إلى الفصحى، فإنه سيفقد قدرته على التأثير لأنه أُخرج من سياقه الجمالي الذي وُضع فيه. واحتج دعاة العامية في المسرح بأشياء كثيرة إلى جانب الأمثال الشعبية، منها مثلاً ما يتعلّق بالأغاني الشعبية الموضوعة أساساً بالعامية، و"النكات" الكوميدية، وضرورة انسجام لغة الحوار المسرحي مع شخصيات لا مكان لها أن تتحدّث إلا بالعامية، ولو وُضعت في غير هذا السياق لفقدت مصداقيتها الفنية، ومن ثَمّ تأثيرها، وهكذا. وأكد هؤلاء الذين يدعون إلى العامية على ضرورة التزام لغة النص المسرحي بمراعاة التفاوت بين الشخصيات، وارتباطها فيما بينها من جهة، وبين الأحداث والأمكنة التي تنتمي إليها من جهة أخرى؛ بمعنى أن لغة الحوار المسرحي ينبغي أن تنسجم ووعي الشخصيات الثقافي والجمالي، وكذلك البيئة التي تنتمي إليها. ويقولون: إنه ليس من المعقول في مسرحية تعكس بيئة متخلّفة حضارياً أن تتحدّث شخصياتها التي تنتمي إلى تلك البيئة اللغة العربية الفصحى.
ويضيف هؤلاء إلى حججهم السابقة حججاً أخرى أبرزها:
- إن عامة الناس تتفاعل مع العامية أكثر من الفصحى.
- والعامي يجد نفسه أكثر واقعية حين يسمع العامية.
- العامية قادرة على تصوير الجانب الحيوي لدى الإنسان، وتساعد على الأداء وتحرّك الممثل وتقرّبه من الناس، ومن الأداء الحي للدور، وتجعله بعيداً عن التكلّف.
- العامية تكسر الحاجز بين المشاهد والممثل.
- العامية سهلة الارتجال عند الضرورة.
- وهي أقدر على تصوير خصوصيات الواقع من الفصحى.
وقد كانت مجمل الآراء والمواقف التي تناولت لغة المسرح العربي تنطلق من مرجعيات ترتكز عل "مُثُل جمالية" متنوّعة على رأسها "النموذج الأوروبي"، و"النموذج الروسي"، و"النموذج العربي الإسلامي" الذي يأخذ قوّته من أصالته؛ أي من الرغبة في السعي إلى تأصيل المسرح العربي عبر مستويات متعدّدة، أبرزها اللغة العربية الفصحى.
وأرجو أن يُسمح لي بالإشارة إلى أن "المُثُل الجمالية" التي كانت سائدة في فترة الأربعينيات والخمسينيات كانت تلقي بظلالها على المشهد الثقافي بشكل عام في تلك الفترة، وكانت تتحكّم بالأجناس الأدبية كالرواية والقصة القصيرة، والشعر إلى جانب المسرح لغةً وشخصيات وأحداثاً ورؤية ورؤيا.
لقد كان الحوار بين دعاة العامية والفصحى في المسرح ذا طابع سجالي قد يصل أحياناً إلى اتهامات علنية لا تهدأ بين الفريقين. فدعاة الفصحى في المسرح يتهمون دعاة العامية بالتحلّل والدعوة إلى التغريب، و"الأوربة" والانسلاخ من الجذور، ودعاة العامية يتهمون دعاة الفصحى بالتخلّف والتقوقع والجمود والأحادية. وما زالت نسائم المعارك النقدية في الأربعينيات والخمسينيات تهبّ بين وقت وآخر حتى الآن على الرغم من تغيّر اهتمامات المسرح، إذ لم تعد "لغة الحوار" هي الشاغل الأول كما كانت سابقاً.
ولو تصفحنا ما كُتب ونُشر عن هذا الموضوع لوجدنا آراءً متباينة؛ بعضها يدعو إلى الفصحى لغةً للأدب من منطلق عربي إسلامي للحفاظ على الموروث، ولإثبات الهوية والمستقبل، وبعضها يدعو إلى العامية لسهولتها، وجماهيريتها ولأنها قد تكون في موقع معيّن لا يمكن لغيرها أن يحلّ فيه. وهناك بيانات نقدية وقف أصحابها "بينَ بينَ"، فدعوا إلى استخدام "لغة الوسط" أو "اللغة الثالثة" التي تتميّز بأنها عربية فصحى بسيطة غير معقدة. ولكن ملامح اللغة التي تحدّث عنها هؤلاء لم تتكشّف لنا حتى الآن بكل أسف.
أبرز المواقف النقدية، ومرتكزاتها الجمالية:
إن المواقف النقدية المذكورة كانت تنطلق- في المرحلة المذكورة وما تلاها حتى الآن- من مواقف جمالية متباينة، يعكسها وعي جمالي متباين، يمكن أن أوجزهُ فيما يلي:
أولاً: الموقف الجمالي التقليدي: الذي يُعلي دائماً من شأن الآخر والموضوع. هذا الموقف يطالب بوجوب سيادة اللغة العربية الفصحى التقليدية دون الالتفات إلى طبيعة الموقف المسرحي أو طبيعة التباين في لغة الشخصيات أو البيئة المسرحية.
ثانياً: الموقف الجمالي (التغريبي): الذي يتخذ من النموذج الأوروبي "مَثَلَهُ الجمالي". وأصحاب هذا الموقف يطالبون بنسف الفصحى، وسيادة العامية في الأدب، والاتجاه الكلي نحو الغرب من خلال الاعتماد على نماذجه الأدبية وأساليبه الجمالية، وغير ذلك حتى لو لم يكن ينسجم وطبيعة الأجناس الأدبية العربية. حتى لقد طالب بعض هؤلاء بتغيير الحروف العربية بحروف لاتينية. ولو عدنا قليلاً إلى الوراء نجد أن جذور هذا التيار تعود إلى العصر العثماني حيث فُرضت آنذاك اللغة التركية في المعاملات الرسمية والقضاء، وحُصرت اللغة الفصحى في المساجد والكتاتيب. وازداد الوضع سوءاً في العهد الاستعماري الحديث حيث فُرضت اللغات الأجنبية: الفرنسية والأنكليزية والإيطالية على الدول العربية المستعمرَة. وما زال بعضها يعاني حتى الآن من ذلك. ويُذكر أن أولى الدعوات إلى العامية وإلى قلب الحرف العربي إلى حرف لاتيني كانت في مصر على لسان أحد المستشرقين الألمان. فقد وضع كتاباً بعنوان (قواعد العامية في مصر) ومنه- كما يؤكّد معظم المهتمين بقضايا العامية والفصحى– انبعثت الدعوة إلى العامية لسهولتها كما يُدّعى، ولصعوبة الفصحى. ومن الدعوات التي تصبّ في هذا الجانب أيضاً الدعوة إلى كتابة الحروف العامية باللاتينية. ويرى أحد الدارسين العرب أن اللهجة الدارجة أنسب لأي مقام وأوقع في النفوس عند الخواص والعوام.
وما يؤكّد قوّة هذا التيار واستمراره ما يحدث اليوم على شاشات التلفزة العربية. فالملاحظ أن العامية حين تُقدّم على شاشة التلفزة يوفّر لها مناخ جذّاب، وفيه غنى وتنوّع، بينما تُقدّم الفصحى في جوّ كئيب، وديكور بائس، لا يخلو من بعث الشعور بالملل لكل من يتابعه.
ثالثاً: الموقف الجمالي (العائم): الذي يرغب أصحابه في الجمع بين النموذج العربي القديم، والنموذج الغربي جمعاً تعسّفياً بطريقة لا تخلو من التلفيق والهجانة، فلا هي بالعربية، ولا هي بالغربية.
رابعاً: وهذا الموقف الأخير ينطلق من معطيات اللغة العربية المعاصرة، ومدى حاجة الأجناس الأدبية إليها. فهو يطالب بأن تكون الفصحى لغةً للأدب من منطلق المحافظة على لغة مشتركة. لكن طبيعة الفصحى التي يطالب بها أصحاب هذا الاتجاه هي الفصحى التي تنسجم وطبيعة الواقع المعاصر من حيث اختيار المفردات السهلة ووضعها في تراكيب سهلة بحيث تؤدّي الغرض المرجوّ منها. ولكن- مقابل ذلك– لا يرفض هؤلاء أن تُستخدم العامية في مواقع معيّنة وبخاصّة في لغو الحوار بمعنى أنهم لا يمانعون من إدخال مفردات عامية إذا دعت الضرورة إلى ذلك في سياق الأجناس الأدبية، وبخاصّة لغو الحوار في المسرح أو القصة القصيرة أو الرواية؛ لأن ذلك يؤدّي إلى حالة من التواؤم الفعّال بين طبيعة الحوار والشخصيات التي تمارسه.
ويعتقد هؤلاء أيضاً أن استخدام الأجناس الأدبية للغة عربية سهلة ونجاحها في ذلك يساعد- من خلال دعم وسائل الاتصال الفضائية العربية اليوم– على كسر الهوة بين الفصحى والعاميّات، ويخلق لغة مشتركة واحدة.
اتجاهان: الفن واللعب، والفن والمنفعة:
إن المواقف الجمالية المذكورة لها علاقة وطيدة باتجاهين فلسفيين أثرا تأثيراً كبيراً في موقف النقد الأدبي من لغة الحوار في المسرح، وفي غيره من الأجناس الأدبية. والاتجاهان هما:
1- الاتجاه الذي يربط جمال الفن ومن ضمنه الأدب بالمنفعة: ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن جمال الفن والأدب يزداد كلما ازدادت المنفعة التي يقدّمها، ويلجماه بقلّة ما يقدّمه من منفعة، ويصبح قبيحاً إذا خلا منها.
2- الاتجاه الذي يربط جمال الفن باللعب: ويَعتبر أن ارتباط أي جنس أدبي مثلاً بمنفعة حتى لو كانت صغيرة ستفسدُ جماله وتجعله قبيحاً. والنقّاد الذي ينطلقون من هذا الموقف لا يهمهم كيف تكون لغةُ الأدب؟ المهم عندهم أن يحقق هذا العملُ الإبداعي اللعبَ أو مقولة الأدب من أجل الفن؛ بمعنى إذا كانت العامية تحقّق هذا الأمرَ، فيجب أن أتمسّك بها حتى يظلّ الأدب جميلاً.
إن النقد العربي المعاصر كان ينطلق، وما يزال من المواقف الفلسفية والجمالية المذكورة في تحديد موقفَه من لغة الحوار المسرحي، ولغة الأجناس الأدبية الأخرى.
المشهد اللغوي الراهن للعربية:
إن الواقع الراهن للغة العربية لا ينبئ بانفراج قريب على صعيد الفصحى، بل يُلاحَظ أن اللهجات العامية تتغلغل على مستوى واسع، وعلى أصعدة مختلفة. وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على الاستحسان الواضح لعامية الحور المسرحي من قبل الجمهور وكثير من النقاد.
وسأرسم- فيما يلي- صورة للمشهد اللغوي القائم في الوطن العربي، ويمكن لنا بعد ذلك أن نحكم على مدى خطورة ما يجري:
أولاً: هناك اليوم عدّة أشكال للغة العربية الفصحى، من أبرزها: الشكل التقليدي، والشكل الحداثي، والشكل الذي يتأرجح "بين بين". ولكل شكل من هذه الأشكال مصطلحاتُه ومرتكزاته الفلسفية والجمالية، وأنماط تفكيره التي تتميّز تميّزاً بيّناً من الآخر.
ثانياً: هناك عدّة لهجات متداولة في الوطن العربي. والإنسان العربي ينشأ على اللهجة العامية، ثم يتعلّم الفصحى على مقاعد الدراسة. وهذا يشكّل له، أي لهذا الفرد ثنائية لا تجعلُه قادراً على الاستقرار باتجاه معيّن.
ثالثاً: ومن سمات الوضع اللغوي الراهن أيضاً أن هناك أناساً غير عرب ينطقون اللغة العربية ويعيشون ثنائية لغتهم الأساسية واللغة العربية الفصحى التي تعلّموها.
رابعاً: هناك تأثير كبير للغات الأجنبية في الباحثين العرب. فهم يفكّرون علمياً باللغة الأجنبية التي أكملوا دراساتهم بها، ويفكّرون باللهجة العامية في سلوكهم العادي اليومي. وهذه ثنائية لغوية أخرى لها انعكاساتها السلبية على العربية الفصحى، وعلى الفرد بوصفه باحثاً، أو متلقياً عادياً لعمل فني.
خامساً: لكن الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف الراهن هو التناقض شبه المستمر بين نمطين ليس لهما علاقة مباشرة بالنقد، ولكنهما يؤثّران فيه، وفي ثنائية الفصحى والعامية، هما:
1- الموقف الرسمي الذي يطالب أن تكون الفصحى هي لغة الحوار المسرحي والأدب. ويتبنّى هذا الموقف مجامع اللغة العربية، والجهات الأكاديمية الرسمية. وهؤلاء يتبنون الموقف الجمالي التقليدي المذكور سابقاً. وقد يكون تمسّك هؤلاء بالفصحى في كل شيء، ومنها مثلاً لغة الحوار المسرحي لمجرّد أنها فصحى، أساءَ إلى العربية الفصحى في أحايين كثيرة.
2- الموقف الفعلي الراهن الذي يبيّن أن العامية لها حضور مميّز في كل مكان، وعلى خشبة المسرح.
أمام هذا الواقع القائم من تعدد اللهجات العامية، وتمكّنها، وأمام ثنائية العامية والفصحى، وثنائية الخطابين التقليدي والحداثي، وثنائية الوعي الجمالي التقليدي والوعي الجمالي الغربي، وثنائية الجدّ واللعب، أي المنفعة والفن للفن. أقول: أمام كل هذه الثنائيات يبدو الواقع اللغوي القائم الآن صعباً، وشائكاً، ويحتاج إلى مزيد من الهدوء والجدية في معالجته بعيداً عن إصدار القرارات المتسرّعة التي لا تغني عن شيء.
لغة المسرح العربي الحديث منذ النشأة حتى الآن:
استعراض موجز للغة المسرح العربي الحديث:
لم يعرف العربُ المسرحَ قديماً لأسباب متعدّدة لا مجال لذكرها هنا، فهم لم يكتبوا "النص المسرحي" بمعناه الاصطلاحي، وإن كانت لهم ممارسات مسرحية كانت تتبدى في الحفلات والأعراس والأعياد الجماعية.
إن المسرح العربي مدينٌ - كما هو معروف - بنشوئه إلى الغرب الأوربي. وهو - إلى جانب القصّة القصيرة والرواية - نتيجةٌ لعملية المثاقفة التي تمّت في القرن الماضي بين الثقافتين الغربية والشرقية، وما زالت مستمرّة.
ويمكن اعتبار مسرحية "البخيل" لمارون النقّاش التي كتبها هو، وأخرجها على خشبة المسرح في بيت جدّه ببيروت عام 1847م أول مسرحية عربية تُدخل فن المسرح إلى اللغة العربية، وتجعله واقعاً ملموساً. ولابدّ من الإشارة إلى أن المسرحية المذكورة ليس لها علاقة بمسرحية البخيل للكاتب الفرنسي موليير.
وتنبع أهمية مسرحية النقّاش من أنها - إلى جانب ما تقدَّمَ - أوّل مسرحية عربية تُثير إشكالية "العاميّة والفصحى" في المسرح العربي.
لقد قدّم النقّاش مسرحيات متعدّدة - إلى جانب البخيل - مثل: أبو الحسن المغفّل 1849م، والحسود السليط 1853م. ولعلّ أبرز ما يميّز مسرحياته أنه دخل إلى المسرح من باب النص الأدبي، كما سعى إلى استخدام مأثور الشعب من قصص، وأفاد من ظاهرة حبّ الناس للشعر مرويّاً ومغنى. باختصار: إن النقّاش أخضع صيغ الفن التي جلبها من أوروبا آنذاك إلى إعادة صياغة بهدف ملاءمتها لشروط البيئة المحلية.
ولكن الأهم من كل ما تقدّم فقد قُدّمت تلك المسرحيات بلغة اختلطت فيها العربية الفصحى بالعامية الركيكة بالتركية.
ويمثّل المرحلة التالية - بعد النقّاش - الكاتب السوري أبو خليل القبّاني الذي قدّم مسرحياته الأولى في أحد بيوت دمشق القديمة، ثم رحل إلى مصر، وفي القاهرة قدّم مسرحيات أنيس الجليس والأمير غانم بن أيوب وقوت القلوب وعفيفة وعنترة، وغيرها.
وكان القباني مؤلّفاً موسيقياً بارعاً لذلك كانت مسرحياته أقرب ما تكون إلى المسرح الغنائي. وكان يختلط فيها التمثيل بالغناء بالرقص.
ولكن الملاحظة الهامة - في هذا المجال – أن لغة المسرحيات التي كتبها ثم قدّمها على خشبة المسرح كانت قائمة بالأساس على العامية، والتركية، وقليل من الفصحى.
ولعل اهتمام القباني بالغناء والرقص والإنشاد في المسرح، وكذلك العامية كانت وراء نشأة فن الأوبريت في البلاد العربية.
ولا يخرج الرائد المسرحي الثالث يعقوب صنّوع عما بناه زميلاه المذكران. فقد قدّم اثنتين وثلاثين مسرحية تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً أغلبها يصوّر الواقع الاجتماعي في مصر آنذاك معتمداً على الدعابة الشعبية والأغاني الشائعة واللهجة العامية. ولابدّ من الإشارة إلى أن الفضل في وضع أسس المسرح الشعبي يعود إليه.
لقد أردتُ من خلال الإطلالة السريعة على جانب من جهد روّاد المسرح العربي الذي أورده معظم الدارسين أن أؤكّد مسألتين:
الأولى: أن مشكلة العامية والفصحى ليست طارئة على المسرح العربي. فقد لازمته منذ نشوئه حتى الآن.
الثانية: أن مسرح الروّاد الأوائل جعل من العامية أساساً في المسرح. وما يزال المسرح العربي منذ مسرحية البخيل للنقّاش حتى الآن ملتزماً بالعامية كأساس، ومنطلق.
وعلى الرغم من أننا لسنا بصدد الحديث عن مراحل المسرح العربي، لكن لابد لنا من الإشارة إلى أن المرحلة الثانية في المسرح العربي التي يُطلق عليها "المرحلة الرومانسية أو مرحلة الأوربة" والتي مثّلها جورج أبيض، ويوسف وهبي، ونجيب الريحاني لم تخرج - على صعيد اللغة - عمّا اختطّه الروّاد. وكانت اللهجة العامية هي السائدة في لغة "النص المسرحي" المكتوب، ولغة الممثّل على خشبة المسرح.
لقد نما المسرح العربي في هذه المرحلة الثانية نموّاً لافتاً، وبدا واضحاً تأثّره بالمسرح الأوربي والروسي، وكذلك بالمدارس الأدبية والفنية، مثل: السريالية، والوجودية، والواقعية، والرمزية، وما إلى ذلك من أسطورة، ورمز، وتقنيات فنية جديدة.
ولكن لو بحثنا في مسرح تلك الفترة عن ملامح لمسرح عربي لا نكاد نقع على شيء بسببٍ من غلبة العناصر الغربية على الشرقية العربية.
ولو تركنا طور النشأة ثم طور النمو وانتقلنا إلى مرحلة النضج لوجدنا أن الأفق المسرحي العربي أصبح أكثر رحابة، واتساعاً وغنىً وتنوّعاً. ويمكن القول: إن التجربة المسرحية لدى الكتّاب العرب تبلورت ونضجت في هذه المرحلة كمّاً وكيفاً. وظهر جيلٌ جديد مدعوم بثقافة مسرحية ووعي جمالي مسرحي. وخلال هذه المرحلة التي تمتدّ حتى الآن ازدادت عملية المثاقفة مع الغرب والشرق عبر الاحتكاك المباشر والترجمات ووسائل الإعلام المختلفة وأُسّست المعاهد المسرحية العُليا في بعض العواصم العربية، وظهر كُتّاب كبار في كتابة النص المسرحي مثل: توفيق الحكيم، ويوسف إدريس، ومحمّد الماغوط، وسعد الله ونّوس، ووليد إخلاصي، ومصطفى الحلاّج، وغيرهم.
لكن الملاحظ هنا أنه على الرغم من كل التطوّر الذي أصاب ثقافة الكاتب وتقنيات المسرح على كافة الأصعدة، فإن العامية كانت أحدَ هواجسه التعبيرية في لغة الحوار المسرح.
وأودّ أن أُشير هنا إلى أنه إذا كانت العامية قد رافقت "النص المسرحي" منذ نشأته، فإن "المسرح التمثيلي" كان مفتوناً بالعامية. فمنذ "البخيل" للنقّاش مروراً بالمسرح الغنائي لأبي خليل القبّاني والمسرح الشعبي الكوميدي ليعقوب صنّوع، فيوسف وهبي والريحاني حتى مسرح دريد لحّام، وعادل إمام، ومحمد صبحي، وغيرهم كانوا جميعاً يقدّمون مسرحهم بالعامية، اللهم باستثناء ما يقدّمه طلاّب المعاهد المسرحية العليا من أعمال مسرحية لغاية العرض على اللجان لإجازة هؤلاء حتى يتخرّجوا، وليس لغاية عروضها على الصعيد الجماهيري.
أما ما تقدّمه المسارح القومية في سورية ومصر وتونس فهو قليل من حيث الكم، وضعف الفاعلية من حيث التأثير والكيف بسبب ضعف العمل الإنتاجي له، وأسباب أخرى لا مجال لذكرها.
إن المسرح السائد هو مسرح القطاع الخاص. وهذا المسرح لا تعنيه اللغة الفصحى بقدر ما يعنيه الربح المالي. وهو مسرح ذكي لأنه يعرف تماماً ما يريده "النظّارة" منه. ولا بد لي من الإشادة بالمسرح الشعري العربي الذي كان يسعى إلى مقاربة الشعر في لغته. ومن أبرز شعرائه: أحمد شوقي، وسليمان العيسى، وصلاح عبدالصبور، وخليل مردم، وخالد محيي الدين البراجعي، وممدوح عدوان، وغيرهم.
أبرز النتائج:
يُلاحظ من خلال استعراضنا السابق ومناقشتنا لجانب من المعارك النقدية التي دارت حول لغة المسرح، ولأبرز النظريات الجمالية الداعمة لذلك، وكذلك من خلال عرضنا الموجز للغة المسرح بدءاً بجيل الروّاد ما يلي:
1- إن العامية كانت وما تزال هاجس "النص المسرحي"، وأساس "المسرح التمثيلي". وهذه العامية أضحت عاميّات. ومن النادر أن نجد مسرحية لم تخضع إلى إغراء تلك "العاميات"، حتى إن بعض المسارح القومية كانت تقدّم مسرحيّاتها باللغة الفصحى، وكان كثيرٌ من النقّاد والجمهور لا يعتبر ذلك مسرحاً، بل يعدُّونه نوعاً من أنواع تأدية الواجب القومي، أو أن المسرح القومي غير جاد؛ لأنه سيقدّم استعراضاً خطابياً للغة الفصحى وليس مسرحاً. ومعظم هؤلاء يعتقدون أن هذا النوع من العروض المسرحية لن ينجح لأنه مكتوب باللغة الفصحى.
2- ناقش النقد الأدبي بعامة والنقد المسرحي بخاصّة مشكلة العامية والفصحى في المسرح، وغيره من الأجناس الأدبية. وكان ذلك النقد أكثر مَيلاً إلى التباسط مع العامية في الحوار المسرحي. وبخاصّة حين يُقدّم "النص المسرحي" على خشبة المسرح، باعتبار أن العامية حالة واقعة لابدّ من الاعتراف بحضورها في المسرح، وهي من خلال ذلك قادرة على التعبير عن أبعاد الشخصيات والأحداث، وقادرة على إثارة الكوميدي والتراجيدي، ورسم الجميل والقبيح، وتكوين الجليل ببراعة متناهية. والعامية بهذه الصورة، ومن منظور جمالي تُعتبر جميلة لأنها تؤدّي إلى الذي وُضعت لأجله. ولأن هناك من يجعلها كذلك فقد راجت وصار لها جمهورها الواسع، وسحرها الخاص، بل أصبحت العامية تتحكّم بتغيير الذوق الاجتماعي. والعامية - من خلال تحكّمها المذكور - حين تكون غير ذلك تبدو قبيحة من وجهة نظر هؤلاء.
إننا ندعو إلى أن تكون اللغة العربية الفصحى لغة الحوار المسرحي، بل لغة الأجناس الأدبية جميعاً دون استثناء؛ فالعربية ليست مجرّد مفردات جميلة فحسب، وإنما هي تمثّل عمق شخصيتنا الحضارية، وحاضرها، وعن طريقها صاغ الإنسان العربي - عبر آلاف السنين - مشاريعَه الحضارية، والجمالية، وعن طريقها أهدى إلى العالم أبجديات المعرفة الإنسانية. إن العربية الفصحى يجب أن تكون لغة مستقبلنا. ولا يتم ذلك إلا إذا ساهم الأدب في استثمار طاقاتها في الحوار والتعبير والتصوير، ولكن ينبغي ألا ننسى مراعاة "بيئة الحوار"، و"لغة الحوار" بين الشخصيات على الصعيد الثقافي، وكذلك "الموروث الشعبي" الذي صيغ أساساً بالعامية، ولا يمكن أن يُقدّم إلا عبر تلك الصيغة. أعني أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي بين الشخصيات، وكذلك الأمثال والأغاني والحكايات، وما إلى ذلك. وحين لا تستطيع الفصحى تحقيق ذلك تصبح قبيحة، ومستهجنة.
وأودّ أن أُشير - قبل إقفال الحديث في هذا الموضوع - إلى أن معظم الذين استخدموا الفصحى في الحوار المسرحي لم ينجحوا في تطويعها لتصبح جزءاً من الشخصية التي تتحدّث بها، بل - دائماً - كنا نجسّ أن الشخصية شيء والحوار الذي تتحدّث به شيء آخر منفصل عنها تماماً إلى جانب الخطاب المنبري الذي يُعدّ أبرز سماتها، لذلك كانت الفصحى - في المسرح - تخسر من الجولة الأولى أمام العامية. وإذا ما أردنا للفصحى أن تسود، ولو بشكل نسبي فينبغي أن نثق بها أولاً، وأن نقتنع بقدرتها على النجاح، وينبغي ثانياً أن يكون الكاتب قادراً على توظيفها توظيفاً صحيحاً بحيث يجعلها جزءاً من الشخصية، وينسحب هذا الكلام على المخرج والممثل وكاتب السيناريو، وكاتب الحوار. وينبغي أن يدعم كل ذلك وسائل الإعلام المختلفة، وبخاصّة المؤثّر منها، وأن تتخلّص الجهات الأكاديمية من المبالغة في الطرح. واعتقد أننا بهذه الصورة نستطيع أن نساهم في جعلها - ربما - في المرتبة الأولى، وجعل العامية في المرتبة الثانية، وليس العكس كما يجري الآن. |
|