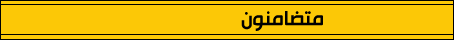قراءة في قصيدة " عائشة " لعلي الحازمي
( 1)
يبسط الشاعر ظله على النص ، ويعيش لعبة الماضي والحاضر ، فيساوق بين ذكريات الأمس الحنون ، ومتاعب الحاضر ، دون أن ينسى أن للزمن دورته التي تعيد ترتيب المشاعر والأشياء ، ولذلك نرى الطبيعة الجنوبية حاضرة بكثافة في قلب المشهد . تطل علينا عائشة ، وهو اسم تراثي أحبه كثيرا ، و أتذكر رواية أجنبية كان كاتبها قداختار هذا الاسم للدلالة على الشخصية العربية ، لكننا مع الحازمي الآن ، وهو يتمعن في الذكرى ، ويعترف أن الوقت شطر حبهما ، ولم يعد الحب القديم هو هو ، وبطريقة الفنانين التأثيريين يتيح مساحة أكبر للضوء كي يكشف من خلاله عن عمق جراحه عبر رسم مشهد قديم لعاطفة جميلة هي الحب ، وسنلاحظ أن مفردات الحب الرومانسي حاضرة بكثافة ، وبتشكيل جميل حين ننظر للفراشات وهي تحوم ، وصوت الحبيبة أقرب للعشب ، والاخضرار كثيف في مشهد النخيل ، متوزعا على ترنيمات ضحكة خجول:
كبرنا على الحب يا عائشة
وكدنا نضيع قِبلتنا
في الدروب المريضة بالوقت
والتعب القروي
لم نكن واضحين كما ينبغي
للفراش بأن يتهافت في ظلنا
كان صوتك أقرب
للعشب من نفسه
حين ينداح بين صفوف النخيل
وينأى على ضحكة فاتنة
(2)
لا يصل إدراك التماثل بين جزئيات الماضي و عطاءات الحاضر حد التطابق ، بل يقتصر على إعادة تمثيل الموقف القديم ، وهو يعاد تشكيله في خفاء مبهم حيث تغفو سنابل الروح ، وهي صورة تنبع من انفساح الحقول في الجنوب العامر بالزرع البهي ، وتكون القرية هي القبضة المحكمة التي تملك وتمنح بحساب ، حتى لو كان الأمر يخص عواطف البشر ، وتتحرك الصورة لنشعر بهواء الحقول ، وهو يمنح النفس سكينة مطمئنة ، ثم يغترف الشاعر من حقل خبرته الحياتية صورة الفلاح وهو يبذر الحب ليحصد المحصول ، ويكون اختياره للقمح ليشبع النفس بالرغبة البريئة في تحقيق حلم التواصل المشروع :
حين تغفو سنابل أرواحنا
في هزيع سريرتها القروي
يجيء هواك الجنوبي مزدحماً
بالمواويل والأغنيات القريبة
من تعبي ...
كان طيفك يبذرني في الحقول
كحبة قمح تفتق وجه التراب
لتفصح عن حرقة كامنة
(3)
لا يقتصر الأمر على إعادة تمثيل الموقف القديم ، بوصفه دالا على مدلول معاصر لا يشار إليه ، وهو الحب ، بل يدرك من خلال عملية الربط والتحليل ، والتنقيب عن روح الحب المحلقة ، هل يكبر الحب مثل الأشخاص ، أم يزداد تعتقا وجمالا ؟
إن الوقت هو السيف المسلط على رقاب العباد ، ولكن ضمن إطار معرفي يمكننا أن نتعرف من خلاله على تحولات الأزمنة ، وصيرورة المشاعر ، وتقلبات القلوب ، وهناك ممازجة فريدة بين القمح حين يحصد ، وبين الأعمار وهي تزداد كثافة وأنينا بثقل السنوات المضافة ، هل يمكننا أن نتذكر هنا قصيدة أحمد عبد المعطي حجازي " عامنا السادس عشر " وبراءة السنوات الغضة ، وكيف صارت مزقا ، مع عمر يتقدم ، وحب يزوي؟
ربما كانت هناك أوجه مقارنة ، غير أن الحازمي يتحدث عن ذاته ، عن حب قد امتلك قلبه فيما كانت رؤية حجازي فيها خيط وجودي لا يغيب عن فطنة الناقد .الحازمي مدجج بأسئلة التحول والمصير ، وأرى عائشة الجميلة تخبيء مشاعرها في الثوب الأسود ، والسلال ، في مشهد ريفي بديع خاصة مع مشهد السماء المعلقة ، التي تهيم في فضائها أرواح تشتعل بالوجد ، وتكتوي بالوله ،فالمواسم تمر ، والعمر يزحف ، فيما يكون الحب متأرجح بين التحقق والاستحالة :
يحرث الوقت أرواحنا في جميع المواسم
قبل أوان الحصاد وبعده
ليس هنالك فصل جديد
من العمر نرقبه حين نجني ثمار عواطفنا
ونخبئها في السلال
تظل السماء معلقة فوقنا
في الجنوب القريب من الروح
تسندها غيمة ممكنة
(4)
كما يختزن الحجر الصخري الماء المتساقط من السماء على هيئة مطر ، يختزن المحب ذكريات الحب الأول بكل مافيه من براءة ، وطزاجة ، وإشراق ، وانفتاح على الحياة . ثمة إحساس عميق بما يحدث من ضياع الحلم ، وتنطوي هذه الجزئية على انفلات الشعور القوي بالامتلاك ، فالضفة تتآكل ، والحمام يغادر الدار ، ويتجه إلى سدرة الحزن . الريش الجميل كان يحمل اسم الحبيب ومن خطفت قلبه . هو موقف الضياع المأساوي لأن الحبيب لم يغادر ، لكن العلة كامنة في الزمن ، وهي صورة رائعة تتشكل على مهل من خبرة الجنوبي بالقرى ، ومخزون ذكرياته الذي لا ينضب على وجه الإطلاق .
ينفي الحب العميق صفة الاغتراب ، ويتوحد الشاعر مع المشهد القديم لحمام يروح ويجيء في سماوات مفتوحة آمنة ، وهو إحساس تقيده لحظة العجز الحاضرة لتتأكد الخسارة الفادحة :
كيف نحيا على ضفة تتآكل
من تحتنا
والحمام يغادر من ردهات
هوانا المجنح في باحة الدار ،
خفيفاً كظلك راح الحمام
يرف على سدرة الحزن في ريشه
كان يحمل اسمي واسمك
بين جناحيه ترتيلة من هديل أخير
وينأى إلى ضفة آمنة
( 5)
يبدأ الشاعر مرثيته في تنويع على اللحن الأصلي ، مع امتزاج بين الحزن الساكن بين الضلوع ، وبين اشتهاء اللحظات القديمة ، هنا يعود لتراثه القديم في اللوم والعتاب ، وإزجاء المدح لوجه الحبيبة الغائبة ، وهو نسق معرفي قديم يجيد الحازمي تشكيله على نار هادئة ، فيما يمكننا أن نتصور أن المفارقة هنا تنطوي على انزياح الحاضر ليأخذ مكان الماضي لا العكس ، وهي حيلة سيكولوجية يلجأ إليها الشاعر حتى يقلل إحساسه الجسيم بالفقد ، وربما كان من الطبيعي أن يبحث الشاعر عن تبرير للفقد ، والتبرير هو جزء من الأزمة نفسها ؛لأن عائشة التي عرفها تبددت بالزمن ، أو تغيرت ، هو يتحسس الأسباب ، وينظر داخله ، ليكتشف أن الفضة قد انسكبت على التراب ، مثلما تحول الواقع إلى تراب ، ويزداد الشعور بالاغتراب ، لأن عائشة حاضرة / غائبة . والزمن هو الجاني ، وخاصة مع لحظاته الآسنة :
لم نكن قادرين على أن نميز
فضتنا عندما انسكبت
فوق وجه التراب وذابت
مع الرمل في لغة تستحيل
يباباً على خطونا
لم يكن باليدين سوى أن نظل
نسير لآخر هذا الطريق
غريبين في لحظة آسنة
(6)
تتخلق دلالة جديدة ، ونحن نخطو مع الحبيبين ، والزمن يلفهما في غلالة غامضة ، حينها يقترن الغناء بلحظات الحلم الجسور ، فيما يطل الصمت ، ويناوش القلوب المكلومة ، وسيكون غريبا أن نجد الحبيبين سويا في المشهد ، ودونما إرادة يتجه كل إلى طــريق ،
فتقترن لحظات الاغتراب المحدودة بحزن أبدي يسكن الذوات المعذبة ، ويتحول الحب القوي من حقيقة مبهجة إلى مجرد ذكريات ، لكأن ذبالة العمر تتأرجح مع هبوب نسمات الجنوب .
ولعلي في حاجة إلى أن ألفت الانتباه إلى أن هذا الحب الذي تحول إلى اغتراب هو المشهد الأكثر إلحاحا في الشعر العربي .
هل يمكننا أن نستعيد " الأطلال " للدكتور إبراهيم ناجي الطبيب الذي كان يعيش مثل هذه الأجواء في الأربعينات و الخمسينات من القرن الماضي ، وقد خلدة قصته أم كلثوم حين شدت :
" أعطني حريتي أطــــــلق يديا ..
.. إنني أعطيت ما استبقيت شيئا .. "
لكن الحازمي ابن عصره ، فهو لا يصرخ ولا يئن ، ولا يريد أن يتحرر من الحب القديم المتجدد . إنه يعاينه ، يعيش لحظات الفقد ، يمرر ذاته خلال ركام الانكسار ، وتلك عذاباته الفريدة ، حتي وهو يسرد لنا كيف عبر الجسر، فاكتشف أنه لم يعد راغبا في المزيد من العمر بعد أن تبددت روحه ، وغابت الفرحة من أعماقه :
حين نعبر جسر النشيد بأحلامنا
للضفاف الأخيرة
نغدو وحيدين في صمتنا
لم نعد بعد هذا الضباب المطل
على شدونا راغبين بشيء من العمر
غير اتساع المواويل
بين كفوف الصدى ..
كلما غفل الفجر عن نفسه
في مساءاتنا يستريح هوانا
على قصب الأغنيات النحيل
ويأخذنا الليل في حيز مطفىء
بالسراج
لنغفو على آهة مزمنة .
(7)
لكن ما يحدث هنا من اعتراف مرير هو غناء البجعة الأخير قبل أن ترحل ، وهو خاتمة المرثية ، التي تحولت إلى أنشودة عشق للحب الطاهر البريء الذي لم يدنسه بشر. يتحول الحب في تلك اللحظة إلى ذكرى تطوحها الريح ، ويعود الشاعر لمشهد عيدان القمح في الحقل ، وهي الرمز الأكثر رسوخا في فضاء النص ، لنعثر على " ثيمات " عصرية للحزن ، و مواطيء أقدام للمراثي ، وبكائيات شفيفة لأحلام تشظت على مذبح الزمن ،وإن كنت أتحفظ تماما على كلمة ناتئة هي " الكلام الطليعي " ، وأحسب أنها لا تتماشى مع الرونق البهي لألفاظ الشاعر التي تميزت بالدقة والرهافة .
قدر المحب أن يتألم ، ويعاني حزنا أبديا . مع عائشة يتكاثر الألم ، ويشتد الوجع ، كما يتلون فضاء النص بحمرة الغروب الدامي ، وتطل نخلات نائحة كنخل السياب في " جيكور " ، ويمتد حبل الأزمة من ضفة لأخري فيما يصمت النشيد :
لم نُجارِ الرياح التي طوحتنا بعيداً
بل مضينا نرجح
من كفة الشمس حين تميل
على قمح أحلامنا في الهجير
طيبان كما النخل
لسنا نجيد الكلام الطليعي
لكننا قد نطيل الوقوف على عتبات التنبؤ
إن غربتنا الرؤى الطاحنة
(

توقيع أخير يلخص المعنى :" سنمضي إلى الروح ياعائشة " ، غير أن الشاعر يقف بين الثرى والثريا حينما يتوجه إلى لحظات الغياب الفارقة ، يقلب عينيه في مشهد الرحيل الأخير ، متأملا اللحظة ، دون أن يجسر على الاعتراف بالهزيمة . ربما كانت هذه اللحظة بالذات ، بكل ما تحمله من أسى وحزن هي محطته الأخيرة ، غير أنه يتكتم ألمه ، ويشرع في استبطان حلم جديد حتى لو بعد ألف عام :
معاً باليدين
سنقطع درب السؤال الأخير
إلى حلمنا
سنمضي إلى قبلة الأغنيات الشريدة
سنمضي ..
وإن يُسْقِط العمر من روحنا قطعةً
لن نعود إليها
سنتركها فوق كف من الرمل
كيما تُؤلِّب فجر الهديل البعيد
ستزهر
باسمي واسمك من برعم
غائر في النشيد
سنولد ثانية .. لا تخافي
سنولد ..
لو بعد ألف سنة
(9)
مثلما ينتظر على الحازمي أن يطل وجه عائشة من جديد ، نتأمل معه تلك اللحظة المخفية في ثنايا الأيام ، ونحن مثقلون بالحزن الأخضر ، ندرك أن صيرورة الحياة ، وقانونها العظيم : " إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم " ، هو قانون فيزيائي ، لكنه يصلح أن نختتم به إطلالتنا النقدية لنص جميل كتبه شاعر مجدد بروح متألمة ، وقلب عطوف !
منقووووووووووووول