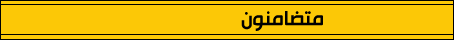كفى حزناً أن لا أرد مطيتي لرحلي، ولا أغدو مع القوم في وفد
وإن أفرعت قريان نجد، ونوّرت من البقل لم أنظر بعيني في نجد
وأن أسأل الأوغاد: ما كان شأنهم، ولا اشهد الشورى لغى ولا رشد
وقد كنت أعطي السيف -في الروع- حقه حياءً إذا جرّدت سيفي من الغمد
إنه يطلعك على مستويين من آثار الشيخوخة أترى في أولها تلك الندوب التي حدثت في نفسه بسب حرمانه من القدرة على ممارسة النشاطات التي كان يسعد بممارستها من قبل، وترى في المستوى الثاني صورة من التمزق النفسي والضجر الروحي القاتل أن أسبح مهمل الشان، ضائعة، إذ لا يقيم له أحد من عامة الذين يحيطون به -فضلاً على خاصتهم- وزناً، لا يسأل ولا يُسأل، فهو معزول عن الناس، وترجمة هذا الضجر تتضح من وقوفك بدقة على عبارة: "وأن أسأل الأوغاد" إذ ترسم لك كلمة الأوغاد" الصورة التي كونت في وجدان الشاعر عن الشريحة الاجتماعية التي كان يعيش بينها، فمثل هذه اللفظة تجسد أمامك نفس هذا الشاعر وقد ملأها الحقد والكره لهذا المجتمع، وهو حقد مدمر، وكره قاتل، وذلك أنه حقد وكره العاجزين، الذين لا يجدون لتجاوز آثارها الفاعلة سبيلاً إلا بالصراخ شأن كل المصدورين من المعمرين الذين أبرزوا في شكواهم ".. ما آلت إليه أحوالهم من ضعف، جر عليهم هواناً بين أهليهم، ومجتمعاتهم التي يعيشون فيها، مقارنين بين حالتهم هذه، وما كان لهم أيام التنعم بالشباب، والاستظلال بظله الوارف.."(16).
وكل ذلك يقف بنا على دور البيت الأخير في عملية التّطبب التي أشرنا إليها سابقاً، كأن الشاعر أمام عجزه القاتل واغترابه المدمر لم يجد ألا التذكر-وسيلة المهزومين من المكروبين-تذكر أنه كان فارس الهيجا الذي ترتجف لسيفه-يسل من غمده-قلوب الفرسان المغاوير .
أقول أن التذكر ها هنا ذو أهمية نفسية بالغة في مجال التخفف من بعض ويلات الإحساس بالاغتراب لأنه يلم بعضاً من شتات النفس الممزقة برفض الأهل لها، وتولي المجتمع عنها خاصة وأن هذا الرفض وذلك التولي قد يأخذان بعداً آخر أعمق في ممارسته وبالتالي في أثره، هو بُعد الاستخفاف إلى أبعد صور الاستخفاف، وهذا دريد بن الصمة الجشمي يفرده قومه في مكان معزول عن البيوت، رغبة عنه، ونفوراً منه، وكراهية لوجوده على قيد الحياة، ويوكلون به أمه أن تقوم على أمره، فإذا هي الأخرى تغدو غير عابئة به، ولا محتملة له، إذ كانت تقيده بقيد الفرس ثم تسير لحاجتها بعيداً عنه، ومر يوماً -عليه بعض رجال قومه، فسأل عن حاله، فأنشأ يقول :(17)
أصبحت أقذف أهداف المنون، كما يرمى الدريئة أدنى فوقه الوتر
في منصفٍ من مدى تسعين من مائةٍ كرمية الكاعب العذراء بالحجرا
في منزلٍ نازح م الحي منتبذٍ كمربط العير، لا أدعى إلى خبر
كأنني ضرب جزت قوادمه، أو جثةٍ من بغاتٍ في يدي هصر
يمضون أمرهم دوني، وما ققدوا مني عزيمة أمر ما خلا كبري
ونومةٍ لست أقضيها، وإن متعت، وما أمضى قبل من شأوي ومن عمري
وأنني رابني قيدٌ حبست به، وقد أكون وما يمشي على اثري
إن السنين إذا قربن من مائةٍ لوين مرة أحوال على مرر
من هذا الذي يبكي؟ إنه دريد بن الصمة الذي قال عنه عمرو بن معد يكرب الفارس المشهور: "لو طفت نطعينة أحياء العرب ما خفت عليها، ما لم ألق عبديها وحريها، يعني بالعبدين عنترة بن شداد العبسي، والسليك بن السلكة، والحرين: دريد بن الصمة، وربيعة بن مكرم.."(18)*، فهو أحد المعدودين أو كان أحد الموهوبين في الجزيرة كلها... ولن تجد أقسى من دموع مثل هذا الطراز من الرجال.
لقد كان سؤال هذا الرجل إياه فرصة عزت وندرت، حتى وجدناه يهتبلها، فيطيل الشكوى، ويفصل القول في الشأن الذي آل إليه، والحال التي صار إليها. ملمحاً إلى أخبار فروسيته وسط هذا الكرب، عل هذه الإلماعة تكون المخرج الذي ينتشله من صيروته هدفاً لنوائب الدهر وناسه، إذ الكل يقذفه بسهامه، حتى لكأنهم أطفال يتلهون برميه، لكنه لا يبعد في هذا الأمل كثيراً، وذلك أن الإحساس بالتلاشي والانهيار بأثر العزلة المفروضة عله، والهوان الذي كان ينبث إلى جوانحه كان أعتى وأكبر، ومن هنا وجدناه يعلن -في إطار شكواه هذه- أنه قد فقد القدرة بأثر ذلك على الإحساس ينفع ما يأتي أو يذر، حتى أن لحظات النوم لم تعد ذات أثر في النفس ولا في الجسد، بل إن التذكر لم يعد له ذلك الأثر السحري في إزاحة بعض الهموم عن النفس.
إنها -على وجه العموم- انكسارة حزينة لنفس شاعر فارس صال وجال، ثم آل أمره إلى حيث صار هين الشان حتى عند الأمة التي تلقى عليه قيداً لا يكون إلا للأنعام، تحبسه به عن الحركة، ولهذا جاء البيت الأخير نفسه مصدور، تقرر واقعاً مريراً لا تحتمله النفس:
إن السنين إذا قربن من مائةٍ لوين مرة أحوال على مرر
ومثل هذا التبرم الضائق بالعجز عن دفع النوائب والتضيع تراه عند ساعدة بن جؤية الهذلي، إذ يعلن لك أن الندم، والتحسر على مضي السباب ليس بدافع صاحبه أمام قهرية نزول الهرم والكبر، وأمام حقيقة أن الشيب -على حد تعبيره-: "داء نجيس لا دواء له".
وذلك إعلان يرسم الانهزام النفسي أمام ذلك الشيب الذي يصيب الجسد بالذبول والوهن، والحواس بالضعف والخور، حتى ليصير الإنسان غير قادر على فعل ا يجلب له الدفء في علاقته بالمجتمع، الذي لم يكن يرعى للكبير حرمة، فهو يقول:(19)
يا ليت شعري، ألا منجي من الهرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندم؟
والشيب داء نجيس، لا دواء له للمرء كان صحيحاً صائب القحم
وسنان، ليس بقاضٍ نومةً أبداً لولا غداة يسير الناس لم يقم
في منكبيه، وفي الأصلاب واهنةٌ، وفي مناصله غمزٌ من القسم
إن يأته في نهار الصيف لا تره إلا يجمع ما يصلى من الحجم
حتى يقال: وراء البيت منتبذاً: قم -لا أبا لك- سار الناس، فاحتزم
فهو يشعرك بتفلت حرارة الشعور بالتواصل مع الآخرين، من خلال الإعلان عن نظرة هؤلاء الآخرين إليه على أنه عبء ثقيل، وعضو مرفوض منبوذ، ويرسم لك البيت الأخير دائرة الإهمال التي كان يطرح فيها وأمثاله من أبناء المجتمع.
وينقل إلينا أحد المعمرين وهو مسافع بن عبدالعزى الضمري صورة نابضة لما كان يدور بين الأشيب وغيره إن جمعه به مجلس، حيث ترى صورة للتبرم النفسي والتأزم أو الضيق بهذه العزلة التي كانت تفرض من قبل المجتمع عليه وأترابه، فيقول:(20)
جلست غدية، وأبو عقيل، وعروة -ذو الندى- وأبو رياح
كأنا مضر حيات برضوى ينؤن -إذا ينؤن- بلا جناح
يرانا أهلنا لا نحن مرضى، فنكوى، أو نلد، ولا صحاح
ولا نروى العضال إذا اجتمعنا على ذي دلونا، والحفر طاح
فالمجتمع يشعرهم بأنهم جزء منه يجب بتره، لا تقديم الدواء له، إذ هو جزء فقدت لرغبة في بقاءه وذلك على الرغم من أن نفوس هؤلاء قد طويت على خلال تؤهل أصحابها للمشاركة الإيجابية، لولا إباء المجتمع ورفضه، وذلك نفهمه من تصوير الشاعر نفسه ومن معه على تلك الحال بالمضرحيات (الصقور)، التي سلبت أجنحتها، وهي قوتها ووسيلتها لممارسة مهامها في الحياة.
لكأن الشاعر يرمز إلى ما فرض عليه وأترابه من عزلة اجتماعية بغيضة هادمة للأمل في النفس بهذه الصورة البيئية المعبرة...
وقد كان الشاعر ها هنا مترجماً لواقع ممض للنفس، مبيد لكل اقتدار على التماسك حين أعلن أن المجتمع مبالغة في الإذلال يضعه وأصحابه في منطقة الأطراف من احتفاله واهتمامه:
يرانا أهلنا لا نحن مرضى، فنكوى، أو نلد، ولا صحاح
لقد كانت الشيخوخة سبة وسوءة في نظر المجتمع على ما يبدو، بل كانت سبباً وجيهاً لدى من يطعمون في المكانات الاجتماعية، كي يتمكنوا بها من عزل الشيوخ، لا عن الدور الاجتماعي القيادي الذي يمارسونه حسب، ولكن عن الحياة الاجتماعية كلها، ويصادفنا في هذا المجال موقف ذي الإصبع العدواني، وكان له باع عريض في السيادة والقيادة والحكمة والشعر، ولكنه صار كبيراً، وتلك -في نظر المجتمع أو بعض أبناءه- سبة كافية لسلبه مكانته، ولم يجد الرجل إلا الصراخ الذي يعلن عن نفس أضناها هذا التنكر، بل الإجحاف، ولا يجد إلا تذكير المجتمع بأياديه، وإعلان قصر باع من سلباه هذه المكانة، طمعاً منهما فيها عن أن يبلغا في ميدان المحامد مبلغه(21)
إنكما صاحبيّ لن تدعا لومي، ومهما أضع، فلن تسعا
إنكما- من سفاه رأيكما- لا تجنباني الشكاة، والقذعا
إلا بأن تكذبا علي، ولن أملك أن تكذبا، وأن تلعا
إن تزعما أني كبرت، فلم أُلْفَ بخيلاً نكسا، ولاورعا
أجعل مالي دون الدَّنا غرضا وما وهى م الأمور، فانصدعا
كما هو معلوم ملموس من واقع حياة البشر فإن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، ولهذا ترى أن سورة الألم النفسي والشعور باجتواء الحياة كلها كانت تشتد حين يستشعر الأشيب الإذلال ممن يتوقع منهم التوقير والإجلال، وهم أبناؤه أو الخاصة من أقربائه، إذ يسكن نفسه إذ ذاك الإحساس بخيبة الأمل، وذلك إحساس قاتل يسلم إلى حالة من الاغتراب النفسي التي تصل بالأشيب إلى تمني الموت .
ويحدث ذلك غالباً حين يجد الأشيب أولاده أو حفدته كارهين لوجوده، يبغضون رؤيته، ويتأففون من كلامه، ويرمونه الخرف، وينهرونه عن الحديث حين يهم به، وقد تعرض كعب بن دارة النخعي لمثل ذلك كله فصرخ:(22)
لقد ملني الأدنى، وأبغض رؤيتي، وأنبأني أن لا يحل كلامي
على الراحتين مرة، وعلى العصا أنوء ثلاثاً، بعدهن قيامي
فيا ليتني قد سخت في الأرض قامةً، وليت طعامي كان فيه حمامي
وفي هذه الصرخة ترى ذل الرجل مجسداً يكل برأسه من بين كلمات كل جملة ها هنا، ليعلن لك أنه لا خير في العيش بعد الشيب والكبر، وتجربة هذا الرجل حميمة الصلة بتجارب كثيرة ما زلنا حتى اليوم نراها، ويصل إلى أسماعنا نبأها بين لحظة وأخرى، فلا ترى النفس موقفاً ابغض من موقف يكون فيه الأشيب على تلك الحال من الإذلال.
على أنه قد يخفف من غلواء الإحساس بالإذلال والامتهان في مثل هذه التجربة أن يكون الأشيب من عامة الناس، أو ممن لم تكن له في السابق مواقف فاعلة في حياة المجتمع، أما أن يكون قائداً ورائداً وسيداً، ثم يمر بهذه التجربة فإن وقع ذلك في نفسه يكون على النحو الذي يلجم الأقلام وقبلها الألسن، إذ ليس بالهين أن تسقط كل هالات المجد وشاراته أو تنهار كل صخرة واقعي اجتماعي بغيض أو إنساني مرذول.
وقد تعرض لهذه التجربة القاسية عدي بن حاتم فارس الفتوحات، وصاحب راية طيء في صفين وحامل لواءها.. لكنه كبر ورق عظمه، فإذا العامة يتولون عنه قبل الخاصة، ويتحول الكل من الإعظام إلى التضييع والإهمال، فيصير الرجل في حاجة إلى أن يستدر عطف القوم عليه، وبرهم به، وحنوهم عليه.
لقد أسن الرجل فاستأذن قومه في وطاءٍ، يجلس عليه، ومت إليهم في ذلك الطلب بكبره ورقة عظمه فقالوا: ننظر، فلما أبطأوا عليه ملأه الإحساس بالإهمال والتضييع، وأنه صار كهلاً، فأنسأ يقول:(23)
أجيبوا يابني ثعل بن عمرو، ولا تكموا الجواب من الحياء
فإني قد كبرت، ورق عطمي وقلّ اللحم من بعد النقاء
وأصبحت الغداة أريد شيئاً يقيني الأرض من برد الشتاء
وطاءً! يا بني ثعل بن عمرو، وليس لشيخكم غير الوطاء
فإن ترضوا به فسرور راضٍ، وإن تأبوا فإني ذو إباء
سأترك ما أردت لما أردتم وردك من عصاك من العناء
لأني من مساءتكم بعيدٌ كبعد الأرض من جو السماء
وإني لا أكون بغير قومي فليس الدلو إلا بالرشاء
أسمعت عن أثر أقوى من هذا الأثر تحدثه الشيخوخة بالنفس؟ إن الرجل كان بالأمس القريب يحمل اللواء ويرن بذكر اسمه وسمع الزمان، ولا يصدر القوم في كبير ولا صغير إلا عن رأيه ومسورته قد عذا هكذا، لإيجاب دعاء، ولا يسمع له توسل، ولا يتحقق له رجاء، مع أنه يحدثهم بانكسارة الضعفاء المحزونين، معلناً لهم أن الشيخوخة قد جعلت آماله في الحياة تنحسر، وتنحسر، حتى صارت لا تتجاوز مجرد الحاجة إلى شيء هين هو الوطاء، وليس غيره، ثم هو يطلب هذا الشيء الهين في تودد وتذل وإعلان أن الأمر كله وقفاً على رضاهم، إذ هو قد فقد القدرة على الإلزام، حتى ليصدق عليه تماماً مضمون قول عدة بن الطيب(24)
إن الكبير إذا عصا أهله ضاقت يداه، بأمره ما يصنع
بل إنه أعلن لهم عن هذا المضمون حين قال لهم:
سأترك ما أردت لما أردتم وردّك من عصاك من العناء
وأيضاً حين أعلن أنه من مساءتهم بعبد، كعبد الأرض من جو السماء، وذلك إعلان يشف عما تحته، إذ يشير إلى أنه قد غدا بالشيب لا حيلة له، فنفسه مترعة بالتأزم والشعور بخيبة الأمل، وهو شعور مهلك للنفس التي يسكنها أو يكاد، خاصة إذا كان صاحبها يعيش في مرحلة الشيب.
ولعل هذا التصور هو الذي أسس لوجود هذا البيت الأخير، الذي يعلن الشاعر فيه عن الانتماء لقومه إلى ابعد ما يكون الانتماء:
وإني لا أكون بغير قومي فليس الدلو إلا بالرشاء
غير أن ذلك الانتماء الذي ابعد الشاعر في إعلانه ليس إلا انتماء في الظاهر حسب، حتى ليصبح أن نسميه احتماء، احتماء من آلام الاغتراب التي تكاد تعصف بالنفس عن طريق الاندفاع إلى إعلان الانتماء، وتلك بلا شك مفارقة عجيبة في معالجة الموقف النفسي التي عاشها الشاعر، وقد كان الشاعر فيها محنكاً، أو استدعاه الموقف أن يكون كذلك، ومن هنا تراه قد استخدم كثيراً من ظلال الألفاظ في هذا الاتجاه، اتجاه تذكيرهم بواجبه عليهم، وحقه قبلهم، حتى تمكن في النهاية من تحقيق بعض ما كان يود تحققه وحدوثه، إذا انعطفت إليه بعض القلوب، "فأذنوا له أن يبسط في ناديهم، وطابت به أنفسهم، وقالوا: أنت سيدنا شيخنا وسيدنا، وما فينا أحدٌ يكره ذلك، ولا يدفعه.."(25)
وكثيرة هي التصورات التي يمكن أن نعزي إليها نجاح الشاعر في التوصل عند نهاية تجربته إلى مبتغاه وعلى راس هذه التصورات أن شاعر هذه التجربة كان إذ ذاك يعيش في الإسلام، وهو الذي كان قد هيأ النفوس لإجلال ذي الشيبة المسلم، وفيما وقفنا عليه من تجارب في هذا المجال ما يدعم ذلك، فالأشيب الذي صرخ من وقع الشيب على نفسه في المجتمع الجاهلي لم يكن يحصل من شكواه على طائل أبعد من ارتداد صدى هذا الصراخ إلى نفسه ليضاعف ذلك من آلامه، ويزيد من ضيقه وتأزمه، ويعمق -بالتالي- من شعوره بالاغتراب النفسي في محيطه، ولذلك نجد أن كل واحد منهم اصطفى لنفسه أسلوباً يتمكن من اجتياز أزمته النفسية أو على الأقل يخفف به من حدة وقعه على نفسه، حين لم يجد لشكواه صدى في نفوس أبناء مجتمعه، ومن هنا وجدنا اللذين يسلكون سبيل الاستسلام وإظهار الانهزام، إلى جوار الذين يعلنون عن بعض التجلد والتماسك، وعدم التضعضع أما ريب الدهر، إلى جوار الذين أعلنوا التمرد والغضب، والرفض لبلادة المجتمع تجاه مصابهم كما وجدنا الذين لم يستطيعوا هذا ولا ذلك فاتخذوا من النزوع إلى الماضي، والهرب النفسي من الحاضر سبيلاً للانفلات من وقع الإحساس بالغربة في المجتمع، فضلاً على الذين امتلكهم اليأس والقنوط فلم يجدوا إلا تمني الموت، كي يتخلصوا من لهيب الحاضر الذي أصبحوا فيه يقادون كما تقاد المطايا وهو ما يمكن عرضه على النحو