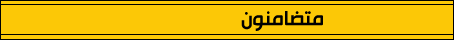هويدا رأفت الجندى
مراقب عام



عدد الرسائل : 4821

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 10158
ترشيحات : 11
الأوســــــــــمة : 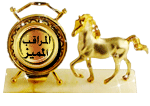
 |  موضوع: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى موضوع: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى  14/9/2009, 14:18 14/9/2009, 14:18 | |
|
الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى
إن القصد إلى تحسّس وعي أعلام التراث النقدي والبلاغي العربي بإشكال اللفظ والمعنى، وما يترتب على ذلك من تبصر ببنية الخطاب عموماً، يستدعي العناية بالأصول اللغوية وتأثيرها في المسائل الأسلوبية لما للعلائق بين المجالين من صلات حميمة. وتتأكد هذه الصلات الحميمة بين المباحث الأسلوبية والنقدية والآراء اللغوية لدى بعض النقاد والبلاغيين خاصة، كالجاحظ، الذي بالإضافة إلى رأيه في أقسام البيان عامة وملاحظاته المتعلقة بالظاهرة اللغوية خاصة مما يشكل إطاراً عاماً لهذه المباحث، تمتد تصوراته الأسلوبية ومقاييسه البلاغية في رسوخ في نظريته في الكلام، إذ هو: "أول مفكر عربي نقف في تراثه على نظرية متكاملة تقدر أن الكلام، وهو المظهر العملي لوجود اللغة المجرد، ينجز بالضرورة في سياق خاص يجب أن تراعى فيه، بالإضافة إلى الناحية اللغوية المحضة، جملة من العوامل الأخرى كالسامع والمقام وظروف المقال وكل ما يقوم بين هذه العناصر. غير اللغوية "Extra linguistique من روابط" .
ولئن كان تفاعل هذه العناصر سيكون المسؤول عن تحديد خصائص الكلام، فإن المرور إلى معاينة هذه الخصائص يستوجب الاقتراب من تصور الجاحظ أوجه استعمال الظاهرة اللغوية، وسنجد في محتوى الحدود الضابطة مضامين مصطلح البلاغة، وما يدور في مجالها، أو يتقاطع مع فعاليتها كالفصاحة، والبيان حين تترادف دلالته مع دلالة البلاغة والفصاحة ما يقرب من هذه الحقيقة.
وهذا ما نجلوه من استقراء كل من عبد السلام المسدي وحمادي صمود، إذ رغم اتفاقهما على تنوع المضامين المستخلصة من تلك المصطلحات، نجد المسدي يؤكد وعي الجاحظ بثنائية توظيف الظاهرة اللغوية بين دلالة غايتها البث كما تتبدى في الاستعمال اللغوي العادي، ودلالة أسلوبية غايتها الخلق الفني كما تظهرها خصائص النص البنائية ، في حين يتحفظ صمود إزاء هذا الفصل مبوئاً وظيفة الفهم والإفهام الصدارة، لكنه لا يلبث وهو يتعقب دلالات مصطلح "بيان" حين يتطابق مع مصطلحي "فصاحة" و"بلاغة" أن يقرَّ بما يتوافق مع الوظيفة الشعرية للخطاب، وذلك حين يرى أن مضمون "بيان" يتجاوز مرتبة الكشف عن المعنى من أي طريق كان إلى: "كيفية في بلوغ تلك الغاية وهيئة مخصوصة يكون عليها الخطاب تجعله معطى حضورياً قائماً بذاته بينما كان في الفعل اللغوي العادي غائباً وراء ما يؤديه" .
ولقد أشار غير حمادي صمود إلى مكانة وظيفة الفهم والإفهام في بلاغة الجاحظ حيث يرى أمجد الطرابلسي أنه من أجل هدف تسهيل إفهام الفكرة فقط، يكون من الضرورة الاعتناء بشكل الخطاب لدى الجاحظ طبعاً إلا أنه ورغم وجاهة الإقرار بتبوّء وظيفة الفهم والإفهام مكانة متقدمة لدى الجاحظ وفي التراث النقدي العربي كله، إذ إن جدوى الخطاب وفائدة القول ركنان مكينان في كل مباشرة كلامية، ولا أدل على ذلك من مكانة المعنى في كل محاولة نقدية وتعدد ما أسند إلى هذه الدلالة من مفاهيم ، فإن الإلحاح على تعهد الصياغة بالعناية البالغة وترسيخ مفهوم الصنعة في الشعر خاصة، مع الإشارة إلى حضور الأنواع الأدبية المختلفة وخاصة الخطابة والشعر، وكذلك القرآن باعتباره قمة البيان المعجز في كل محاولة تقنين لظاهرة الأسلوب، يفسح المجال للإقرار بأن القدماء واعون بتحرك القول ضمن مسار الاستعمال المألوف الهادف إلى الاتصال أساساً، ومسار الاستعمال غير المألوف، وإن لم ينتف منه القصد إلى الفائدة، ذلك أنه مع الإشارة إلى أن استخلاص مقاييس الأسلوب كان شاملاً لكل كلام بليغ، إلا أن ذلك لا يعدو من منظور أولي ضبط الأسس والقواعد العامة التي تأخذ طابعها المتخصص عندما يتعلق الأمر بنوع أو بآخر، ولا أدل على ذلك من إقرارهم أن القرآن صيغ بأسلوب العربية غير أنه معجز فوق مقدور البشر، معنى ذلك أن عملية التشكيل الفنّي للظاهرة البلاغية في القرآن الكريم ترتقي درجة الإعجاز وتتفرد من ثمة بحكم طريقة الصياغة وأساليب تشكيلها، وكذلك الشعر، إذ يجمعون على تميز خطابه بخصوصية في تشكيل المعنى، حيث يترسخ الوعي بخصوصية هذا الخطاب في مقابلة الشعر بالنثر، علماً بأن الوعي بالخواص البنيوية للغة كل نوع متفاوتة لدى النقاد، لكنها حاضرة بكل وضوح لدى البعض كالجاحظ وأبي حيان التوحيدي ، وشديدة الوضوح لدى الفلاسفة الإسلاميين .
فالخطاب الشعري في الثقافة العربية الإسلامية قديماً لا يعدو من منظور أصول المعاني أن يكون مكروراً، إذ إن ترسيخ القيم التي أفرزتها قناعات ثقافية شتى، وربط الشعر بالقديم الراسخ في الجاهلية حصر للفعل الإبداعي في الشعر في الإخراج المتجدد للمألوف، وفي هذا الإخراج مفارقة إذ إنه إذ يظل أميناً للخطوط العريضة لمسارات المعنى في كل تفرعاته ينحت الشاعر لنفسه التفرد والتميز في الصورة المخرجة للمعنى المتميزة بخصوصية العبارة، أو الاختراع الجزئي المتمثل في التفريع والتوليد، من هنا لم يكن المتلقي يبحث عن الجديد بالدرجة الأولى بقدر ما كان يستهدف اللذة الحاصلة من التجدد الطارئ على المعروف.
ولقد تبدى الوعي بتفرد بنية القصيدة الشعرية مبكراً إذ يكفي استطلاع آراء اللغويين من أمثال الخليل بن أحمد القائل: "الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلّت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم ولا يحتج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل" ، وابن الجمحي في تأكيده دور الضرورة الشعرية النابعة من قيود الوزن والقافية في قولـه: "والمنطق على المتكلم أوسع منه على الشاعر والشعر يحتاج إلى البناء والعروض والقوافي، والمتكلم مطلق يتخير الكلام" ، للتأكد من حضور مفهوم النوع الأدبي في التقنين لبنية النص ومقاييس الأسلوب. هذا الحضور الذي يأبى اختزال خصوصية الشعر في اعتباره نثراً تزينه موسيقى – على حد عبارة حمادي صمود – إلى الإقرار بأنه حسب رأيه أيضاً "مغاير للنثر منفرد ببنية لغوية متميز بلغة لا تخضع لنفس القوانين التي تترتب حسبها اللغة والأشياء في النثر" ، وهذا الوعي بتميز البنية اللغوية في كل نوع ليس إلا انعكاساً لتباين الوظائف المسندة إلى كل واحد منها.
أما شأن هذه المسألة عند الجاحظ، فإننا نراه قد أفرد بلاغة النثر بقسم من البيان والتبيين واستشهد عليها بأنواع النثر المتداولة في عصره حيث "أقام بذلك الدليل على أنه يعتبر النثر الفني ندا للشعر كفؤاً" ، فإذا أدركنا أنه حاد الوعي بتفرد الشعر ببنية مخصوصة تجعله مستعصياً على الترجمة ، أصبح بالإمكان الإقرار بأن حضور هذه الأنواع في بلاغته سيطبع تصوره لمشكلة اللفظ والمعنى، والبنية العامة بطابع التداخل، أو ازدواجية النظرة وسيغلب هيمنة نوع أو نوعين في استخلاص مفاهيم هذا المستوى أو ذاك، فحديث الجاحظ عن البنية العامة الذي ينحصر بين درسه النظم وإلحاحه على تلاحم الأجزاء وحسن الوصف نابع من استقراء بنية النص القرآني والشعر أساساً.
هذا الإطار العام مكّن الجاحظ من تحقيق الوعي بمرتبتي الكلام: العادي والأدبي والفصل بينهما، ذلك أنه يرى أن "كلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات، فمن الكلام الجزل والسخيف والمليح والحسن، والقبيح والسمج، والخفيف والثقيل، وكله عربي وبكل قد تكلموا، وبكل قد تمادحوا وتعايبوا" . هذه المساحة العامة للكلام الواقعة بين قطبي السخيف السوقي الصادر عن طبقة العامة دون شك والمليح الحسن الذي يكون محصلة الصنعة والاعتناء الذي يضعه أهل القول البليغ، تتحدد بخواص في الكلام ذاته، ذلك أن "العامة ربما استخفت أقل اللغتين أو أضعفهما، وتستعمل ما هو أقل في أصل اللغة استعمالاً وتدع ما هو أظهر وأكثر" ، في حين يكون البصر بجوهر الكلام البليغ عند رواة الكتاب أعم، وعلى ألسنة حذاق الشعراء أظهر، هذا الجوهر المتحقق بالاعتماد على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة وعلى "الألفاظ العذبة والمخارج السهلة، والديباجية الكريمة، وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد، وعلى كل كلام لـه ماء ورونق، وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للسان باب البلاغة ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ، وأشارت إلى حِسان المعاني" .
وهذا الصنف من الكلام المتميز بالخصائص الفنية يقتضي الإخراج المتأني الواعي كما يتحقق في التنقيح والصنعة وحذف فضول الكلام حسب ما تشخصه مقولة: خير الشعر الحولي المنقح ، أو العناية البالغة بالخطابة وتدبير القول خاصة إذا دعت المقاصد إلى ذلك. وعلى العموم يحتاج البيان في هذا المستوى الفني "إلى تمييز وسياسة، وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة" . من هنا يتحقق للمستويين السابقين ضوابط تتنزل في مجرى "المقابلة التي أقامها الجاحظ بين "البيان" و"حسن البيان" . فالمستوى العادي يلح على الإفهام لمجرد الإبلاغ والإخبار في حين يتحقق في المستوى الثاني من توظيف الظاهرة اللغوية تحسين الإبانة، كما يتمثل ذلك في سياق تعليق الجاحظ على قول العتابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ، إذ يرى الجاحظ أنه "لم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه، بالكلام الملحون، والمعدول عن جهته، والمصروف عن حقه، أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان، بعد أن نكون قد فهمنا عنه. فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة، والخطأ والصواب، والإغلاق والإبانة، والملحون والمعرب، كله سواء... وإنما عني العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء" .
وتأسيساً على ما سلف يكون تحرك الجاحظ لضبط خصائص الصياغة الجميلة المخرجة للقول وفق معايير البلاغة شاملاً، يطول اللفظة في مستواها الإفرادي ثم في علائقها بالمعنى، إلى غاية فهم لحمة الوحدات في السياق الواحد في ما أسماه بالنظم أو حسن التأليف والنسج. ونكتفي بالإشارة إلى رصد الجاحظ مبدأ الاختيار الأول المتجسد في اللفظة والمنطلقات المؤسسة لهذا الاختيار، حيث يترسخ اشتراط الجاحظ في اللفظة المفردة انسجام وحداتها الصوتية المشكلة لبنيتها كما يتحقق ذلك في ائتلاف هذه المكونات مما ينتج عنه صفات يجمل بعضها في "ما رَّق وعذب وخف وسهل" أو غيرهما مما أجمله أيضاً في حاجة المنطق "إلى الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى الجزالة والفخامة" ، وأوصاف أخرى تبدو انعكاساً لتصور أخلاقي من مثل قوله أن يكون اللفظ كريماً في نفسه ونكتفي بهذه الإشارة رغم تأكيد أهمية شرط الاختيار الأول المتمثل في اللفظ المنتقى وفق الشروط المحددة ودوره في بلاغة النص عامة لنمرّ إلى العنصر الأهم في موضوعنا الذي يتجسد في علاقة اللفظ بالمعنى.
فرغم إشارة الجاحظ إلى إمكان وجود معنى بدون لفظ فإنه يرى مستحيلاً أن "يكون اللفظ اسماً إلا وهو مضمن بمعنى، وقد يكون المعنى بلا اسم، ولا يكون اسماً إلا وله معنى" . والتمييز بين الحقلين لم يمنع من الدعوة إلى إحداث أشكال من الائتلاف بينهما أو تطابقهما. ويتحقق هذا الائتلاف في مستويات شتى منطلقها أساس وجودي – إن صح الوصف – يقوم على مقابلة المعنى واللفظ بالروح والجسد إذ إن "الأسماء في معنى الأبدان والمعاني في معنى الأرواح. اللفظ للمعنى بدن، والمعنى للفظ روح" ، وتتبدى عملية الاحتواء اللفظي للمعنى كتضمن البدن للنفس فالنفوس "المضمنة كالمعاني المضمنة" .
هذا المستوى الكوني يضيق ليتلبس بلبوس الأصول الاجتماعية والمنظور الأخلاقي ذلك أن "من أراد معنى كريماً فيلتمس لـه لفظاً كريماً، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف" ، ثم تتبسط المقابلات في أزواج ثنائية تمتد لتحكم صلة المعنى باللفظ خارج أطر المعتقدات الاجتماعية والأخلاقية لتتأسس وفق خواص في المعنى ذاته من حيث الوضوح والالتباس وذلك في قوله: "إنما الألفاظ على أقدار المعاني، فكثيرها لكثيرها، وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها، وسخيفها لسخيفها، والمعاني المفردة البائنة بصورها وجهاتها، تحتاج من الألفاظ إلى أقل مما تحتاج إليه المعاني المشتركة، والجهات الملتبسة" ؛ فإذا كان بدء العلاقة بين الطرفين يقوم في الملاحظة السابقة على أساس كمّي فإن تفاعلهما تعمقه طبيعة المعنى ذاته، ذلك أن الغموض والالتباس يحتاجان إذا قصد التوضيح إلى الإطالة والشرح حيث إن عملية التفاعل محكومة بخصوصية في المعنى ذاته، ويتأكد هذا المجرى من منظور الكم أيضاً، فالمعاني "إذا كثرت والوجوه إذا افتنت، كثر عدد اللفظ، وإن حذفت فضوله بغاية الحذف" .
وانطلاقاً من هذه العلاقة بين المعنى واللفظ القائمة على أسس وجودية واجتماعية، ومحكومة بفكرة الإبداع، يكون إيلاء أحد الطرفين الأولوية في التعبير مساً وتشويهاً لعملية التعبير نفسها، فشر "البلغاء من هيّأ رسم المعنى قبل أن يهيئ المعنى عشقاً لذلك اللفظ وشغفاً بذلك الاسم حتى صار يجر إليه المعنى جراً ويلزقه إلزاقاً" ، ذلك أن عدم إيفاء المعنى الغامض في ذاته حقه في اللفظ الملائم والمطابق والتعلق ببراعة اللفظ ونشدانه إحداث لعدم التوازن بين طرفي الدلالة "فاختر من المعاني ما لم يكن مستوراً باللفظ المنعقد مغرقاً في الإكثار والتكلف فما أكثر من لا يحفل باستهلاك المعنى مع براعة اللفظ وغموضه على السامع بعد أن يتسق له القول وما زال المعنى محجوباً لم تكشف عنه العبارة فالمعنى بعد مقيم على استخفائه وصارت العبارة لغواً وظرفاً خالياً" . وتأسيساً على ما سبق تكون "القاعدة الأولى والعامة لعلاقة اللفظ بالمعنى تقوم عنده على مطابقة اللفظ للمعنى" والجاحظ صريح في استخلاصه هذا المبدأ إذ يقول: "من علم حق المعنى أن يكون الاسم لـه طبقاً، وتلك الحال لـه وفقاً، ويكون الاسم لـه لا فاضلاً ولا مفضولاً، ولا مقصراً، ولا مشتركاً، ولامضمناً" . وعدم إيفاء هذا الأصل حقه من العناية يؤدي إلى اختلال التوازن بين الألفاظ والمعاني فيمتد أحد الطرفين على حساب الآخر، فالزنادقة: "أصحاب ألفاظ في كتبهم، وأصحاب تهويل، لأنهم حين عدموا المعاني ولم يكن عندهم منها طائل، مالوا إلى تكلف ما هو أخصر وأيسر وأوجز كثيراً" .
ويأخذ مبدأ المطابقة والمشاكلة بين المعنى واللفظ مدى أوسع يصبح بمقتضاه تلازم المعنى واللفظ انعكاساً للوظيفة المبتغاة أو تمشياً مع خاصية في اللغة كقيامها على غزارة الدلالات، أو محكوماً بمفهوم للنوع الأدبي، فمبدأ الوضوح واعتماد الدلالة التصريحية في علاقة اللفظ بالمعنى مشروطان بتحقيق وظيفة تبليغية مباشرة إفهامية، كما يستشف ذلك من قول الجاحظ معرفاً البيان بأنه "الدلالة الظاهرة على المعنى" ، وأن "أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه" ، هذه الضوابط التي تجد سندها في مقياس التزامن الذي يجسد التقبل الآني للدال والمدلول وهو ناتج عن "مراعاته للمقامات ولا سيما المقام الخطابي" ، يظهر ذلك في مثل قوله ملخصاً نتيجة إيفاء كثير من شروط التطابق بين المعنى واللفظ ضوابطها التي تكون محصلتها امتناع أن يكون "اللفظ أسرع إلى السمع من المعنى إلى القلب"
، وأن الاسم لا "يستحق اسم البلاغة حتى يطابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك" ، لكن إذا كان هذان المبدآن يجسّدان أثر العناصر الحافة بالخطاب في بنية الخطاب نفسه تدعمهما مقتضيات الخطابة كنوع يقتضى خصائص منها الوضوح والتزامن باعتبارها عوامل تكفل للخطاب نجاعته وجدواه، وتتمشى مع الدلالة الصريحة للغة، إلا أن هذا الموقف المؤسس على الاهتمام بفعالية الدلالة المباشرة ينافسه الإقرار بثراء الدلالة اللغوية المتأتية من إمكان التعبير المتعدد والمتنوع عن المتصور الواحد، إذ إن من مميزات لغة الأسلوب الأدبي عند الجاحظ "اعتمادها على الطاقات الإيحائية في الظاهرة اللغوية أكثر من اقتصارها على طاقاتها التصريحية" . فإذا كان لابد من الإقرار بأن العدول عن التصريح إلى الإيحاء كان في بلاغة الجاحظ محكوماً بمقتضيات "المقام والمواضعات الاجتماعية من ناحية، وأصول الاعتقاد الاعتزالي من ناحية أخرى" ، فإنه لابد من الإشارة أيضاً إلى أن للنوع الأدبي كما يتجسد في الشعر هنا، والكتاب المعجز، دوراً حاسماً في تأكيد دور الطاقة الإيحائية في كسر مبدأي الوضوح والتزامن باعتبارها مميزاً رئيسياً للأسلوب الأدبي، والامتداد بالدلالة إلى مدى أوسع تحتاج بمقتضاه إلى تعميق النظر لتحقيق الفهم، هذا الفهم الذي يكون محصلة تفاعل المتلقين مع الطاقات الكامنة في النص حيث يتيح لها هذا الكمون الانفتاح على مبدأ التأويل لاستجلاء خفاياه.
إن الاصطلاحات المحددة لطاقة الإيحاء في اللغة التي تتنوع بتنوع المواقع المجلية لهذه الخاصية التي يجمل الجاحظ معظمها في "الوحي والإشارة والإيجاز والكناية والتعريض" ، تجد مبررها الأكيد في الخطاب الشعري عموماً والقرآن الكريم باعتباره خاصية فردية في اللغة العربية خصوصاً. فالإيحاء يوفر إمكان التعبير المتعدد عن المعنى الواحد، إذ إن الناس قد يستعملون "الكناية وربما وضعوا الكلمة بدل الكلمة يريدون أن يظهروا المعنى بأبين اللفظ" ، إلا أنه" ربما كانت الكناية أبلغ في التعظيم، وأدعى إلى التقديم، من الإفصاح والشرح" ؛ وهذا المبدأ يتفاعل مع متطلبات النوع الأدبي. فاقتضاب اللفظ وقصد الإيجاز إنما هو خاصية شعرية إذ من خواص اللغة الشعرية قيامها على الوحي والإشارة والتكثيف. من هنا كانت الأمثلة الشعرية للإيجاز لدى الجاحظ تقتضي إعمال الذهن لمحاصرة المعنى، إذ إن مبدأ التزامن في تلقي الدال بالسمع والمعنى بالقلب ينحصر ليتيح انفساحاً زمنياً يستوجبه تتابع دوائر الصياغة للوصول إلى المعنى. فمن الأمثلة التي يضربها للإيجاز وحذف الفضول قول بعضهم يصف "كلاباً في حال شدها وعدْوها، وفي سرعة رفع قوائمها ووضعها، فقال: كأنها ترفع ما لم يوضع.
... ومن الإيجاز المحذوف قول الراجز،ووصف سهمه حين رمى عيراً كيف نفذ سهمه وكيف صرعه، وهو قوله:
"حتى نجا من جوفه وما نجا".
ولاشك أن التضاد الدلالي في ترفع ويوضع والتجانس في نجا المكررة يركز حضور الصياغة نفسها ويحقق إعجاباً أو لذة بالإضافة إلى انه يدهش الذهن بتصادم المدلولات في السياق الواحد مما يتجاوز بالقول حد الإفهام فقط إلى مستوى الإطراب أو التعجيب.
والإيجاز خاصية من خواص الأسلوب في القرآن الكريم، يقول الجاحظ إن له كتاباً جمع فيه آياً من القرآن "تعرف بها فصل ما بين الإيجاز والحذف،وبين الزوائد والفضول والاستعارات، فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة... فمنها قوله حين وصف خمر أهل الجنة (لا يصدّعون عنها ولا ينزفون( وهاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا". وتكثيف الدلالة الذي يتجسد مقوماً رئيسياً في النص الكريم، يؤكد مبدأ التأويل الذي هو بالإضافة إلى أنه نتاج استغلال الطاقة الإيحائية في اللغة عموماً، يمثل أصلاً في التعامل مع أسلوب القرآن الكريم القائم على استغلال هذه الطاقة. هذا الاستغلال الذي يترتب عليه شحذ الذهن لمحاصرة الدلالة التي تعمق مبدأ التفاوت بين المتلقين في فهم فحوا الخطاب. ومبدأ التأويل طبيعي إذ لو لم يكن لكان ((ينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متفقاً على تأويله، كما يكون متفقاً على تنزيله، ولا يكون بين جميع النصارى واليهود اختلاف في شيء من التأويلات. وينبغي لك أن لا ترجع إلاّ إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظها، ولو شاء الله أن ينزل كتبه ويجعل كلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير لفعل، ولكنّا لم نر شيئاً من الدين والدنيا دفع إلينا على الكفاية، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة، وذهبت المسابقة والمنافسة، ولم يكن التفاضل، وليس على هذا بنى الله الدنيا" .
إن مبدأ التأويل يُحطّم مقولة الوضوح والتزامن في الخطاب ليبني الدلالة في طبقات من المعنى يصل إليها الذهن بعد فترة، ذلك أن مبدأ الغموض في النص يتماشى مع لذة الذهن في استكناه المجهول والطرق على باب الغامض مراراً لينفتح، يروي عبد القاهر الجرجاني عن الجاحظ فيما يتعلق بفضيلة الفكر والنظر فيرى أن: "رهان العقول التي تستبق ونضالها الذي تمتحن قواها في تعاطيه هو الفكر والرّوية والقياس والاستنباط" . ذلك "لأن الشيء من غير معدنه أغرب،وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم وكلما كان أبعد في الوهم، كان أطرف وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع" .
وهذه الازدواجية القائمة على الدعوة إلى المشاكلة والمطابقة بين طرفي الدلالة لتحقيق الوضوح في الخطاب والإقرار بطاقة الإيحاء في اللغة تنعكس في موقف مزدوج من الصنعة أيضاً. صحيح أن الدعوة إلى الوسطية في انتقاء المعجم اللفظي في أنه "كما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً وساقطاً سوقياً، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً" ، تبدو من مقتضيات تحقيق الإفهام كما يتجسد في وضوح الدلالة، إلا أن تحقيق الغموض المحوج إلى التأويل لا يقتضي توظيف الغريب أو الوحشي، ذلك أن خفي الدلالة يولده السياق أساساً، وهذا لا يتنافى مع ما يشرطه الجاحظ من مقاييس أسلوبية. وإذن فموقف الجاحظ المزدوج من الصنعة يؤكده تحرك الصياغة في مسارين رئيسيين يشملان أوساطاً لا شك بهما، فغاية الإفهام وتحقيق الوضوح يكونان مدعاة إلى الاقتصاد في تأليف الكتاب، حتى لا "يهذّبه جداً، وينقّحه ويصفّيه ويروقه، حتى لا ينطق إلا بلبّ اللبّ، وباللفظ قد حذف فضوله، وأسقط زوائده، حتى عاد خالصاً لا شوب فيه، فإنه إن فعل ذلك، لم يفهم عنه إلا بأن يجدد لهم إفهاماً مراراً وتكراراً" ، ومن صفات البليغ أيضاً ان "لا يدقق المعاني كل التدقيق، ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح، ولا يصفيها كل التصفية، ولا يهذبها غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماً، أو فيلسوفاً عليماً، ومن قد تعود حذف فضول الكلام، وإسقاط مشتركات الألفاظ" . وإذا كانت الإشارة الأخيرة تكشف عن انعكاس المستوى المعرفي والثقافي للفئة المتوجه إليها بالخطاب في بنية هذا الخطاب، فإن للنوع الأدبي أيضاً دوراً في القصد إلى التنقيح والتحكيك مثلما تجسد في تسمية بعض القصائد "بالحوليات والمقلدات والمنقحات والمحكمات" ، ومثلما تختزله هذه المقولة: "خير الشعر الحولي المنقح" . وكذلك الأمر في الخطابة إذ أنه نسب إلى البعيث الشاعر قوله: "إني والله ما أرسل الكلام قضيباً خشيبا، وما أريد أن أخطب يوم الحفل إلا بالبائت المحكك" . ومع الإقرار بالاختلاف في قصد الصنعة بين الشعر والخطابة إذ أن التدبير في الشعر أشيع إلا أنهم "كانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومهمات الأمور، ميّثوه في صدورهم، وقيدوه على أنفسهم، فإذا قومه الثقاف وأدخل الكير، وقام على الخلاص، أبرزه محككاً منقحاً، ومصفى من الأدناس مهذباً" .
وإذا كان هذا الموقف المزدوج من الصنعة انعكاساً لموقف مزدوج يدعو إلى الوضوح ويقر الوحي والإشارة والتكثيف ويتماشى مع خاصية الغزارة في الدلالة اللغوية، فإنه محكوم أيضاً بمنظور اجتماعي ذي طابع معرفي وثقافي تتنزل فيه الطبقة منزلة معرفية أساساً في ثنائية العامة والخاصة، ذلك أن العامة في هذا التصور ليست مضادة للخاصة إلا في الدرجة، بحيث يكون موقعها في سلّم المعرفة أدنى فحسب،وهذا يعني انضواءهما معاً تحت لواء الثقافة عموماً، مما يجعل فئة السوقة والبلديين خارج هذا الحصر، وهو موقف يفسر مراتب القول البليغ المتدرج في مستويات تمشياً مع المتلقي ومستواه ومصادراً في الآن نفسه على النوع، إذ أن عموم الخطابة وذيوعها في مختلف الأوساط والمناسبات يجعل بنيتها انعكاساً لموقف المتلقي معرفياً فتتدرج صياغتها بين قصد التسهيل وقصد الإيجاز والغموض، ونفس الشيء في الشعر، ذلك أن بنيته النوعية لا تتنافى مع قدراته على تلبية أذواق الجميع إلى أن يسموا في قصائد السماطين والطوال التي تنشد يوم الحفل، والتي تلتمس بها صلات الأشراف والقادة وجوائز الملوك والسادة التي لا بد من أن يقصد فيها "صنيع زهير والحطيئة وأشباههما" ، والقرآن متعاطى في أوساط العامة والخاصة جميعاً إلاّ أن استيعاب مقاصده مختلف، وهذا المنظور التصنيفي يحدده الجاحظ في قوله: "وإذا سمعتموني أذكر العوام فإني لست أعني الفلاحين والحشوة والصناع والباعة، ولست أعني أيضاً الأكراد في الجبال وسكان الجزائر في البحار، ولست أعني من الأمم مثل البير والطيلسان ومثل موفان وجيلان ومثل الزنج وأشباه الزنج، وإنما الأمم المذكورون من جميع الناس أربع: العرب، وفارس، والهند، والروم. والباقون همج وأشباه الهمج. وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا، ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا، فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم ولم يبلغوا منزلة الخاصة منّا. على أن الخاصة تتفاضل في طبقات أيضاً".
ولكن كيف يستقيم هذا الفهم الداعي إلى مطابقة المعنى واللفظ، مع الإيمان بأن الألفاظ "تكون كسوة لتلك المعاني" ، وأن وظيفتها تزيين المعاني، بل إن المسألة لتمتد إلى الإقرار بإمكان عدم التكافؤ بين قطبي الدلالة من منظور القيمة، وإنّ المعنى المزين باللفظ قد ينقل إلى مقدار أعلى من مقداره، فالمعاني "إذا كسيت الألفاظ الكريمة، أو أكسبت الأوصاف الرفيعة، تحولت في العيون عن مقادير صورها وأربت على حقائق أقدارها، بقدر ما زينت، وحسب ما زخرفت. فقد صارت الألفاظ في معاني المعارض، وصارت المعاني في معنى الجواري" ، وإذا كان هذا ترسيخاً لمبدأ الزخرفة المكين في قناعات النقاد القدماء عموماً، فإنه لا يناقض ما سلف من تأكيد ضرورة التطابق بين المعنى واللفظ، ذلك أن الأمر هنا متعلق بالصنعة وبالمبالغة في الإخراج الصوري للمعنى، وهذا يدعو إلى عرض رأيه في صور المعاني التي تزيد رأيه في المعاني والألفاظ والصلات بينها تحديداً وتدقيقاً. وتأخذ علاقة المعنى المحتوى في اللفظ بالاستناد إلى الأصل الفلسفي في الصورة والهيولى اصطلاح صورة المعنى، وهي أدق في إيفاء علاقة المستويين المتكاملين في النص وصفهما إذا إن المعنى المتلبس بالصورة لا وجود له خارج مجالها.
ومفهوم الصورة يشمل كل مراتب المعاني المتلبسة بالصورة،فهو ليس خاصية تتعلق بالقول البليغ، إذ إن كل إخراج للمعنى في صياغة ما بناء لصورته، يصف الجاحظ بعض رسائله بأنه صوّرها في أحسن صورة . والانحراف في رواية نادرة "يخرجها عن صورتها" ، فالإعراب "يفسد نوادر المولدين، كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب، لأن سامع ذلك الكلام إنما أعجبته تلك الصورة وذلك المخرج، وتلك اللغة وتلك العادة، فإذا دخلت على هذا الأمر – الذي إنما أضحك بسخفه وبعض كلام العجمية التي فيه – حروف الإعراب والتحقيق والتثقيل وحولته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحاء،وأهل المروءة والنجابة انقلب المعنى مع انقلاب نظمه، وتبدلت صورته" ، وتبدل الصورة وانقلاب المعنى إقرار بتكامل المستويين، هذا التكامل الذي يأخذ طابعاً خصوصياً ومتفرداً في الشعر ذلك أن صورة المعنى فيه تتشكل في صياغة يراعى فيها خصوصيتها ذاتها، وهذا الإخراج المتميز للشعر يهبه التمايز ضمن أشكال القول البليغ فيكسبه التفرد بالمقابل إلى أشكال التعبير في الحضارة الواحدة ذلك أن "الشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل، ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه، وذهب حسنه وسقط موضع التعجب لا كالكلام المنثور" .
إن الإقرار باستعصاء الشعر على الترجمة تأكيد لقيمة الشكل في الشعر لا ريب، لكنا نرى الشكل معادلاً للصورة في هذا المقام،ومن هنا يكون شكل الشعر المتميز محتوياً على معناه، فموضع التعجب من الشعر كما ورد في نص الجاحظ السابق ليس نتاج مستويات صوتية فحسب، بل هو خلاصة تفاعل عناصر الكلام في نظم يتهدده التقطع إن هو ترجم. فالإلحاح على "الشكلانية" هنا متوافق مع خواص الشعر الذي تولى فيه اللغة ونسيج البناء الأولية، من هنا نجد المدخل إلى قراءة مقولة الجاحظ في أن "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك. فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، لا شك أن للصراع الشعوبي وموقف الجاحظ السياسي والثقافي عامة أثراً في إصدار هذا الحكم، فضلاً عن أنه بالاعتماد على المستوى النقدي من المقولة يظهر القبول "لمبدأ الفلسفة الأرسطية التي تقدم الصورة على الهيولى أو الشكل على المادة" ؛ على أننا لا نرى في مبدأ التقديم إخلالاً بالهيولى أو المادة، إذ إنه بالإضافة إلى العلاقة الجدلية بين الصورة والمادة التي تنفي وجود أحدهما في غياب الآخر، يتنزل مبدأ الهيولى في هذا المقام ضمن مستويين، إذ بمعادلته للمعنى يتحدد لـه وجودان إن صح الوصف، فالمعنى خارج مجال الصورة مادة ملقاة في الطريق، كأصول عامة منثورة في الموجودات كلها ذلك أن كل موجود ناطق بالدلالة، ناهيك عن أن الأغراض أو أصولها التي هي مصادر للشعر مادة ملقاة في الذاكرة العامة راسخة في الديوان المعرفي للأمة، وما دام المقام مقام شعر، فالإخراج الصوري للمعنى فيه إنما هو سبك لهذه المادة الملقاة أو المعروفة في بناء جديد، فتولد كياناً جديداً، أصوله معروفة وخواصه الحيوية جديدة. وفي هذا السبك الجديد ميلاد جديد للمعنى يتم عبر التوليد أو التفطن للغريب وسط الملقى المألوف، أو التعامل مع المعروف على أنه بمجرد أن يتلبس بالصورة يوهب الوجود المتجدد فيستحيل محتوى بعد أن كان موضوعاً. فللمعنى عنده دلالتان: دلالة المحتوى المتلبس بالصياغة أو كما شاع قديماً صورة المعنى، وأسس عليه عبد القاهر فهمه للجاحظ نفسه ولفكرته في الصورة والنظم ، ودلالة المعنى المعادل للمادة الأولية. "وعلى أساس هذا التفسير يكون الناس الذين ظنوا أن "المعنى" في نظرية الجاحظ يشير إلى عدم التفاوت في "العملية الفكرية" القائمة وراء البناء الفني، قوماً مخطئين في تصورهم. فهم قد أساؤوا فهم ما رمى إليه الجاحظ، لأنه لم يتجاوز بما يعني "المادة الأولية" التي تتولاها "الروية" بالصياغة، فخلطوا – بذلك – بين تلك المادة الضرورية المشاعة وبين "الروية" الفكرية التي تؤسس "وحدة متكاملة" من اللفظ والمعنى تأسيساً متفاوتاً في القدرة على التأثير. فأرجعوا الفضيلة إلى اللفظ وحده" .
وتأسيساً على ما سلف يمكننا الاقتراب من رأيه في أبيات عنترة "في صفة الذباب، فإنه وصفه فأجاد صفته فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض له أحد منهم. ولقد عرض له بعض المحدثين ممن كان يحسن القول بمبلغ من استكراهه لذلك المعنى، ومن اضطرابه فيه، أنه صار دليلاً على سوء طبعه في الشعر. قال عنترة:
جادت عليه كل عين ثرّة فتركن كل حديقة كالدرهم
فترى الذباب بها يغني وحده هزجاً كفعل الشارب المترنم
غرداً يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم
ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة" ، فإننا لا نرى بين تصوره للمعنى في قوله السابق، ومفهومه للصياغة والصورة تناقضاً، ذلك أن المعنى – كما بدا لنا في النص السابق – معادل للمحتوى بدليل تعليقه في آخر المقطوعة بقوله: "إنه لم يسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة"، فالمعنى كما تقدمه صياغة عنترة هو المعجب، وإلا فلمَ فقد قيمته ولحقه الاضطراب عندما تناوله غير عنترة؟ فلو كان المعنى لا يتفاوت في أي صياغة لما تفرد عنترة بهذا السبق، لأن جوهر هذا السبق إنما يكمن في التطابق التام بين المعنى المبتدع الذي لا وجود له خارج صياغته المتفردة، وبين هذه الصياغة نفسها، فالمادة الأولية للمعنى يمكن أن تكون "صفة الذباب عندما يحك إحدى يديه بالأخرى"، لكن تشبيهه بمقطوع اليدين المكب على الزناد ضمن هذا الإطار الوصفي الشامل هو الخصوصية المحدثة في المعنى التي لم تتأسس إلا على الصياغة؛ صحيح أن الجاحظ بحث في المعنى في مستويات شتى كتصنيفه المعاني من منظور زوايا الإسراف أو الإفراط والاقتصاد أو الصدق وتعرضه لأخطاء الشعراء فيها، وكذا تعقبه السرقات في المعاني والألفاظ، فضلاً عن مقابلته بين أصول المعاني في النثر ومشابهاتها في الشعر،و غيرها ، إلا أنه يبني فهماً للمعنى أعمق عندما يكون خلاصة للصياغة، يظهر ذلك في مثل هذا الموقف" وقال زهير :
والإثم من شرّ ما توصل به والبرّ كالغيث نبته أمر
أي كثير، ولو شاء أن يقول:
والبرّ كالماء نبته أمر
استقام الشعر ولكن قد لا يكون له معنى. وإنما أراد أن النبات يكون على الغيث أجود" (75)؛ وانتفاء المعنى باستبدال الكلمة بأخرى لا يعني خلوّ البيت من كلِّ دلالة، إذ إن بنية البيت القائمة على القواعد النحوية تظل محتفظة بدلالة ما، إلا أن المعنى الشعري المعجب هو الذي يأفل بتغيير لفظة واحدة لها إشعاع معنوي عميق، من هنا يكون المعنى محصلة للتفاعل الحادث بين معاني الكلمات المختلفة في السياق الواحد، ولو كان للمعنى وجود مستقل مستقر ثابت لما كان التفاوت كبيراً بل وارداً أصلاً بين استعمال "الغيث" أو "الماء" في البيت السابق.
فتقديم الجاحظ الصياغة أو اللفظ تارة والمعنى أخرى لا يوحي بتضاد أو تناقض إذا حملنا المعنى على أن المقصود به محتوى الصياغة، أو المادة الأولية حسب دلالة العبارات ومقتضى آرائه البلاغية والنقدية. فعلى الرغم من أننا نتحفظ من القول بوجود قائلين بأن البلاغة في الألفاظ (كالجاحظ والآمدي والجرجاني مثلاً) فعند من يقول بهذا الرأي يرى أنهم "لم يعنوا بالألفاظ أصواتاً مجردة من معانيها وإنما عنوا بها العبارة عن المعنى" . لذلك نستغرب من إحسان عباس، وهو الذي رأى في دلالة المعنى لدى الجاحظ المستخلص من مقولته في المعاني المطروحة بالاستعانة برأي عبد القاهر "مادة أولية" تتفاوت حتماً حين تتناولها الروية فتؤسس "وحدة كاملة" من اللفظ والمعنى" ، نستغرب منه، وهو يقارن بين الجاحظ وابن قتيبة، أن يرى أن "من بين الفروق بينهما اختلافهما في النظر إلى مشكلة اللفظ والمعنى، فبينما انحاز الجاحظ إلى جانب اللفظ، ذهب ابن قتيبة مذهب التسوية" . ولعلّ إحسان عباس يحمّل اللفظ في نصه السابق معنى الشكل، فيكون انحياز الجاحظ إلى اللفظ انحيازاً إلى الصياغة المحتوية على معناها، في حين يتجسد موقف ابن قتيبة في تبنيه فكرة الصياغة والمعنى في مستواه القيمي المتجسد في ما يدعو إليه الشعر من حكمة وأخلاق. قد نجد تأكيد هذا المنحى في الفهم في موقفه الآخر من الجاحظ الذي يسمه فيه بالتناقض بناء على نظريته في الشكل، إذ إنه يرى أن الجاحظ وقف منها موقفين أحدهما يؤيدها والثاني ينقضها، فأما الأول فيتبدى في إصراره على أن الشعر لا يترجم كما رأينا في النصوص السابقة، ذلك أن استعصاءه على الترجمة إنما هو سرٌّ من أسرار الشكل، "وأما الثاني فهو قوله إن هناك معاني لا يمكن أن تسرق كوصف عنترة للذباب... فقوله إنه لا يسرق دليل على أن "السر في المعنى" قبل اللفظ، ولكن الجاحظ لم ينتبه لهذا التناقض" . ولكن أين يكمن هذا المعنى المحتوي على السر، أهو معادل للمادة الأولية، وإذ ذاك ينتفي عن أبيات عنترة كل وصف بالشعر، وإذا كان مضمناً في صياغة عنترة مصداقاً لفعل "الروية المؤسسة لوحدة اللفظ والمعنى"، كما يرى إحسان عباس أيضاً، أصبح عنصراً حيوياً في الشكل إذ لا نحسب أن إحسان عباس يحمل نظرية الجاحظ في الشكل على المستوى الصوتي للألفاظ لخلوّها من كل دلالة عدا دلالة التصويت الموسيقي، وهذا غير وارد، إذ يرى في نظرية الجاحظ في الشكل نصرة للإعجاز، ذلك "أن الإعجاز لا يفسر إلا عن طريق النظم، ومن آمن بأن النظم جديرٌ برفع البيان إلى مستوى الإعجاز، لم يعد قادراً على أن يتبنى نظرية تقديم المعنى على اللفظ" ، فلو حملنا المعنى هنا على المواد الأولية القابلة للتشكيل في صياغات متعددة لانتفى التناقض عن الجاحظ، إذ إن النظم المبرهن على الإعجاز لا يعني أصواتاً مفارقة إنما هو الانتظام الموحد لوحدات دالة في سياق خاص يكون المعنى المفرز خلاصة هذا الانتظام نفسه. فالنظم أو الشكل إنما هو لحمة طرفين هما معنى ولفظ، وبهذا الفهم ينتفي عن الجاحظ الوصف بالتناقض،ويكون من دلالات "المعنى" عنده المادة الأولية القابلة لأن تتشكل في صياغات شتى، هذه لا يوليها الاهتمام إلا باعتبارها وجوداً بالقوة يستحيل شكلاً جميلاً بالصياغة،ويكون انتصاره للنظم دليلاً على الإعجاز أو تقديمه أبيات عنترة باعتبارها سبقاً معنوياً فريداً أو غيرها من مواقف شبيهة يعني الصورة العامة الشاملة لطرفي الدلالة اللذين هما: المعنى واللفظ. وهذا يحيل إلى البحث في مفهوم النظم لدى الجاحظ أو ما يتعلق بالبنية العامة.
نلاحظ مبدئياً أن مجمل آراء الجاحظ في البنية العامة كان نتيجة تحسسه مشكلة التأليف في القرآن والشعر أساساً، وهذا إذ يدعم فكرة توزع مقاييس الجاحظ الأسلوبية بين أكثر من نوع من أنواع الكلام البليغ، يؤكد استقلال القرآن والشعر بقطاع مهم من هذه المقاييس وهو النظم أو التأليف والبنية العامة، مما يرسخ الاقتناع باحتلال الوعي بالصياغة وبخصائص بنية الكلام ذاتها مكاناً عميقاً في بلاغة الجاحظ، ويعمق الدليل على وعيه بالمستوى الفني من الكلام الذي يقصد في إخراجه تجنب المألوف من الاستعمال، وتجاوز وظيفة الإفهام إلى وظيفة الإطراب والتعجيب.
فإذا كان "لقضية النظم هذه أثر واضح في تحديد مفهوم الجاحظ للأسلوب " فإن ضبط مدلولها بدقة أمر متعذر خاصة في غياب مؤلفه "نظم القرآن"، إلا أنه يمكن تحسس دلالاتها الأولية التي قد تسعف في الاقتراب من مقاصد الجاحظ من استعمال هذا الاصطلاح.
وعلى الرغم من وجاهة رأي من يرى أن قضية النظم لدى الجاحظ "لم تتجاوز عنده الإعلان المبدئي المشفوع ببعض الأمثلة القليلة إلى بحث لغوي بلاغي منظم في أساليب القرآن كما سيكون الشأن في مؤلفات إعجاز القرآن بعده" فإن غياب البحث البلاغي المنظم لا يمنع من الإشارة إلى أن الجاحظ يبدي إحساساً بخصوصية الإخراج القرآني للقول البليغ، وقد يسعف هذا الإحساس في الاقتراب من التعرف على مفهومه للنظم. صحيح أن الباحث أشار إلى الوقفة الوحيدة للجاحظ – حسب رأيه - المعرفة للأسلوب القرآني كما يلخصها نصه الذي أشار فيه إلى استعارات القرآن وإلى استغلاله المتميز للطاقة الإيحائية ، التي تمثل بعض مقومات النظم عنده، إلا أن امتداد الجاحظ بوصف كل تأليف فني ينضوي تحت نوع أدبي بوصف النظم أو بعض مترادفاته كالسبك وحسن التأليف مع الإقرار باقتران لفظ القرآن بهذا الوصف في كثير من المواضع، يزيدها التحاما ًمؤلفه الضائع المشار إليه سابقاً، قد يمكن هذا التوظيف الأولي للمصطلح من استنتاج أن معناه يطول مفهوم التركيب والبنية الملحمة لكل عناصر النص.
يلاحظ مبدئياً أن النظم أو بعض مترادفاته كالسبك تذكر كمواصفات نص اكتملت له صفات الجودة ألفاظاً ومعاني ثم سبكاً. فجواهر الكلام التي هي من اختصاص الكتّاب وحذّاق الشعراء توجد في "الألفاظ المتخيرة، والمعاني المنتخبة، وعلى الألفاظ العذبة، والمخارج السهلة، والديباجية الكريمة، وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد" ، فكأن السبك فعالية تنضاف إلى اكتمال المعاني والألفاظ في الخطاب، فقد استقبل بعضهم بعض كتبه "بالتصغير لقدره والتهجين لنظمه والاعتراض على لفظه، والتحقير لمعانيه، فزريت على نحته وسبكه، كما زريت على معناه ولفظه" ذلك ان السبك إنما يكون لعناصر مكتملة الحسن في ذاتها "فإن التأليف يزيد الأجزاء الحسنة حسناً" .
ثم يقترب معنى النظم من مفهوم التأليف الشامل لمستويات النص،كما يظهر في مثل هذا الوصف الأولي عن "نظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه" . وهذا التأليف المتميز بخصوصية هذا النوع أو ذاك مما سيتفرع من الشعر والنثر هو الذي يمكّن من مقابلة القرآن بغيره من أجناس القول، وهو يكشف عن وعي الجاحظ الأولى بمفهوم الطريقة أو البناء الخاص بكل نوع أدبي، ففرق "ما بين نظم القرآن وتأليفه ونظم سائر الكلام وتأليفه؛ فليس يعرف فروق النظم واختلاف البحث إلا من عرف القصيد من الرجز، والمخمس من الأسجاع، والمزاوج من المنثور، والخطب من الرسائل، وحتى يعرف العجز العارض الذي يجوز ارتفاعه من العجز الذي هو صفة في الذات. فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام" .
إذاً فاقتران النظم والتأليف من جهة والمقابلات الثنائية بين مختلف الأنواع المذكورة التي تنتهي إلى قوله صنوف التأليف واشتراط معرفتها لإدراك مباينة نظم القرآن لها جميعاً من جهة أخرى، ينم عن وعي بالفروق الشكلية بين المتشابهات، كالمزاوج من المنثور والخطب من الرسائل والقصيد من الرجز والمخمس من الأسجاع. فإدراك الفرق بين المزاوج والمنثور مثلاً لابد أن يقوم على وعي بالمستوى الإيقاعي المتفرد في المزاوج الذي تخضع فيه الدوال إلى أنماط من الانتظام والتكرار، في حين يغيب مثل هذا البناء في المنثور. وقد يمكن أن نستنتج من ذلك أن الجاحظ مدرك لخواص بنائية في القرآن تجعل إلحاحه على تمييز نظمه عما عداه قائماً على رصيد من ضبط لطريقته في نضد الكلام يتجاوز فيها الإشارة إلى الاستعارة واستغلال الطاقة الإيحائية، وقد يدعم ذلك وضعه النظم في النص السالف موضع الطريقة. ويزيدنا اقتراباً من فهم الجاحظ اختلاف أصناف القول قولـه: "إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز، ومن المنثور والأسجاع، ومن المزدوج وما لا يزدوج، فمعنى العلم أن ذلك له شاهد صادق من الديباجة الكريمة، والرونق العجيب، والسبك والنحت" . فمصطلحات الديباجة والسبك والنحت لابد أن تتشكل وفق بناء كل نوع، ولعل في الوعي بذلك ما يدعم فكرة قيام رأيه في نظم القرآن على إدراك متميز لبناء الكلام فيه حتى وإن كان إدراكاً أولياً.
فمعنى النظم يترادف مع التأليف والسبك ومشابهاتها في إطار شامل لبنية أي نص، ثم يضيق ليحمل دلالة الطريقة أو الأسلوب في نوع أدبي أو صنف خطابي، بحيث يمكننا هذا التضييق من مقاربته أكثر، خاصة أن الجاحظ خص الشعر بوقفات متعددة مبرزاً مقاييس جودته عبر رصده بعض مستويات بنيته وتعاضد هذه المستويات في البنية العامة.
اهتم الجاحظ بالإخراج الصوري للمعنى في الشعر خاصة، ويكفي ذيوع مقولته في أن الشعر صياغة ونسج وتصوير للكشف عن تصوره للحمة المعنى واللفظ في إطار شامل يذيب العناصر في كل موحد،تبدو اللازمة المتكررة فيه إيقاع أصواته المنظم كخاصية نوعية في القصيدة. هذه الخاصية التي تأخذ مكانها في بنية عامة تشمل كل المستويات.
الإحساس بالمستوى الصوتي يظهر في وقفات لدى الجاحظ في رصد ما أسماه بالتنافر في الكلام، ذلك أن "من ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه... منها قول الشاعر:
لم يضرها، والحمد لله، شيء وانثنت نحو عزف نفس ذهول
فتفقد النصف الأخير من هذا البيت، فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض" . وإذا كان في ما سلف تشخيص للظاهرة كما تتجسد شعراً، فإن معتمده الشعر أيضاً لمحاكمة هذا النمط من عدم تآلف اللفظ في مثل هذا الحكم الذي يتضمنه هذا البيت الشعري:
وشعر كبعر الكبش فرّق بينه لسان دعيّ في القريض دخيل
لتنتهي خلاصة الموقف إلى مقابلة الشكلين المتوافق والمتلائم في وصف اللفظ والمتخالف المستكره وانعكاس ذلك على نظام البيت الذي يمكن أن تكون أجزاؤه "مختلفة متباينة، ومتناظرة مستكرهة، تشق على اللسان وتقده، والأخرى تراها سهلة لينة، ورطبة مواتية، سلسة النظام، خفيفة على اللسان، حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد" .
والحق أن حديث الجاحظ عن التلاحم والتلاؤم اللفظي ليس خالصاً للمستوى الصوتي إذ يتعاضد مع المنظور الكلي المؤسس على لحمة المستويات المختلفة في القصيدة. صحيح أن ولع الجاحظ بالإي
|
|
الوتر الحزين
شخصيات هامة
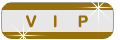


العمر : 57
عدد الرسائل : 18803

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 32785
ترشيحات : 121
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى  14/9/2009, 23:23 14/9/2009, 23:23 | |
| |
|
هويدا رأفت الجندى
مراقب عام



عدد الرسائل : 4821

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 10158
ترشيحات : 11
الأوســــــــــمة : 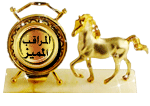
 |  موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى  15/9/2009, 04:04 15/9/2009, 04:04 | |
| - الوتر الحزين كتب:

أختي الفاضله
بارك الله فيك لجهدك المثمر الطيب
وكل عام وانت بكل الخير والسعاده

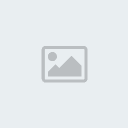
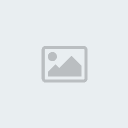
[img:ee26]http://www.althkra.net/pic/ep/32[2.gif[/img:ee26] أستاذى الكريم شرفنى تواجدك وحضورك الطيب بارك الله فيك وبانتظار مرورك دوما |
|
عبير عبد القوى الأعلامى
نائب المدير الفني



عدد الرسائل : 9451

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 17868
ترشيحات : 33
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى  27/10/2009, 09:41 27/10/2009, 09:41 | |
| |
|
أبو طالب الأعلامى
عضو جديد
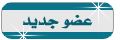


عدد الرسائل : 44

بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 3471
ترشيحات : 0
 |  موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى  7/12/2016, 01:16 7/12/2016, 01:16 | |
| |
|
أحمد أيمن الأعلامي
مشرف



العمر : 29
عدد الرسائل : 1784

بلد الإقامة : الفيـــــــــوم
احترام القوانين : 
العمل : 
الحالة : 
نقاط : 7877
ترشيحات : 20
الأوســــــــــمة : 
 |  موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى موضوع: رد: الجاحظ وتطابق اللفظ والمعنى  16/1/2017, 00:32 16/1/2017, 00:32 | |
| |
|